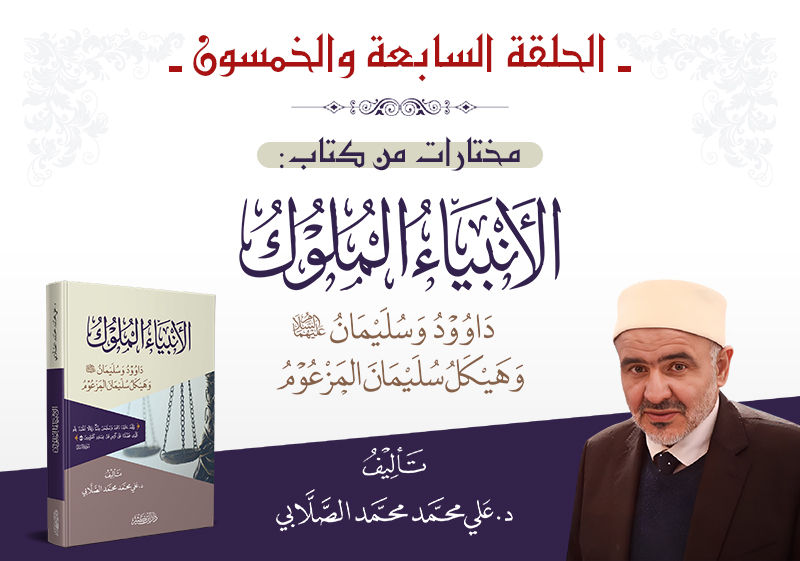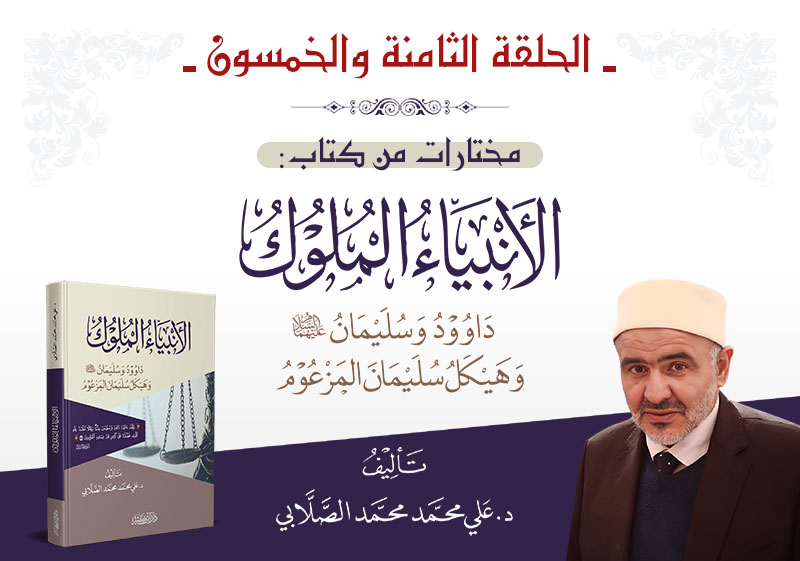سليمان عليه السلام والهدهد ..
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك ...
بقلم د. علي محمد الصلابي ...
الحلقة (56)
قال تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21)﴾:
تبدأ الآيات الكريمة في قصة سليمان (عليه السلام) مع الهدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إلى ستة مشاهد، بينها فجوات فنية، تدرك من المشاهد المعروضة، وتكمل جمال الغرض الفني في القصة، وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل التوجه الوجداني المقصود بعرضها في السورة، وتحقق العبرة التي من أجلها يساق القصص في القرآن الكريم، وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بديعا، من الناحيتين: الفنية الجمالية، والدينية الوجدانية.
ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطير، كما تضمن الإشارة إلى نعمة العلم؛ فإن القصة تحتوي دورا لكل من الجن والإنس والطير. ويبرز فيها دور العلم كذلك. وكأنما كانت تلك المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوار الرئيسية في القصة وهذه سمة فنية دقيقة في القصص القرآني.
كذلك تتضح السمات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة: شخصية سليمان، وشخصية الملك، وشخصية الهدهد، وشخصية حاشية الملكة. كما تعرض الانفعالات النفسية لهذه الشخصيات في شتى مشاهد القصة ومواقفها.
يبدأ المشهد الأول في مشهد العرض العسكري العام لسليمان وجنوده، بعدما أتوا على وادي النمل، وبعد مقالة النملة، وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر والدعاء والإنابة:
وتفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذّبنّه عذابا شديدا أو لأذبحنّه، أو ليأتيني بسلطان مبين.
فها هو ذا الملك النبي سليمان في موكبه الفخم الضخم. ها هو ذا يتفقد الطير فلا يجد الهدهد. ونفهم من هذا أنه هدهد خاص، معين في نوبته في هذا العرض. وليس هدهدا مّا من تلك الألوف أو الملايين التي تحويها الأرض من أمة الهداهد، كما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمةً من سمات شخصيته: سمة اليقظة والدقة والحزم، فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير، الذي يجمع آخره على أوله كي لا يتفرق وينتكث.
وهو يسأل عنه في صيغة مترفعة مرنة جامعة: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾، ويتضح أنه غائب، ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن! وحينئذ يتعيّن أن يؤخذ الأمر بالحزم، كي لا تكون فوضى. فالأمر بعد سؤال الملك هذا السؤال لم يعد سرًّا. وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية الجند. ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدّد الجندي الغائب المخالف: (لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه). ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض، إنما هو نبي وهو لم يسمع بعدُ حجّةَ الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه، ويتبين عذره. ومن ثم تبرز سمة النبي العادل: أو ليأتيني بسلطان مبين؛ أي حجة قوية توضح عذره، وتنفي المؤاخذة عنه.
قال السعدي رحمه الله: في قوله ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾: دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقّد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء وقربه، كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه، أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها، ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة، ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات.
وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال: "وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال" أو "فتش عن الهدهد"، أو: "بحث عنه"، ونحو ذلك من العبارات، وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عيّنها لها. وأيضاً فإن سليمان (عليه السلام) لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح غدوُّها شهر ورواحُها شهر، فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟"
وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع، واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمرهم بالتفكر في معانيه، وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله ﷺ ردها إلى هذا الأصل، فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليها، وإن خالفته لفظاً ومعنى أو لفظاً أو معنى ردها وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لها، وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته.
والشاهد أن تفقد سليمان (عليه السلام) للطير، وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته، حتى فقد هذا الطائر الصغير ﴿فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ أي: هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري؟
فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ دون القتل، ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي: حجة واضحة على تخلفه، وهذا من كمال ورعه وإنصافه أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح، فلذلك استثناه لورعه وفطنته.
قال الشيخ عبد الحميد بن باديس -رحمه الله- في قوله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾:
﴿تَفَقَّدَ﴾ التفقد تطلُّبك ما فقدته وغاب عنك، وتعرُّفك أحواله. ﴿لَا أَرَى﴾ لا أبصر.
﴿الْهُدْهُدَ﴾، هو (تبيب) وهو طائر صغير الجرم منتن الريح ليس من كرام الطير، ولا من سباعها.
﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾؛ استفهم عما حصل له فمنعه من الرؤية، حيث ظن أولًا أن الهدهد كان حاضراً، وإنما هو لم يره.
﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾؛ استفهم عن غيبته حيث ظن ثانياً أنه غائب فاستفهم عن صحة ما ظن، فكلمة أم فيها إضراب، وفيها استفهام، فأضرب إضراب انتقال من ظن إلى ظن.
﴿كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾؛ تعريض بقبح فعله، لما انحط عن شرف الحضور، وكان من الغائبين. وهنا المعنى:
تطلب سليمان (عليه السلام) معرفة ما غاب عنه من أحوال الطير فلم ير الهدهد، وأخذ يتساءل فظن أن شيئاً ستره عنه فلم يره، ولما لم يكن شيء من ذلك، ظن أنه كان غائباً غير حاضر، وذلك هو الظن الأخير الذي حصل به اليقين.
مراجع الحلقة:
- الأنبياء الملوك، علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 215-256.
- في ظلال القرآن، سيد قطب، (5/2638).
- تفسير السعدي، ص802.
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي:
https://www.alsalabi.com/salabibooksOnePage/689
سليمان عليه السلام والهدهد ..
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك ...
بقلم د. علي محمد الصلابي ...
الحلقة (56)
قال تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21)﴾:
تبدأ الآيات الكريمة في قصة سليمان (عليه السلام) مع الهدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إلى ستة مشاهد، بينها فجوات فنية، تدرك من المشاهد المعروضة، وتكمل جمال الغرض الفني في القصة، وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل التوجه الوجداني المقصود بعرضها في السورة، وتحقق العبرة التي من أجلها يساق القصص في القرآن الكريم، وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بديعا، من الناحيتين: الفنية الجمالية، والدينية الوجدانية.
ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطير، كما تضمن الإشارة إلى نعمة العلم؛ فإن القصة تحتوي دورا لكل من الجن والإنس والطير. ويبرز فيها دور العلم كذلك. وكأنما كانت تلك المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوار الرئيسية في القصة وهذه سمة فنية دقيقة في القصص القرآني.
كذلك تتضح السمات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة: شخصية سليمان، وشخصية الملك، وشخصية الهدهد، وشخصية حاشية الملكة. كما تعرض الانفعالات النفسية لهذه الشخصيات في شتى مشاهد القصة ومواقفها.
يبدأ المشهد الأول في مشهد العرض العسكري العام لسليمان وجنوده، بعدما أتوا على وادي النمل، وبعد مقالة النملة، وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر والدعاء والإنابة:
وتفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذّبنّه عذابا شديدا أو لأذبحنّه، أو ليأتيني بسلطان مبين.
فها هو ذا الملك النبي سليمان في موكبه الفخم الضخم. ها هو ذا يتفقد الطير فلا يجد الهدهد. ونفهم من هذا أنه هدهد خاص، معين في نوبته في هذا العرض. وليس هدهدا مّا من تلك الألوف أو الملايين التي تحويها الأرض من أمة الهداهد، كما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمةً من سمات شخصيته: سمة اليقظة والدقة والحزم، فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير، الذي يجمع آخره على أوله كي لا يتفرق وينتكث.
وهو يسأل عنه في صيغة مترفعة مرنة جامعة: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾، ويتضح أنه غائب، ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن! وحينئذ يتعيّن أن يؤخذ الأمر بالحزم، كي لا تكون فوضى. فالأمر بعد سؤال الملك هذا السؤال لم يعد سرًّا. وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية الجند. ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدّد الجندي الغائب المخالف: (لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه). ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض، إنما هو نبي وهو لم يسمع بعدُ حجّةَ الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه، ويتبين عذره. ومن ثم تبرز سمة النبي العادل: أو ليأتيني بسلطان مبين؛ أي حجة قوية توضح عذره، وتنفي المؤاخذة عنه.
قال السعدي رحمه الله: في قوله ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾: دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقّد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء وقربه، كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه، أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها، ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة، ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات.
وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال: "وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال" أو "فتش عن الهدهد"، أو: "بحث عنه"، ونحو ذلك من العبارات، وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عيّنها لها. وأيضاً فإن سليمان (عليه السلام) لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح غدوُّها شهر ورواحُها شهر، فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟"
وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع، واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمرهم بالتفكر في معانيه، وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله ﷺ ردها إلى هذا الأصل، فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليها، وإن خالفته لفظاً ومعنى أو لفظاً أو معنى ردها وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لها، وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته.
والشاهد أن تفقد سليمان (عليه السلام) للطير، وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته، حتى فقد هذا الطائر الصغير ﴿فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ أي: هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري؟
فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ دون القتل، ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي: حجة واضحة على تخلفه، وهذا من كمال ورعه وإنصافه أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح، فلذلك استثناه لورعه وفطنته.
قال الشيخ عبد الحميد بن باديس -رحمه الله- في قوله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾:
﴿تَفَقَّدَ﴾ التفقد تطلُّبك ما فقدته وغاب عنك، وتعرُّفك أحواله. ﴿لَا أَرَى﴾ لا أبصر.
﴿الْهُدْهُدَ﴾، هو (تبيب) وهو طائر صغير الجرم منتن الريح ليس من كرام الطير، ولا من سباعها.
﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾؛ استفهم عما حصل له فمنعه من الرؤية، حيث ظن أولًا أن الهدهد كان حاضراً، وإنما هو لم يره.
﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾؛ استفهم عن غيبته حيث ظن ثانياً أنه غائب فاستفهم عن صحة ما ظن، فكلمة أم فيها إضراب، وفيها استفهام، فأضرب إضراب انتقال من ظن إلى ظن.
﴿كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾؛ تعريض بقبح فعله، لما انحط عن شرف الحضور، وكان من الغائبين. وهنا المعنى:
تطلب سليمان (عليه السلام) معرفة ما غاب عنه من أحوال الطير فلم ير الهدهد، وأخذ يتساءل فظن أن شيئاً ستره عنه فلم يره، ولما لم يكن شيء من ذلك، ظن أنه كان غائباً غير حاضر، وذلك هو الظن الأخير الذي حصل به اليقين.
مراجع الحلقة:
- الأنبياء الملوك، علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 215-256.
- في ظلال القرآن، سيد قطب، (5/2638).
- تفسير السعدي، ص802.
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي:
https://www.alsalabi.com/salabibooksOnePage/689