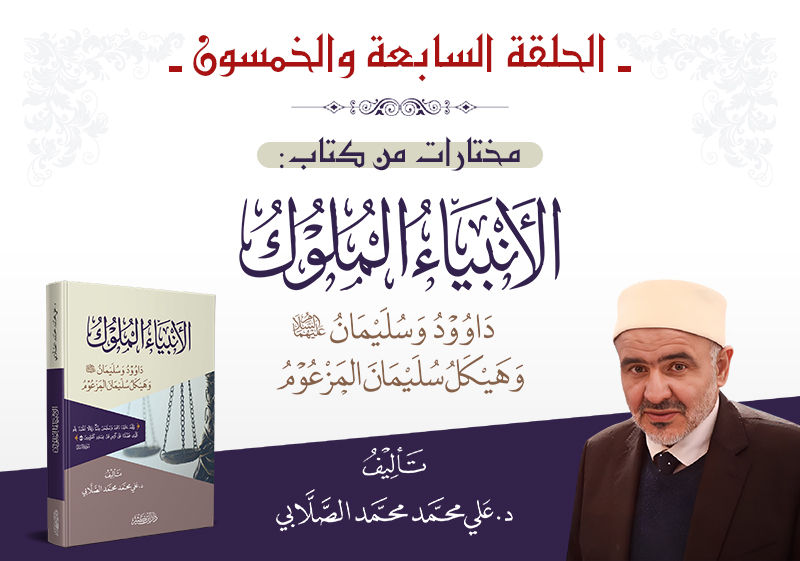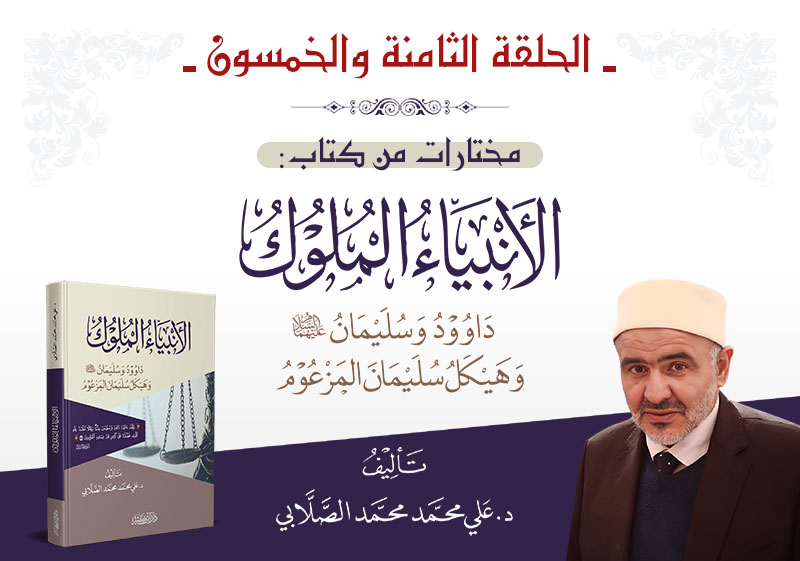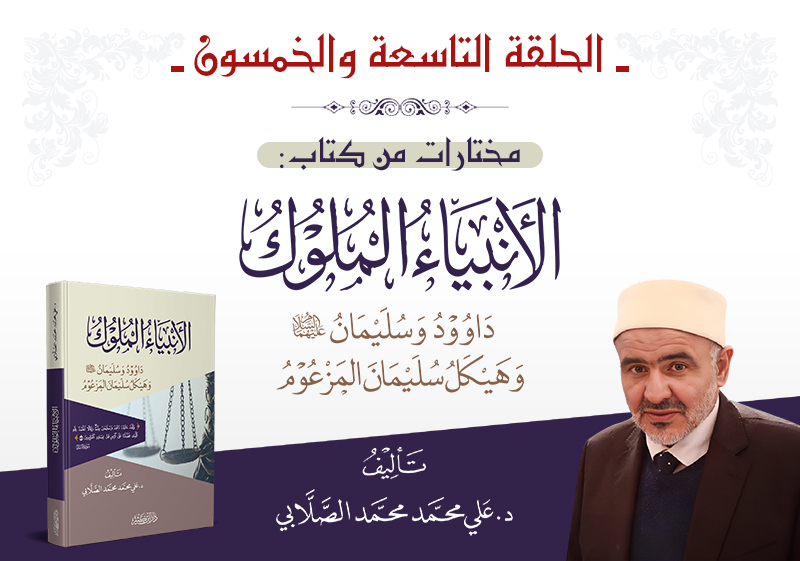الدروس والحكم من تساؤل سليمان (عليه السلام) عن مكان وحال الهدهد ..
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك (عليهم السلام)
بقلم: د. علي محمد الصلابي
الحلقة (57)
قال تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21)﴾:
تعليم وقدوة:
من حق الرعية على راعيها أن يتفقدها، ويتعرف أحوالها؛ إذ هو مسؤول عن الجليل والدقيق منها. فهو يباشر بنفسه ما استطاع مباشرته منها، ويضع الوسائل التي تطلعه على ما غاب عليه منها. كما ينيط بأهل الخبرة والمقدرة والأمانة تفقد أحوالها حتى تكون أحوال كل ناحية معروفة مباشرة لمن كلف بها.
فهذا سليمان على عظمة ملكه، واتساع جيشه، وكثرة أتباعه، قد تولى التفقد بنفسه، ولم يهمل أمر الهدهد على صغره وصغر مكانه. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "لو أن سخلة بشاطئ الفرات يأخذها الذئب ليسأل عنها عمر". وإن هذا التفقد والتعرف هو على كل راع في الأمم والجماعات والأسر والرفاق، وكل من كانت له رعية.
تعليل وتحرير:
تفقد سليمان جنس ما معه من الطير للتعرف كما ذكرنا، وذِكْرُ الطير هو الذي تعلقت به القصة، وليس في السكوت عن غير الطير ما يدل على أنه لم يتفقده. فالتفقد لم يكن للهدهد بخصوصه، وإنما لما تفقد جنس الطير فقده ولم يجده، فقال ما قال. فلا وجه لسؤال من سأل: كيف تفقد الهدهد من بين سائر الطير.
تدقيق لغوي وغوص علمي:
سأل سليمان عن حال نفسه، فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ ولم يسأل عن حال الهدهد فيقل: ما للهدهد لا أراه؛ فأنكر حال نفسه قبل أن ينكر حال غيره.
وقد نقل الحافظ الإمام ابن العربي عن الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري شيخ الصوفية في زمانه (رحمهما الله)، فقد قال: "إنما قال ما لي لا أرى، لأنه اعتبر حال نفسه إذ علم أنه أوتي الملك العظيم، وسخر له الخلق، فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العمل، فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصر في حق الشكر فلأجله سلبها؛ فجعل يتفقد نفسه، فقال: ما لي".
وكذلك تفعل شيوخ الصوفية إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم. هذا في الآداب، فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في الفرائض؟!.
وفي قوله تعالى: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21)﴾ [النمل: 21].
- ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بنتف ريشه، هكذا فسره ابن عباس وجماعة من التابعين.
- ﴿بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ بحجة قاطعة توضح عذره في غيبته. سميت الحجة سلطاناً لما لها من السلطة على العقل في إخضاعه.
أفادت (أو) أن المحلوف على حصوله هو أحد الثلاثة، فإذا حصلت الحجة فلا تعذيب ولا ذبح، ولو لم تحصل لفعل أحدهما. وقد قدم التعذيب لأنه أشد من القتل، وحالة الغضب تقتضي تقديم الأشد.
المعنى:
يٌقسِم نبي الله سليمان (عليه السلام) على معاقبة الهدهد -وقد تحقق غيبته- بالتعذيب أو بالذبح، إذا لم يأته بالحجة التي تبين عذره في تلك الغيبة، ولا يستثني للعفو، ولا يجعل سبباً لسلامته من العقوبة إلّا الحجة.
توجيه واستنباط:
ليس في الآية ما يفهم خصوص نتف الريش من لفظ العذاب الشديد، وإنما فهم ابن عباس -رضي الله عنه- وأئمة من التابعين ذلك بالنظر العقلي والاعتبار؛ فإن نتف ريشه يعطل خاصية الطيران فيه، فيتحول من حياة الطير إلى حياة دواب الأرض، وذلك نوع من المسخ، وقد علم أن المسخ في القرآن أشنع عقوبة في الدنيا، فلهذا فسّروا العذابَ الشديد بنتف الريش.
والإنسان خاصيته التفكير في أفق العلم الواسع الرحيب، فمن حرم إنساناً -فرداً أو جماعة- من العلم فقد حرمه من خصوصية الإنسانية، وحوله إلى عيشة العجماوات، وذلك نوع من المسخ، فهو عذاب شديد، وأي عذاب شديد؟!
كان هذا الهدهد من جنود سليمان التي حشرت له، وقد كان في مكانه الذي عين له وأقيم فيه، فلما فارق وترك الفرجة في صفه وأوقع الخلل في جنسه استحق العقاب الصارم الذي لا هوادة فيه.
وهذا أصل في صرامة أحكام الجندية وشدتها؛ لعظم المسؤولية التي تحملتها وتوقف سلامة الجميع على قيامها بها، وعظم الخطر الذي يعم الجميع إذا أخلَّتْ بها.
تقدير العقوبة:
جرمُ الهدهد صغيرٌ، وما كُلّف إلا بما يستطيعه من الوقوف في مكانه والبقاء في مركزه، ولكن جرمه بإخلاله بهذا الواجب كان جرماً كبيراً؛ فإن الخلل الصغير مجلبة للخلل الكبير، فقدرت عقوبته على حسب كبر ذنبه لا على حسب صغر ذاته.
تنبيه وإرشاد:
كل واحد في قومه أو في جماعته هو المسؤول عنهم من ناحيته، مما يقوم به من عمل حسب كفاءته واستطاعته، فعليه أن يحفظ مركزه ولا يدع الخطر يدخل، ولا الخلل يقع من جهته؛ فإنه إذا قصر في ذلك وترك مكانه فتح ثغرة الفساد على قومه وجماعته، وأوجد السبيل لتسرُّبِ الهلاك إليهم. وزوالُ حجر صغير من السد المقام لصد السيل يفضي إلى خراب السد بتمامه. فإخلالُ أيِّ أحد بمركزه -ولو كان أصغر المراكز- مؤدٍّ إلى الضرر العام. وثبات كل واحد في مركزه وقيامه بحراسته هو مظهر النظام والتضامن وهما أساس القوة.
الحق فوق كل أحد:
لقد أغضب سليمانَ غيابُ الهدهد، فلذا توعّده هذا الوعيد، وأكّده هذا التأكيد، ولكن سلطان سليمان في قوته وملكه ومكانته يجب أن يخضع لسلطان آخر هو أعظم من سلطانه: هو سلطان الحق، والحق فوق كل أحد، وملك سليمان ملك حق، فلا بد له من الخضوع لسلطان الحجة، ليقيم ميزان العدل، والعدل أساس الملك، وسياج العمران.
قال ابن العربي المالكي: هذا يدل -من سليمان- على تفقده أحوال الرعية، والمحافظة عليهم، فانظروا إلى الهدهد وإلى صغره فإنه لم يغب عنه حاله، فكيف بعظائم الملك؟ ويرحم الله عمر، فإنه كان على سيرته قال: "لو أن سخلة بشاطئ الفرات أخذها الذئب ليُسأل عنها عمر"، فما ظنك بوالٍ تذهب على يديه البلدان، وتضيع الرعية، وتضيع الرعيان.
وقال أيضاً: كان الهدهد صغيرَ الجرم، وَوُعد بالعذاب الشديد لعظيم الجرم. قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الحد على قدر الذنب، لا على قدر الجسد.
إن قادة البناء الحضاري لا بد لهم من صفة اليقظة، والمتابعة، والقوانين الضابطة لحركة الجيوش، ومؤسسات الدول.
كما أن التأني في الأمر وإبقاء مجال للعذر من صفات القيادية الربانية: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾؛ فالسلطان المبين: هو العذر البيِّن الواضح المقبول، وهذا الاستدراك من سلميان (عليه السلام) يدل على حزمه وضبطه وعدله وتثبّته؛ فقد أعطى المتهم فرصة لبيان حجته والدفاع عن نفسه؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أما إذا قدم عذراً أو حجة فلا بد أن تقبل منه.
مراجع الحلقة:
- الأنبياء الملوك، علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 256-262.
- ابن باديس حياته وآثاره (2/33 - 37).
- أحكام القرآن، ابن العربي، دار الكتب العلمية، ط3، 1424ه، (3/1455).
- مقومات بناء الحضارة في سورة النمل، سعيد أحمد، ص40.
- أخلاق الأنبياء، محمد عبد الدرويش، الرياض، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ص216.
- القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، صلاح الخالدي، دار القلم، دمشق - الدار الشامية، بيروت، ط1، 1419ه - 1998م، (3/527).
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي