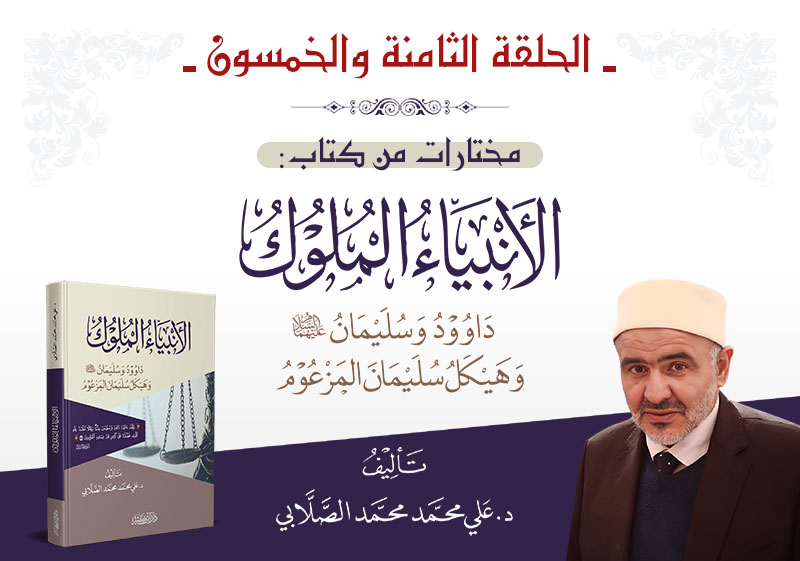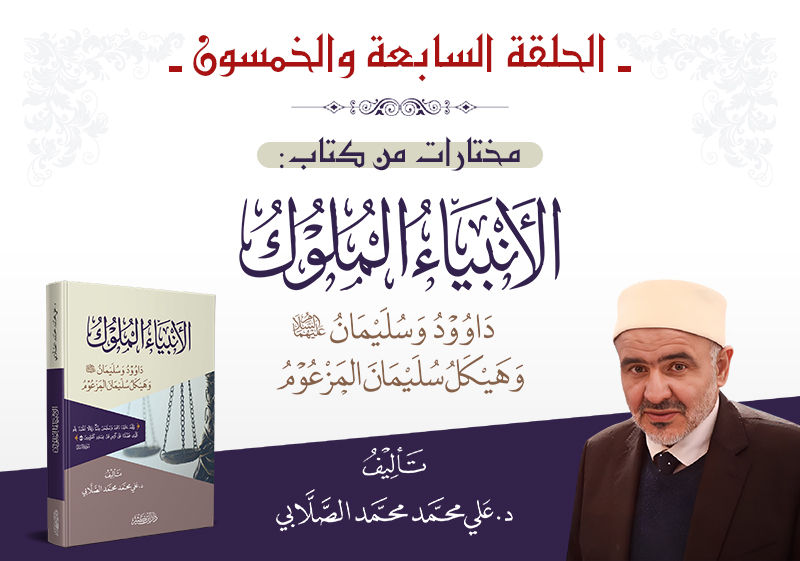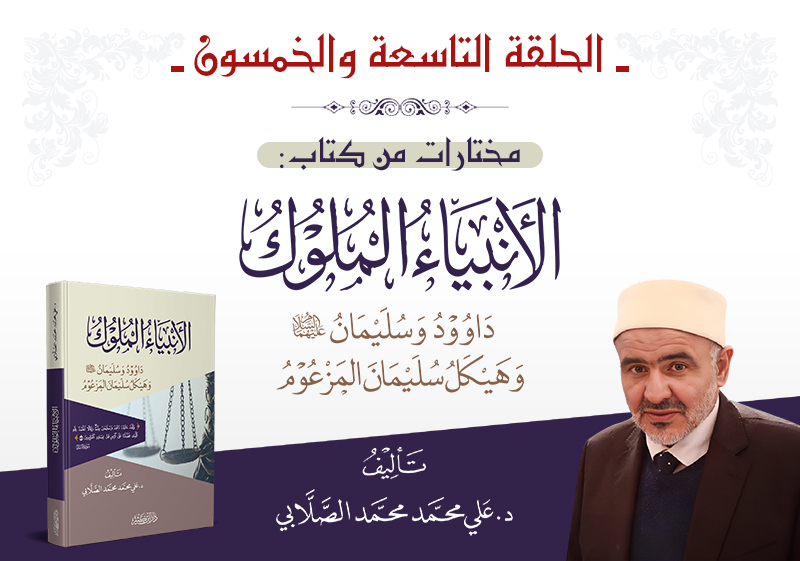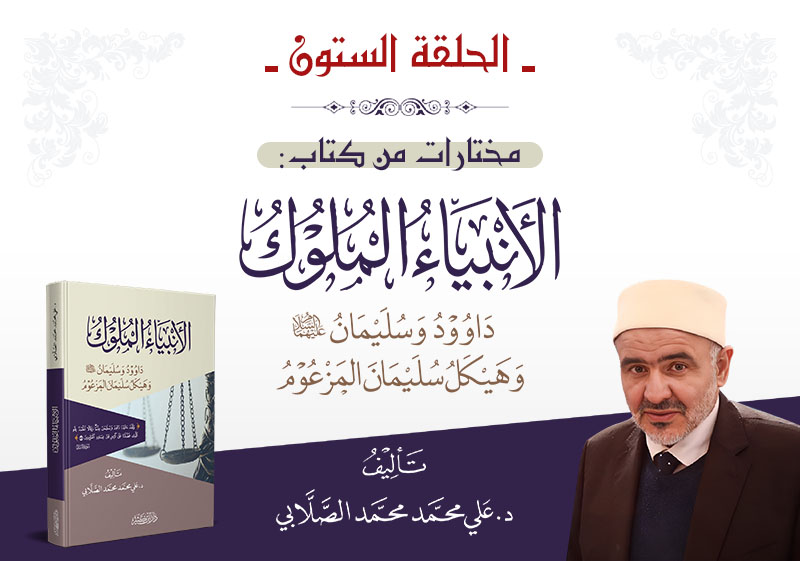في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ ..
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك ...
بقلم د. علي محمد الصلابي ...
الحلقة (58)
قال تعالى: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾:
أ- ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾: لم يقل: فلبث؛ لأن المكث يعبر به ويستعمل للمدة القصيرة؛ على حين أن اللبث يكون للمدد الطويلة، والمكوث هو التوقف والانتظار، فهو يحمل معنى ملازمة المكان، والبقاء فيه مدة ما.
- ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾: مدة يسيرة، فلم يتأخر كثيراً؛ لأنه يعلم أنه تخلف عن مجلس سليمان، وذهب بدون إذنه؛ لذلك تعجل العودة.
والضمير في ﴿مَكَثَ﴾ يحتمل أن يكون لسليمان، ويحتمل أن يكون للهدهد، والأولى حمله على الهدهد، لأن الكلام السابق عنه، والكلام التالي له.
فالهدهد أقام زماناً غير بعيد، وغاب غيبة قصيرة ثم حضر، فهل كان الهدهد قريباً من هدفه؟ وسليمان وجيشه كانوا على مقربة من اليمن -كما تقول بعض الروايات-؟ أم أن قطع الهدهد هذه المسافة البعيدة، بين اليمن وفلسطين في مدة قصيرة يعتبر أحد المعجزات؟ والنصوص تسكت عن هذا. وقد رجح الدكتور صلاح الخالدي (رحمه الله): أن يكون ذلك معجزة؛ فقال: كيف مكث الهدهد غير بعيد؟ مع أن المسافة بين اليمن وفلسطين بعيدة تزيد على الألفي كيلو متر، وبينهما بقاع عديدة؟ لقد كان قطع الهدهد للمسافة الطويلة في وقت قصير، معجزة ربانية؛ فالله طوى له الطريق الطويلة، وجعله يجتازها في فترة قصيرة ويعود في مدة يسيرة. ولا ننسى أن الله سخر الريح لسليمان (عليه السلام)، غدوُّها شهر ورواحُها شهر. وقد يكون لهذه الريح دور في حمل الهدهد إلى اليمن وعودته إلى فلسطين.
ب- ﴿فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾:
- ﴿فَقَالَ﴾ بالفاء الدالة على التعقيب؛ لأنه رأى سليمان غاضباً مُتحفِّزاً لمعاقبته؛ لذلك بادره قبل أنْ ينطق، وقبل أنْ ينهره: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ [النمل: 22]
الإحاطة: إدراك المعلوم من كل جوانبه، ومنه البحر المحيط لاتساعه. ويقول سبحانه: ﴿وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً﴾ [النساء: 126] ومنه: الحائط يجعلونه حول البستان ليحميه ويُحدِّده، ومنه: يحتاط للأمر.
لقد جاء الهدهد بسلطان العلم فقال: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ وهي كلمة في غاية الجمال، إنني أنا الهدهد الضعيف الذي لا يكاد يكون شيئاً بجوار النبي الملك سليمان العظيم، قد أحطت -من العلم- بما لم يحط به نبي الله؛ وذلك أن العلم لا نهاية له، وأن الإحاطة به مستحيلة والناس يتقاسمون بعضه، يحيط فريق منهم بما لم يحط به الآخر، وهم جميعاً لا يحيطون إلا بالبعض الضئيل من العلم: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.
قال ابن القيم (رحمه الله): وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم؛ وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب؛ لولا سلطان العلم.
إنه سلطان العلم الذي يشفع لحامله تقصيره تجاه مسؤوله، فالهدهد تغيب دون إذن، ولكنه عاد مخاطباً سليمان (عليه السلام) بعلم لم يسبقه إليه أحد، حتى نبي الله سليمان (عليه السلام)، فقال له: ﴿بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾.
وقال ابن العربي (رحمه الله): وهذا دليل على أن الصغير يقول للكبير، والمتعلم للعالم: عندي ما ليس عندك، إذا تحقق ذلك وتيقنه. وقال القرطبي رحمه الله: وفي هذا رد على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب.
وقال الزمخشري (رحمه الله): ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة، ابتلاء له في علمه، وتنبيها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما بما لم يحط به، لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه، ويكون لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة.
جـ- ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾: ونقف عند جمال التعبير في سبأ ونبأ، فبينهما جناس ناقص، وهو من المحسّنات البديعية في لغتنا، ويعطي للعبارة نغمة جميلة تتوافق مع المعنى المراد، والجناس أن تتفق الكلمتان في الحروف، وتختلفا في المعنى، كما في قول الشاعر:
رَحَلْتُ عَنِ الدِّيَارِ لكُم أَسِيرُ … وَقَلْبي في محبتكُمْ أَسير
وقَوْل الآخر:
لَمْ يَقْضِ مِنْ حقِّكم عَليَّ … بَعْضَ الذي يَجِبُ
قَلْبٌ متَى مَا جَرَت … ذِكْرَاكُمُ يَجِبُ
وإن من الجناس التام في القرآن الكريم: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة يُقْسِمُ المجرمون مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ [الروم: 55].
فالتعبير القرآني ﴿وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ﴾ [النمل: 22] تعبير جميل لفظاً، دقيق مَعنىً، أَلَا تراه لو قال (وجئتك من سبأ بخبر) لاختلَّ اللفظ والمعنى معاً؛ لأن الخبر يُرَاد به مُطلْق الخبر، أمّا النبأ فلا تُقال إلا للخبر العجيب الهام اللافت للنظر، كما في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ النبإ العظيم﴾ [النبأ: 12].
والجناس لا يكون جميلاً مؤثراً إلا إذا جاء طبيعياً غير مُتكلّف، ومثال ذلك هذا الجناس الناقص في قوله تعالى: ﴿ويْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة: 1] فقد ورد اللفظ المناسب مُعبِّراً عن المعنى المراد دون تكلّف، فالهُمَزة هو الذي يعيب بالقول. واللمزة: الذي يعيب بالفعل، فالقرآن لا يتصيَّد لفظاً ليُحدِث جناساً، إنما يأتي الجناس فيه طبيعياً يقتضيه المعنى.
ومن ذلك في الحديث الشريف: «الخيل معقود في نواصيها الخير». فبين الخير والخير جناس ناقص، جاء محسنا للفظ، مؤديّاً للمعنى.
ونلحظ أن الهدهد لم يعرف سبأ ما هي، وهذا دليل على أن سليمان (عليه السلام) يعرف ما فيها من ملك، إنما لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة.
مراجع الحلقة:
- الأنبياء الملوك، علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 262-266.
- الإعلامية في الخطاب القرآني، زهراء البرقعاوي، دار كنوز المعرفة العلمية، ط1، 2019م، ص192.
- المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، القاهرة، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط5، 2011م، (3/916).
- تفسير الشعراوي، ص (17/10768-10771).
- مواقف الأنبياء في القرآن تحليل وتوجيه، ص151.
- قصص الأنبياء في رحاب الكون، د. عبد الحليم محمود، ص265.
- مفتاح دار السعادة، ابن القيم، (1/173).
- سلطان العلم في سورة النمل، د. نبيل محمد، رسالة علمية، جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، 2018م، ص18.
- أحكام القرآن، ابن العربي، دار الكتب العلمية، ط3، 1424ه، (3/1456).
- جامع أحكام القرآن (12/181).
- الكشاف (3/143).
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي:
https://www.alsalabi.com/salabibooksOnePage/689