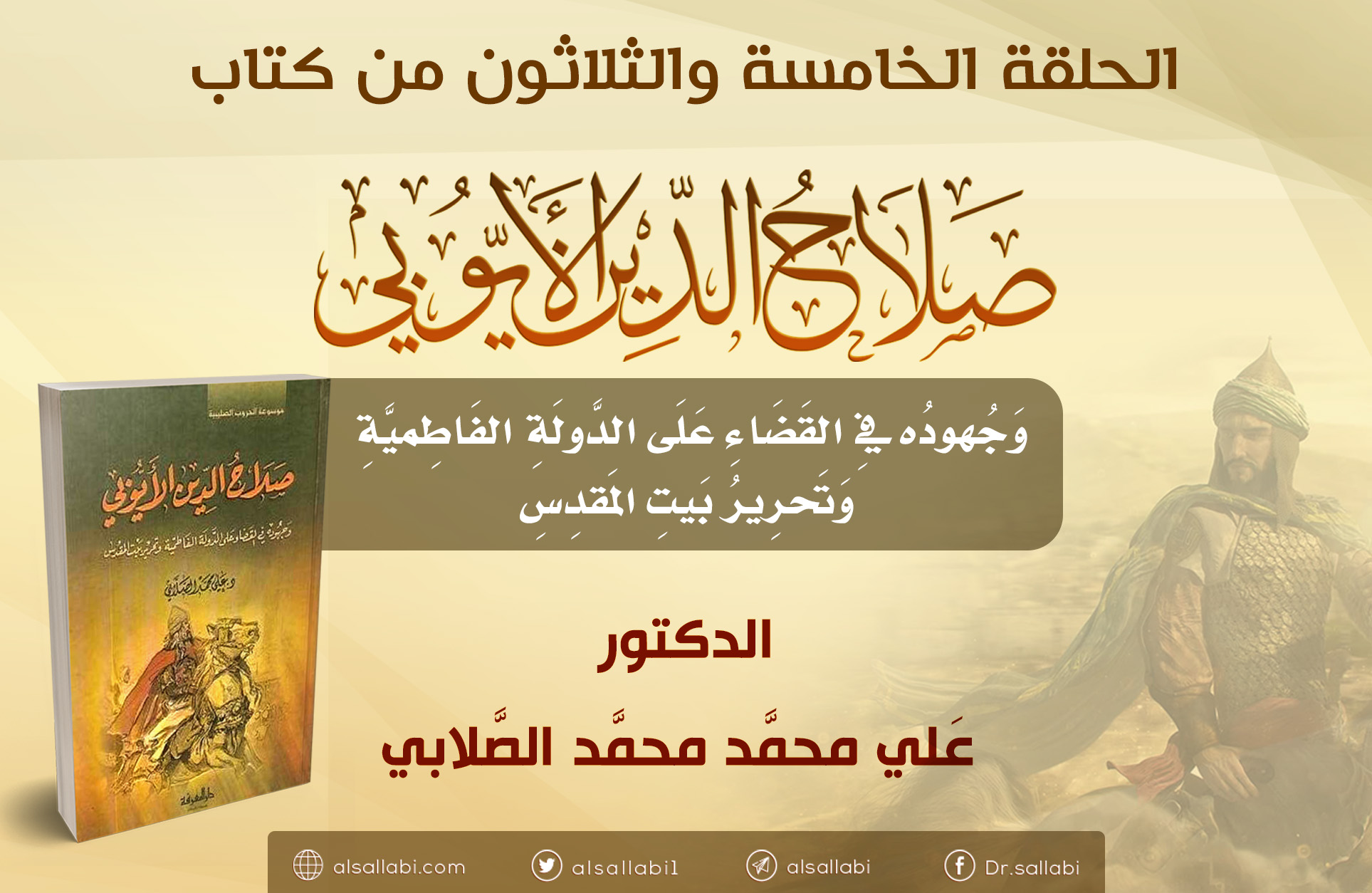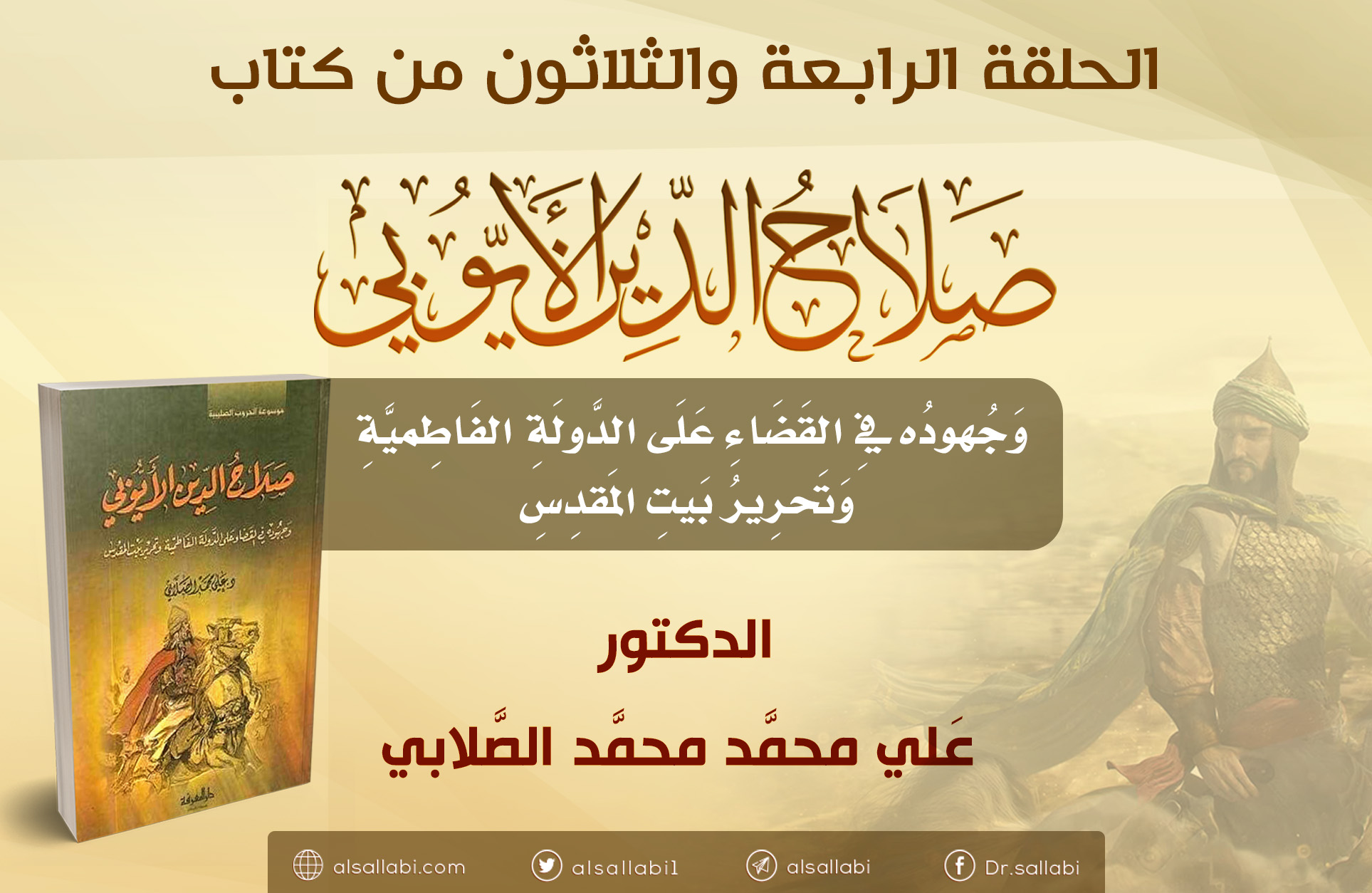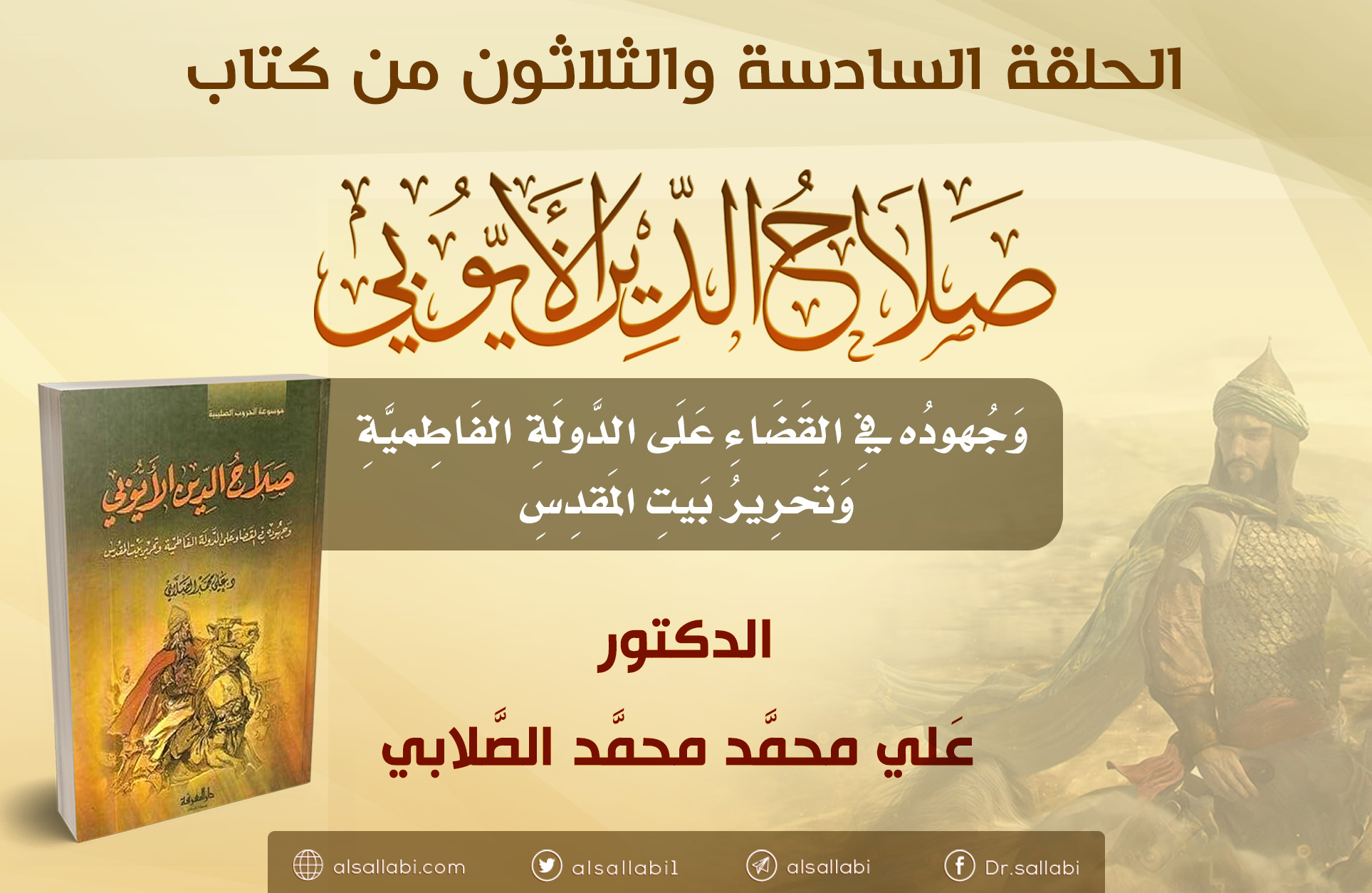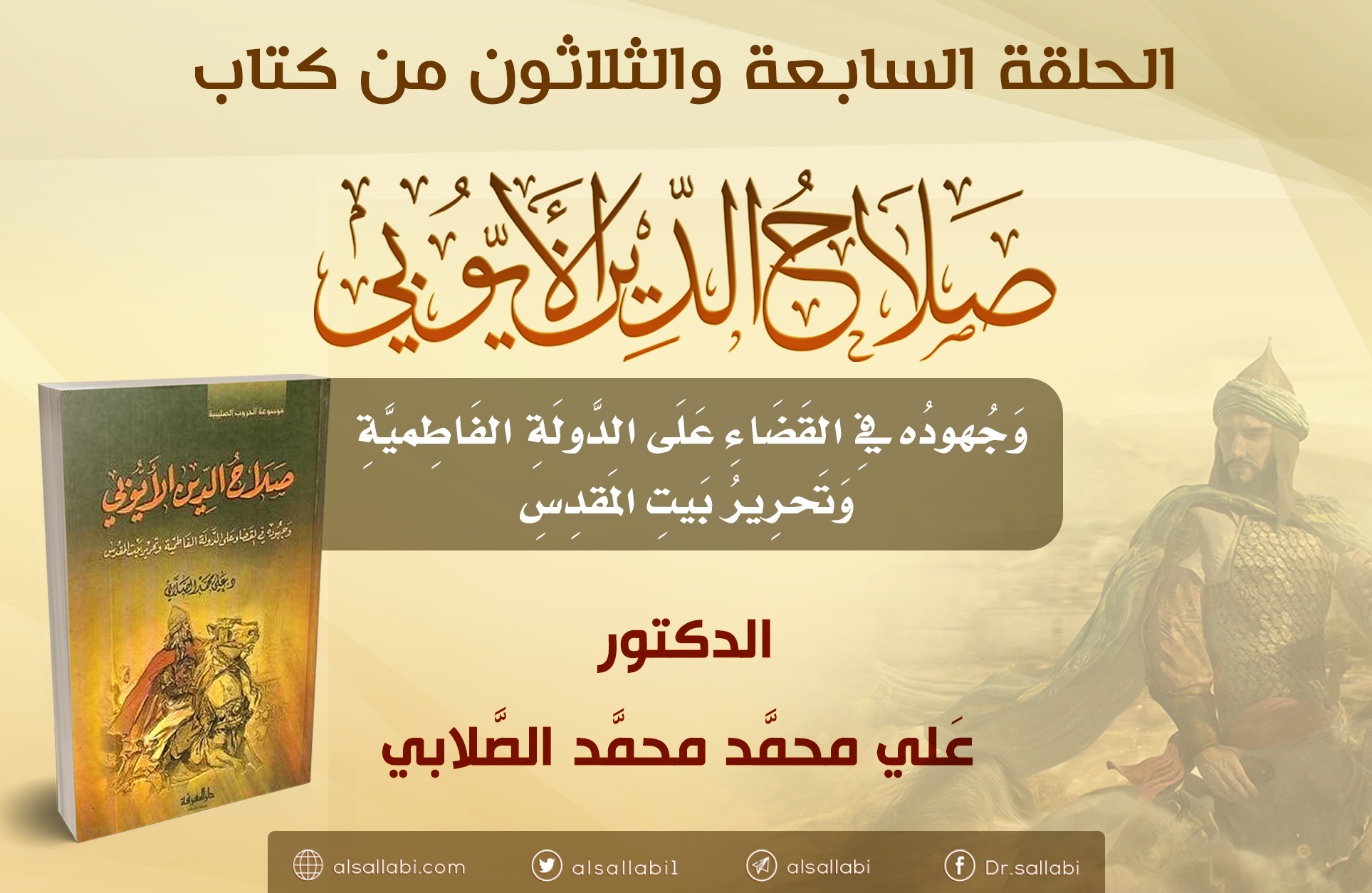في سيرة صلاح الدين الايوبي
عناصر الثقافة السنية في العهد الأيوبي
الحلقة: الخامسة والثلاثون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يونيو 2020
كانت عناية صلاح الدين الأيوبي ، والسَّلاطين الذين جاؤوا بعده للتمكين لمذهب أهل السنة في البلاد التي حكموها عنايةً شاملةً ، ومكثَّفةً في المدن التابعة لهم ، كالقاهرة ، والإسكندرية ، ودمشق ، وحلب ، وغيرها. ومن أهم عناصر الثقافة السنية التي اهتمَّ بها الأيوبيُّون:
1 ـ القرآن الكريم:
اهتمَّ الأيوبيُّون يتلقين القران الكريم للصغار ، وتحفيظهم إيَّاه في البلاد التابعة لهم ، فابن جبير يذكر: أنَّ صلاح الدين أمر بعمارة أماكن متعدِّدة في مصر ، ورتَّب فيها معلَّمين للقران الكريم، يعلِّمون أبناء الفقراء، والأيتام خاصَّةً، وتجرى عليهم الجراية الكافية لهم. ويصور القاضي بهاء الدين بن شدَّاد مدى عناية صلاح الدين بالقران، فيذكر: أنه مرَّ يوماً على طفل صغير يقرأ القران ، فاستحسن قراءته ، فقرَّ به إليه ، وجعل له حظاً من خاصِّ طعامه ، ووقف عليه ، وعلى أبيه جزءاً من مزرعةٍ. وكان يشترط في إمامه ، أن يكون عالماً بعلوم القران ، متقناً لحفظه. وقد مرَّ بنا: أنَّ القاضي الفاضل جعل إلى جانب مدرسته في القاهرة كُتَّاباً وقفه على تعليم الأيتام القران الكريم ، وأنَّه خصَّص إحدى قاعات هذه المدرسة لإقراء القران، وتدريس علم القراءات ، وعندما زار ابن جبير دمشق وجد الجامع الأموي لا يخلو من تلاوة القران الكريم لا صباحاً، ولا مساءً، ولهؤلاء القراء إجراء يومي يعيش منه أكثر من خمسمئة إنسان ، وعند فراغ القراء من التلاوة الصباحية يجلس أمام كلٍّ منهم صبيٌّ يلقنه القران الكريم، وللصبيان على قراءتهم جرايةٌ معلومة أيضاً ، تصل إليهم عدا أبناء ذوي اليسار ، فإنَّ اباءهم ينزهونهم عن أخذها. كما رأى ابن جبير مكاناً بدمشق، يتعلَّم فيه الصبيان القران الكريم، وعليه وَقْفٌ كبير يأخذ منه المعلمون ما يفي بحاجات الصبيان ، وكسوتهم ، وينفقونه عليهم، وكان علم القراءات يدرس بدار الحديث الأشرفية بدمشق ، وبالمدرسة القاهرية بحلب.
2 ـ الحديث الشريف:
واهتمَّ الأيوبيون بالحديث الشريف اهتماماً عظيماً ، وكان هذا الاهتمام تلبيةً لحاجتين ملحَّتين واجههما المجتمع الإسلامي في مصر ، والشام ، وإحداهما عامَّة ، والأخرى خاصَّة ببعض البيئات ، أما العامة؛ فهي: أنَّ المسلمين كانوا يواجهون عدواً يتربَّص بهم الدوائر ، ويعبث بمقدساتهم ، وكان الاهتمام بتحريض المؤمنين على قتالهم يتطلب عنايةً كبيرةً بالحديث الشريف ، وخاصَّةً ، ما يتعلَّق منه بهذا الباب ، لذا وجدنا صلاح الدين شغوفاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يردِّده ، ويسمعه ، بل ويسعى لسماعه ، ويشجِّع على التأليف فيه ، ويذكر العماد الأصفهاني: أنَّه تردَّد معه أثناء زيارته للإسكندرية في عام 572هـ/1176م على الحافظ السلفي ، وسمعوا منه الحديث الشريف ، كما سمع هو ، وأولاده موطَّأ مالك من فقيه الإسكندرية: ابن عوف الزُّهري ، وذلك في عام 577هـ/1181م. ويصف بهاء الدين بن شدَّاد صلاح الدين: بأنه كان شديد الرغبة في سماع الحديث ، وأنه كان يسعى إلى علمائه إذا كانوا ممَّن ينزهون أنفسهم عن حضور مجالس الحكام ، ويستطرد ابن شداد قائلاً: إنه كان يحبُّ أن يقرأ الحديث بنفسه ، ويستحضرني في خلوته ، ويحضر بعضاً من كتب الحديث ، ويقرؤها.
وكان الرَّجل إذا أراد أن يتقرَّب إليه حثَّه على الجهاد ، أو ذكر له شيئاً من أخباره. يقول ابن شداد: ولقد ألِّفَ له كتبٌ عدَّة في الجهاد ، وأنا مِمَّن جمع له فيه كتاباً ، جمعت فيه آدابه ، وكلَّ ايةٍ وردت فيه ، وكلَّ حديثٍ في فضله ، وكان ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يطالعه حتى أخذه منه ولده الأفضل. ولم تكن العناية بالحديث مما اختصَّ به صلاح الدين ، بل إنَّ كثيراً من أمراء الأيوبيين سعى إلى سماع الحديث ، وروايته ، ومنهم: تقي الدِّين عمر؛ الذي سمع من السلفي بالإسكندرية ، والملك الكامل؛ الذي نهج سبيل نور الدين ، وأنشأ بمصر أوَّل دارٍ للحديث الشريف. ووصفه السيوطي بأنَّه كان معظماً للسنة ، وأهلها ، وأنَّه سمع من السلفي ، وأجازه. كما وصفه سبط ابن الجوزي بأنه كان يتكلَّم في صحيح مسلم بكلامٍ مليح. أما الأشرف بن العادل؛ فقد سمع صحيح البخاري في دار الحديث الأشرفية؛ التي أنشأها بدمشق.
هذه الجهود التي نهض بها الأيوبيون للعناية بالحديث كانت استجابة لحاجةٍ عامة تتعلَّق بمتطلَّبات الجهاد في سبيل الله، والحض عليه، ورفع إمكانات المسلمين عن طريق تربيتهم ، وتثقيفهم بعنصر هام من عناصر الثقافة السنية.
وأما الحاجة الخاصة التي تطلب مزيداً من الحفاوة بالحديث الشريف ، فكانت ، تتعلَّق بالبيئات التي ساد فيها النفوذ الشيعي فترةً من الزَّمن ، ذلك: أن الشيعة لا يصحِّحون من الأحاديث إلا ما رواه أهل البيت فقط ، وما ينسبونه إلى أهل البيت لا يخلو من الوضع ، والأكاذيب ، كروايات زرارة ، وجابر الجعفي ، وغيرهم من الكذبة ، ويطعنون فيما سواه ، ويتَّخذون من ذلك وسيلةً إلى الطعن في رواتها ، ولذا كانت العناية بالحديث الشريف في مصر إحياءً لهذا الجانب من جوانب الثقافة السنية.
4 ـ أصول العقيدة السنية:
اهتم الأيوبيون بالمحافظة على أصول العقيدة على مذهب الإمام الأشعري ، فقد كان ـ رحمه الله ـ من العلماء الذين حملوا لواء العلم في كلِّ ميادينه ، وصنوفه ويعدُّ من العلماء الذين جمعوا بين شتَّى المعارف ، والعلوم، والفنون. قال عنه الذهبي: العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن... وكان عجباً في الذَّكاء ، وقوة الفهم ، ولمَّا برع في معرفة الاعتزال كرهه ، وتبرأ منه ، وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى منه ، ثم أخذ يردُّ على المعتزلة ، ويهتك عُوارهم. وذكر الذهبي أيضاً: ولأبي الحسن ذكاءٌ مفرط ، وتبحُّر في العلم ، وله أشياء حسنة ، وتصانيف جمَّة تقضي له بسعة العلم ، ويقول: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول ، يذكر فيها قواعد مذهب السَّلف في الصِّفات ، وقال فيها: تُمَرُّ كما جاءت ، ثم قال: وبذلك أقول ، وبه أدين ، ولا تُؤَوَّل.
وقال عنه القاضي عياض: وصنف لأهل السنة التصانيف ، وأقام الحجج على إثبات السنة ، وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ، ورؤيته ، وقِدَم كلامه ، وقدرته ، وأمور السَّمع الواردة عن الصِّراط ، والميزان ، والشفاعة، والحوض ، وفتنة القبر التي نفت المعتزلة ، وغير ذلك من مذاهب أهل السنة ، والحديث ، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب ، والسنة ، والدلائل الواضحة العقلية ، ودفع شبه المبتدعة ، ومن بعدهم من الملاحدة الرافضة ، وصنَّف في ذلك التصانيف المبسوطة؛ التي نفع الله بها الأمَّة. وأما ابن عساكر؛ فقد أفرد كتاباً في الدِّفاع عنه ، ومدحه كثيراً ، وجعله من المجدِّدين ، وذكر الروايات الواردة في مدح قومه ، وأسرته. وكذلك السِّبكي في طبقات الشافعية ، وكان ممَّا قال فيه: شيخنا ، وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري ، شيخ طريقة أهل السنة ، والجماعة ، وإمام المتكلِّمين ، وناصر سنة سيد المرسلين ، والذابُّ عن الدِّين ، والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعياً يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لربِّ العالمين ، إمام حبر ، تقيٌّ ، بَرٌّ ، حمى جناب الشرع من الحديث المفتري ، وقام في نصرة الإسلام ، فنصره نصراً مؤزراً. وغيرهم من العلماء الذين مدحوه ، وأثنوا على ما قام به من نصر المسلمين ، والردِّ على المبتدعة من المعتزلة ، وغيرهم.
أ ـ المراحل التي مَرَّ بها:
مرَّ أبو الحسن الأشعري بأطوار ثلاثة في حياته الاعتقادية:
الطور الأول:
تكاد أن تجمع كل المصادر التي ترجمت للأشعري على أنه عاش طوره الأوَّل في ظل المعتزلة ، والاعتزال ، وأنه بقي فيه ملازماً شيخه ، وزوج أمِّه الجبائي؛ حتى بلغ أربعين سنةً من عمره.
الطور الثاني:
بعد خروجه على المعتزلة سلك طريق عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ، وبدأ يردُّ على المعتزلة معتمداً على القوانين ، والقضايا التي قالها عبد الله بن كلاب. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع من الاعتزال سلك طريق أبي محمد بن كلاب، وهذا الطور يمثله كتاب: اللُّمع في الرد على أهل الزَّيغ والبدع. وكان ابن كلاب يردُّ على المعتزلة ، والجهمية ، ومن تبعهم بطريقةٍ يميل فيها إلى مذهب أهل السنة ، والحديث ، ولكن لما كثر جداله معهم ، وردُّه عليهم ، ومناظرته لهم بالطرق القياسية؛ سلَّم لهم أصولا هم واضعوها ، فمن هنا دخلت البدعة في طريقته. وكان ابن كلاب قد أحدث مذهباً جديداً ، فيه ما يوافق السَّلف ، وفيه ما يوافق المعتزلة ، والجهمية. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين:
فأهل السنة والجماعة يُثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات ، والأفعال التي يشاؤها ، ويقدر عليها ، والجهمية من المعتزلة ، وغيرهم تنكر هذا ، وهذا ، فأثبت ابن كلاب قيام الصِّفات اللاَّزمة به ، ونفى أن يقوم به ما يتعلَّق بمشيئته ، وقدرته من الأفعال ، وغيرها ، ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي ، وأبو الحسن الأشعري. وهذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب دفع الإمام أحمد بن حنبل ، وغيره من أئمة السَّلف إلى أن يحذِّروا منه ، ومن أتباعه الكلابية. وهذه الطريقة التي أحدثها ابن كلاب البصري لم يسبقه إليها غيره ، ووافقه عليها الأشعري ، وردَّ من خلالها على الجهمية ، والمعتزلة.
الطور الثالث:
مكث الأشعري زمناً على طريقة ابن كلاب يردُّ على المعتزلة ، وغيرهم من خلال ما اعتقده في هذه الطريقة ، ولكنَّ الله تعالى مَنَّ عليه بالحق ، فنَّور بصيرته ، وذلك بالرُّجوع التامِّ إلى مذهب أهل السنة والجماعة ، والتزام طريقتهم ، واتباع منهجهم ، ومسلكهم ، وكان هذا هو الذي أراد أن يلقى الله تعالى عليه متبرئاً من المذاهب التي عاشها ، وداعياً إلى طريقه السَّلف ، ومذهبهم ، ومنتسباً إلى الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وهذا الطور نظراً لأهميته في المجال الاعتقادي؛ فقد أثبتناه له ـ بعد توفيق الله بثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أقوال العلماء:
لقد شهد كثير من العلماء ، والأئمة برجوع الأشعري الرُّجوع التام إلى مذهب السَّلف الصالح ، وهؤلاء الأئمة ما قالوا هذه الشهادة إلا بعد أن سبروا حياته ، وعرفوا ما كان عليه ، وما اسقرَّ عليه. ومن هؤلاء العلماء.
ـ شيخ الإسلام ابن تيمية.
ـ تلميذه الحافظ ابن القيِّم.
ـ الحافظ الذهبي.
ـ الحافظ ابن كثير ، وقد قال رحمه الله: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال:
أولها:
حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة.
الحال الثاني:
إثبات الصفات العقلية السَّبع ، وهي: الحياة ، والعلم ، والقدرة ، والإرادة ، والسَّمع ، والبصر ، والكلام ، وتأويل الصفات الخبرية ، كالوجه ، واليدين ، والقدم ، والساق ، ونحو ذلك.
الحال الثالث:
إثبات ذلك كله من غير تكييف، ولا تشبيه جرياً على منوال السَّلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنَّفها آخراً.
ـ الشيخ نعمان الالوسي.
ـ الشيخ أبو المعالي محمود الالوسي.
ـ العلامة محب الدين الخطيب. وقال رحمه الله في بيان أطوار الأشعري ، ورجوعه التام إلى مذهب السلف: أبو الحسن الأشعري عليُّ بن إسماعيل من كبار أئمة الكلام في الإسلام ، نشأ أوَّل أمره على الاعتزال ، وتتلمذ فيه على الجبائي ، ثم ايقظ الله بصيرته؛ وهو في منتصف عمره ، وبداية نضجه ، فأعلن رجوعه عن ضلالة الاعتزال ، ومضى في هذا الطور نشيطاً يولِّف ، ويناظر ، ويُلقي الدروس في الردِّ على المعتزلة ، سالكاً طريقاً وسطاً بين طريقة الجدل ، والتأويل ، وطريقة السَّلف ، ثمَّ محَّض طريقته وأخلصها لله بالرُّجوع الكامل إلى طريقة السَّلف في إثبات كلِّ ما ثبت بالنَّضِّ من أمور الغيب؛ التي أوجب الله على عباده إخلاص الإيمان بها. وكتب بذلك كتبه الأخيرة ، ومنها في أيدي الناس كتاب «الإبانة» وقد نصَّ مترجموه على أنها اخر كتبه ، وهذا ما أراد أن يلقى الله عليه ، وكل ما خالف ذلك مما يُنسب إليه ، أو صارت تقول به الأشعرية ، فإنَّ الأشعري رجع عنه إلى ما في كتاب الإبانة ، وأمثاله.
الوجه الثاني: التقاؤه الحافظ زكريا الساجي:
بعد خروجه من الاعتزال ، ومن التخلُّص من طريقة ابن كلاب لجأ إلى الأئمَّة من أهل الحديث ممَّن عُرفوا بسلامة عقيدتهم ، وصفاء منهجهم؛ ليأخذ منهم مقالة السَّلف ، وأصحاب الحديث ، ومن أشهرهم: الحافظ الثبت محدِّث البصرة زكريا الساجي. يقول ابن تيمية عن الأشعري: وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة ، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى ، وذلك اخر أمره ، كما ذكره هو ، وأصحابه في كتبهم. وقال الذهبي عندما ترجم للحافظ الساجي: وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الأصولي تحرير مقالة أهل الحديث ، والسَّلف. وقال في مكان اخر عن الساجي: أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السَّلف في الصِّفات ، واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تأليف. ومن الذين أثبتوا للأشعري هذا اللقاء مع المحدِّث الحافظ زكريا الساجي ، وجعلوه نقطة تحول كبيرة عند الأشعريالإمامان: ابن القيم، وابن كثير، وغيرهما.
الوجه الثالث: تأليفه كتاب الإبانة ، وإثباته له:
إنَّ اخرَ الكتب التي ألَّفها الأشعري ـ رحمه الله ـ هو كتاب الإبانة ، وقد ذكر في هذا الكتاب انتسابه للإمام أحمد ، رحمه الله ، والتزامه بعقيدة السَّلف الصالح ، واتباع أئمَّة الحديث. وذكر بعد هذا عقيدة السَّلف الصالح في أمور الدِّين ، ولقد أثبت هذا الكتاب للأشعري جمعٌ كثير من الأئمة من المتقدِّمين ، والمتأخرين، وأقرب العلماء زمناً بزمن الأشعري هو ابن النديم ت385هـ فقد ذكر في كتابه الفهرست ترجمة للأشعري ، وذكر جملةً من كتبه التي ألفها ، ومنها كتاب «التبين عن أصول الدين» وجاء بعده ابن عساكر، وانتصر للأشعري، واثبت له كتاب «الإبانة» ونقل منه كثيراً في كتابه «التبيين» للإشادة بحسن عقيدة الأشعري. قال ابن عساكر عن الأشعري: وتصانيفه بين أهل العلم مشهورةٌ معروفة ، وبالإجادة ، والإصابة للتحقيق عند المحققين موصوفة، ومن وقف على كتابه المسمَّى «الإبانة» عرف موضعه من العلم، والديانة.
ثم جاء ابن درباس ت659هـ، وألَّف كتاباً في الذبِّ عن الأشعري، وأثبت له كتاب الإبانة. وقال: أما بعد.. فاعلموا معشر الإخوان ـ وفقنا الله ، وإيَّاكم للدِّين القويم ، وهدانا جميعاً للصراط المستقيم ـ بأنَّ كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقرَّ عليه أمرُه فيما كان يعتقده ، وبما كان يدين الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بِمَنِّ الله ، ولطفه ، وكل مقالة تُنسب إليه الان مما يخالف ما فيه فقد رجع عنها ، وتبرَّأ إلى الله سبحانه ، وتعالى منها. وروى ، وأثبت ديانة الصحابة ، والتابعين ، وأئمة الحديث الماضين ، وقول أحمد بن حنبل ، رضي الله عنهم أجمعين ، وأنَّه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ، فهل يسوغ أن يُقال: أنه رجع إلى غيره؟ فإلى ماذا يرجع تراه؟ أيرجع عن كتاب الله وسنة نبي الله ، خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون ، وأئمة الحديث الماضون ، وقد علم أنَّه مذهبهم ، ورواه عنهم؟! هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين؛ كيف بأئمة الدِّين. وقد ذكر هذا الكتاب ، واعتمد عليه ، وأثبته عن الإمام الحسن ـ رحمه الله ـ وأثنى عليه بما ذكره فيه ، وبرَّأه من كل بدعة نسبت إليه ، ونقل منه إلى تصنيفه جماعةٌ من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام ، وأئمة القراء ، وحفَّاظ الحديث ، وغيرهم. ثم ذكر ـ رحمه الله ـ جماعة من هؤلاء الأئمة الذين أثبتوا كتاب «الإبانة» للأشعري ، ومنهم:
ـ إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي (ت446هـ).
ـ الحافظ أبو عثمان الصابوني (ت449هـ).
ـ الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي (ت458هـ).
ـ الإمام الفقيه أبو الفتح نصر المقدسي (ت490هـ).
ـ الفقيه أبو المعالي مجلي صاحب كتاب الذخائر في الفقه (ت 550هـ.
وهناك جمع كثير من العلماء ممَّن أثبت كتاب «الإبانة للأشعري» غير الذين ذكرهم ابن درباس ، ومنهم.
ـ الإمام ابن تيمية ، رحمه الله (ت728هـ).
ـ الحافظ للذهبي (ت 748هـ) ، وقال: وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن ، شهره الحافظ ابن عساكر ، واعتمد عليه ، ونسخه بخطِّه الإمام محيي الدين النووي.
ـ الإمام ابن القيم (ت571هـ).
ـ الحافظ ابن كثير (ت774هـ).
ـ العلامة ابن فرحون المالكي (ت799هـ). وهناك جمع كثير لا يُحصى عددهم من العلماء ، والأئمة من الذين أثبتوا كتاب الإبانة للأشعري ، وأنَّه اخر ما صنَّف.
وقد ذكر المؤرخون مجموعةً من الأسباب في سبب رجوع أبي الحسن إلى مذهب أهل السُّنة ، وترك الاعتزال ، وأهمها: رحمة الله به ، وهدايته له.
ب ـ سِرُّ عظمة الأشعري في التاريخ:
نهض أبو الحسن الأشعري بعد هذا التحوُّل العظيم ، يدعو إلى عقيدة أهل السنة ، ويدافع عنها في حماسةٍ ، وإيمان، ويردُّ على المعتزلة ، ويتتبَّعهم في مجالسهم ، ومراكزهم ، يحاول إقناعهم بما اقتنع به أخيراً من عقائد أهل السنة ، ومذاهب السَّلف ، وكان نشاطه في ذلك أعظم من نشاطه في السَّابق ، وكان يقصدهم بنفسه يناظرهم ، فكُلِّم في ذلك ، فقد قيل له: كيف تُخالط أهل البدع ، وتقصُدهم بنفسك ، وقد أمرت بهجرهم؟ فقال: هم أولو رياسة ، منهم الوالي ، والقاضي ، ولرياستهم لا ينزلون إليَّ ، فإذا كانوا هم لا ينزلون إليَّ ، ولا أسير أنا إليهم ، فكيف يظهر الحقُّ ، ويعلمون: أن لأهل السنة ناصراً بالحجَّة؟!.
وهذه الجهود العظيمة ، والمثابرة الصابرة في مناصرة مذهب أهل السنة تستحقُّ الثناء ، والتقدير. وكان أبو الحسن الأشعري في مستواه العقلي أعلى من مستوى معاصريه ، وأقرانه ، وكان صاحب نبوغ ، وابتكار في العقليات ، وكان يردُّ على حُجج المعتزلة ، وعقائدهم في سهولة ، وينقُضها بمقدرةٍ وثقةٍ ، كما يرد الأستاذ الكبير على شبه تلاميذه ، ويحلُّ مشاكلهم. وقد كان أبو الحسن الأشعري إماماً مجتهداً في علم الكلام ، وأحد مؤسسيه ، وقد خضع كلُّ مَنْ جاء بعده من المتكلِّمين لعبقريته ، وعُمْقِ كلامه ، ودقَّة نظره ، وإصابة فكره.
ج ـ أبو الحسن الأشعري يشرح عقيدته التي يدين بها:
فيقول: وقولنا الذي نقول به ، وديانتنا التي نَدين بها: التمسُّك بكتاب ربِّنا ، عزَّ وجلَّ ، وبسنَّة نبينا ، عليه السلام، وما رُوي عن الصحابة ، والتابعين ، وأئمَّة الحديث ، ونحن بذلك معتصمون ، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ـ نضَّر الله وجهه ، ورفع درجته ، وأجزل مثوبته ـ قائلون ، ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنَّه الإمام الفاضل ، والرئيس الكامل؛ الذي أبان الله به الحقَّ ، ورفع به الضَّلال ، وأوضح به المنهاج ، وقمع به بدع المبتدعين ، وزَيْغَ الزائغين ، وشَكَّ الشاكِّين ، فرحمة الله عليه من إمام مُقَدَّم ، وخليلٍ معظَّم مضخَّم!.
ولم تقتصر خدمة الأشعري على تأييد عقائد أهل السنة ، والسَّلف تأييداً إجمالياً ، فقد كان الحنابلة ، والمحدِّثون قائمين به ، غير مقصرِّين فيه ، بل إنَّ عبقريته تتجلَّى في أنَّه أقام البراهين ، والدلائل العقلية ، والكلامية على هذه العقائد ، وناقش المعتزلة ، والمتفلسفة عقيدةً ، وذلك كلُّه في لغةٍ يفهمونها ، وأسلوبٍ يألفونه ، ويُجلُّونه ، وبذلك اثبت: أنَّ هذا الدِّين ، وعقيدته الواضحة مؤيَّدان بالعقل ، وأنَّ العقل الصَّحيح يويِّد الدين الصَّحيح ، ولا صراع بينهما ، ولا تناقض.
د ـ مصدر العقيدة عند أبي الحسن الأشعري:
كان الأشعري مؤمناً بأنَّ مصدر العقيدة ، والمسائل التي تتَّصل بالإلهيات ، وما وراء الطبيعة هو الكتاب ، والسنَّة ، وما جاء به الأنبياء ، وليس العقل المجرَّد ، والمقياس ، والميتافيزيقا اليونانية ، ولكنَّه لم يكن يرى السُّكوت ، والإعراض عن المباحث التي حدثت بتطورات الزَّمان ، واختلاط هذه الأمَّة بالأمم ، والدِّيانات ، والفلسفات الأجنبية؛ حتى تكوَّنت على أساسها فرقٌ ، ونحل ، وكان يرى: أنَّ السكوت عن هذه المباحث يضرُّ بالإسلام ، ويُفْقد مهابه السُّنَّة ، ويحمل على ذلك ضعف السنة العلمي ، والعقلي ، وعجز علماء الدين ، وممثليه عن مواجهة هذه التيارات ، ومقاومة هذه الهجمات ، ويَهتبلهُ أهل الفرق الضالَّة ، فينفذون في أهل السنة ، والعقيدة الصَّحيحة، فينفثون فيهم ، ويزرعون الشكوك ، ويستميلون شبابهم الذكيَّ المثقَّف إلى أنفسهم.
وكان الأشعري مؤمناً بأنَّ مصدر العقيدة هو الوحي ، والنبوة المحمَّدية ، والطريق إلى معرفته هو الكتاب ، والسنة، وما ثبت عن الصحابة ، رضي الله عنهم ، وهذا مُفترق الطريق بينه وبين المعتزلة ، فإنَّه يتَّجه في ذلك اتجاهاً معارضاً لاتجاه المعتزلة ، ولكنَّه رغم ذلك يعتقد مخلصاً: أنَّ الدفاع عن هذه العقيدة السليمة ، وغَرسها في قلب الجيل الإسلامي الجديد ، يحتاج إلى الحديث بلغة العصر العلمية السَّائدة ، واستعمال المصطلحات العلمية ، ومناقشة المعارضين على أسلوبهم العقلي ، ولم يكن يسوِّغ ذلك فقط ، بل يَعدُّه أفضلُ الجهاد ، وأعظم القربات في ذلك العصر ، وهذا مفترق الطريق بينه وبين بعض من الحنابلة ، والمحدِّثين الذين كانوا يتأثَّمون ، ويتحرَّجون من النزول في هذا المستوى
هـ بعض مؤلفات أبي الحسن الأشعري:
لم يقتصر أبو الحسن الأشعري على المناظرة ، والمعارضة ، بل خلَّف مكتبةً من مؤلفاته في الدِّفاع عن السنة ، وشرح العقيدة الحسنة ، وقد ألَّف تفسيراً للقران ، أقلُّ ما قيل في أجزائه أنَّه في ثلاثين مجلداً ، وقد ذكر بعض المؤلفين: أنَّ مؤلفاته تبلغ إلى ثلاثمئة مؤلف ، أكثرها في الردِّ على المعتزلة ، وبعضها في الردِّ على مذاهب ، وفرق أخرى ، ومنها: كتاب «الفصول» الذي ردَّ على الفلاسفة ، والطبيعيين ، والدَّهرية ، والبراهمة ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وهو كتاب كبير يحتوي على اثني عشر كتاباً. وقد ذكر ابن خلِّكان من مؤلفاته كتاب «اللُّمع» و«إيضاح البرهان» و«التبيين عن أصول الدبن» و«الشرح والتفصيل في الردِّ على أهل الإفك والتضليل». وله ـ عدا العلوم العقلية ، والكلام ـ مؤلفاتٌ في علوم الشريعة ، منها: «كتاب القياس» و«كتاب الاجتهاد» و«خبر الواحد» وكتاب في الرد على ابن الراونديِّ في إنكاره للتواتر ، وقد ذكر في كتابه«العمد» مؤلفاته التي فرغ منها سنة 320هـ يعني: قبل وفاته بأربع سنوات ، وهي ثمانٌ وستُّون مؤلفاً ، وكثيرٌ منها يقع في عشرة مجلدات ، أو أكثر ، وقد ألَّف في اخر حياته كتباً كثيرة ، ويدلُّ كتابه: «مقالات الإسلاميين» على أنه لم يكن متكلِّماً ، فحسب ، بل كان مؤرِّخاً أميناً لعلم العقائد ، وقد اعترف بدقَّته ، وأمانته ، وتحرِّيه للصدق في النقل المستشرقون ، وكتب الفرق ، والديانات تدلُّ على أمانته ، ودقَّته في النقل.
و ـ اجتهاده في العبادة:
لم يكن أبو الحسن الأشعري رجل علمٍ ، وعقلٍ ، وبحثٍ ، ونظرٍ فحسب ، بل كان ـ مع وصوله إلى درجة الإمامة ، والاجتهاد في العلم ، والعقل ـ مجتهداً في العبادات ، متحلِّياً بالأخلاق الفاضلة ، وذلك ما يمتاز به العلماء الأقدمون؛ فإنَّ اشتغالهم بالعلم لم يكن مانعاً لهم عن الاجتهاد في العبادات ، والحرص على الطَّاعات ، وكانوا يجمعون بين الدراسة ، والإفادة ، والعبادة ، والزهادة. قال أحمد بن علي الفقيه: خدمت الإمام أبا الحسن بالبصرة سنين ، وعاشرته ببغداد إلى أن توفي ـ رحمه الله ـ فلم أجد. أورعَ منه ، وأغضَّ طرفاً ، ولم أر شيخاً أكثر حياءً منه في أمور الدُّنيا ، ولا أنشط منه في أمور الاخرة. ويحكي أبو الحسن السَّروي من عبادته في الليل ، واشتغاله ما يدلُّ على حرصه ، وقوَّته في العبادة. قال ابن خلِّكان: وكان يأكل من غَلَّةِ ضيعةٍ وقفَها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى على عَقِبهِ ، وكانت نفقته في كلِّ يوم سبعة عشر درهماً. هكذا قاله الخطيب
ز ـ عقيدة أبي الحسن الأشعري التي مات عليها:
قال أبو الحسن الأشعري: هذه حكاية جملة ما عليه أهل الحديث ، والسنة:
1 ـ الإقرار بالله ، وملائكته ، ورسله ، وأنَّ محمداً عبده ، ورسوله.
2 ـ وأنَّ الجنة حقٌّ ، وأنَّ النار حقٌّ ، وأنَّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها ، وأنَّ الله يبعث من في القبور.
3 ـ وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال: {ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥}.
4 ـ وأن له يَدَيْنِ بلا كيفٍ ، كما قال: {خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ}.
5 ـ وأن له عينين بلا كيفٍ ، كما قال: {تَجۡرِي بِأَعۡيُنِنَا}.
6 ـ وأنَّ له وجهاً ، كما قال: {وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧}.
7 ـ وأنَّ أسماء الله لا يقال: إنَّها غير الله ، كما قالت المعتزلة ، والخوارج.
8 ـ وأقرُّوا: أنَّ لله سبحانه علماً كما قال: {أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦۖ} [النساء: 166] ، وقال: {وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلۡمِهِۦۚ} [فاطر: 11] .
9 ـ وأثبتوا السمع ، والبصر ، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة.
10 ـ وأثبتوا لله القوَّة كما قال: {أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗۖ } [فصلت: 15] .
11 ـ وقالوا: إنَّه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله.
12 ـ وأنَّ الأشياء تكون بمشيئة الله، كما قال عزَّوجلَّ: {وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ} [التكوير: 29]. وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان، وما لا يشاء لا يكون.
13 ـ وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يعلمه الله ، أو يفعل شيئاً علم الله: أنه لا يفعله.
14 ـ وأقرُّوا: أنه لا خالق إلا الله ، وأن سيئات العباد يخلقها الله ، وأنَّ أعمال العباد يخلقها الله عزَّ وجلَّ ، وأنَّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً.
15 ـ ويقولون: إن القران كلام الله غير مخلوق.
16 ـ والكلام في الوقت ، واللَّفظ ، ومن قال باللَّفظ ، أو الوقت فهو مبتدع عندهم لا يقال: اللفظ بالقران مخلوق ، أو غير مخلوق.
17 ـ ويقولون: إنَّ الله سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون، ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون، قال الله عزَّ وجلَّ: {كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ ١٥} [المطففين: 15]. وأنَّ موسى ـ عليه السلام ـ سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا ، وأنَّ الله سبحانه تجلَّى للجبل ، فجعله دكَّاً ، فأعلمه: أنَّه لا يراه في الدنيا ، بل يراه في الاخرة.
18 ـ ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنى ، والسرقة ، وما أشبه ذلك من الكبائر ، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون ، وإن ارتكبوا الكبائر.
19 ـ والإيمان عندهم هو الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، وبالقدر خيره ، وشرِّه ، حلوه ، ومره ، وأنَّ ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ، وما أصابهم لم يكن ليخطئهم.
20 ـ والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الحديث. والإسلام عندهم غير الإيمان.
21 ـ ويقرُّون بأنَّ الله سبحانه مقلِّب القلوب.
22 ـ ويقرُّون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمَّته ، وبعذاب القبر ، وأنَّ الحوض حقٌّ ، والصراط حقٌّ ، والبعث بعد الموت حقٌّ.
23 ـ والمحاسبة من الله عزَّ وجلَّ للعباد حقٌّ ، والوقوف بين يدي الله حقٌّ.
24 ـ ويقرُّون بأنَّ الإيمان قولٌ ، وعملٌ ، يزيد ، وينقص ، ولا يقولون مخلوقٌ ، ولا غير مخلوق.
25 ـ ويقولون: اسماء الله هي الله.
26 ـ ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ، ولا يحكمون بالجنَّة لأحد من الموحِّدين ، حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شاء ، ويقولون: أمرهم إلى الله؛ إن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم ، ويؤمنون بأنَّ الله سبحانه يخرج قوماً من الموحِّدين من النار على ما جاءت به الرِّوايات عن رسول الله.
27 ـ وينكرون الجدال ، والمراء في الدِّين ، والخصومة في القدر ، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للرِّوايات الصَّحيحة، والاثار التي رواها الثقات عدلاً عن عدل؛ حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقولون: كيف ، ولا لِمَ؛ لأنَّ ذلك بدعة.
28 ـ ويقولون: إنَّ الله لم يأمر بالشرِّ بل نهى عنه ، وأمر بالخير ، ولم يرض بالشرِّ وإن كان مريداً له.
29 ـ ويعرِّفون حقَّ الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم ، ويمسكون عمَّا شجر بينهم صغيرهم ، وكبيرهم.
30 ـ ويقدِّمون أبا بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علياً رضوان الله عليهم.
31 ـ ويقرُّون: أنهم الخلفاء الرَّاشدون المهديُّون ، وهم أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
32 ـ ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا ، فيقول: هل من مستغفرٍ؟ كما جاء الحديث عن رسول الله.
33 ـ ويأخذون بالكتاب ، والسنة ، كما قال الله عزَّ وجلَّ: {فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ} [النساء: 59] .
34 ـ ويرون اتباع مَنْ سلف من أئمَّة الدِّين ، ولا يبتدعون في دينهم ما لم يأذن به الله.
35 ـ ويقرُّون أنَّ الله سبحانه يجيء يوم القيامة، كما قال: {وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ٢٢} [الفجر: 22].
36 ـ وأنَّ الله يَقْرُب من خلقه كيف شاء، كما قال: {وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ ١٦} [ق: 16].
37 ـ ويرون العيد ، والجماعة خلف كلَّ إمام برٍّ ، وفاجر.
38 ـ ويثبتون المسح عن الخفين سُنَّةً ، ويرونه في الحضر ، والسفر.
39 ـ ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى اخر عصابه تقاتل الدَّجال ، وبعد ذلك.
40 ـ ويرون الدُّعاء لأئمَّة المسلمين بالصَّلاح ، وألا يخرجوا عليهم بالسَّيف ، وألا يقاتلوا في الفتنة.
41 ـ ويصدِّقون بخروج الدَّجال ، وأنَّ عيسى بن مريم يقتله.
42 ـ ويؤمنون بمنكر ، ونكير ، والمعراج ، والرُّؤيا في المنام.
43 ـ وأنَّ الدعاء لموتى المسلمين ، والصدقة عنهم بعد موتهم تصلُ إليهم.
44 ـ ويصدِّقون بأنَّ في الدنيا سحرةٌ ، وأنَّ الساحر كافرٌ ، كما قال الله ، وأنَّ السحر كائن موجودٌ في الدنيا.
45 ـ ويرون الصلاة على كلِّ من مات من أهل القبلة بَرِّهم ، وفاجرهم ، وموارثتهم.
46 ـ ويقرُّون أنَّ الجنة ، والنار مخلوقتان.
47 ـ وأنَّ مَنْ مات مات بأجله ، وكذلك مَنْ قُتِل قتل بأجله.
48 ـ وأنَّ الأرزاق من قِبل الله سبحانه ، يرزقها عباده حلالاً ، كانت أم حراماً.
49 ـ وأنَّ الشيطان يوسوس للإنسان ، ويشكِّكه ، ويخبطه.
50 ـ وأنَّ الصالحين قد يجوز أن يخصَّهم الله بآيات تظهر على أيديهم.
51 ـ وأنَّ السنة لا تَنْسَخُ القرآن.
52 ـ وأنَّ الأطفال أمرُهم إلى الله؛ إن شاء؛ عذَّبهم ، وإن شاء؛ فعل بهم ما أراد.
53 ـ وأنَّ الله عالم ما العباد عاملون ، وكتب: أنَّ ذلك يكون ، وأن الأمور بيد الله.
54 ـ ويرون الصَّبر على حكم الله ، والأخذ بما أمر الله به ، والانتهاء عما نهى عنه، وإخلاص العمل، والنَّصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين، والنصيحة بجماعة المسلمين، واجتناب الكبائر، والزنى، وقول الزور، والعصبية، والفخر، والكبر، والإزراء على الناس، والعجب.
55 ـ ويرون مجانبة كلَّ داعٍ إلى بدعة.
56 ـ ويرون التشاغل بقراءة القران، وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع التواضع، وحسن الخلق، وبذل المعروف، وكفِّ الأذى، وترك الغيبة، والنميمة، والسعاية، وتفقد المأكل ، والمشرب.
57 ـ فهذه جملة ما يأمرون به ، ويستعلمونه ، ويرونه. وبكلِّ ما ذُكر من قولهم نقول ، وإليه نذهب ، وما توفيقنا إلا بالله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وبه نستعين ، وعليه نتوكَّل ، وإليه المصير.
هذه عقيدة الإمام الأشعري التي استقرَّ عليها ، وصرح بها ، وهي من الاثار التي تركها بعد وفاته. وقد ساهمت بلا شك في توعية الأمة ، وتربيتها على أصول أهل السنة والجماعة سواء في المدارس النظامية في عهد السلاجقة ، أو في عهد الزنكيين ، والأيوبيين ، والمماليك ، والعثمانيين ، وإلى يومنا هذا. ومن الإنصاف العلمي القول بأن المذهب الأشعري لم يستقرَّ على ما مات عليه الإمام أبو الحسن الأشعري ، بل حدث تطوُّر في المذهب الأشعري؛ بحيث: إنَّ أقوال الأشاعرة تعدَّدت ، واختلفت في مسائل عديدة ، ومن أشهر الذين اجتهدوا ، وخالفوا أبا الحسن الأشعري ، في بعض المسائل ، أبي بكر الباقلاني ، وابن فورك ، وعبد القاهر البغدادي ، والبيهقي ، والقشيري ، والجويني ، والغزالي ، وغيرهم على درجاتٍ متفاوتة بينهم في ذلك ، وقد قام الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود بتتبُّع هذا التطوُّر بنوعٍ من التفصيل في كتابه القيِّم: موقف ابن تيمية من الأشاعرة.
ـ وفاتـه:
وكانت وفاته سنة 324هـ ودفن ببغداد في مشروع الزوايا ، ونودي على جنازته: اليوم مات ناصر السنة.
هذه هي العقـيدة السنية التي سارت عليها الدولـة الأيوبية ، ولقد قـام علماء السنة يتفنيد فكرة النصِّ التي قال بها الشيعة الرافضة ، وبنوا عليها مذهبهم في الإمامة ، وأوضحوا تهافتها اعتماداً على ما تمَّ من اختيار أبي بكر ، ومبايعة المسلمين له في يوم السَّقيفة. وفي نفس الوقت ، راح دعاة السنة يؤكِّـدون شرعية خلفاء بني العبـاس السنِّيين في الخلافـة ، وحكم جميع بلاد المسلمين ، ويظهرون مثالب الفكر الباطني الإسماعيلي ، وما انطوى عليه من مغالطات ، وتدليس ، ويبينون بطـلان النَّسب الفاطمي ، وانتسابهم لعليِّ بن أبي طالب ، ولقد استفاد الأيوبيون من السَّلاجقة ، والزنكيين في وسائل نشر العقيدة السنية الإسلامية بمصر ، وفي أنحاء الدولة الأيوبية ، وقد كانت العقيدة الإسلامية السنية ، ووسائل نشرها من ناحيةٍ ، والفقه الشَّافعي السنِّي من ناحيةٍ أخرى كانت تمثِّل في العصر الأيوبي إحدى شقي الدَّعوة السنية؛ التي نشرها الأيوبيُّون بعد قضائهم على الدَّعوة الشيعية الإسماعيلية.
يمكنكم تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/66.pdf