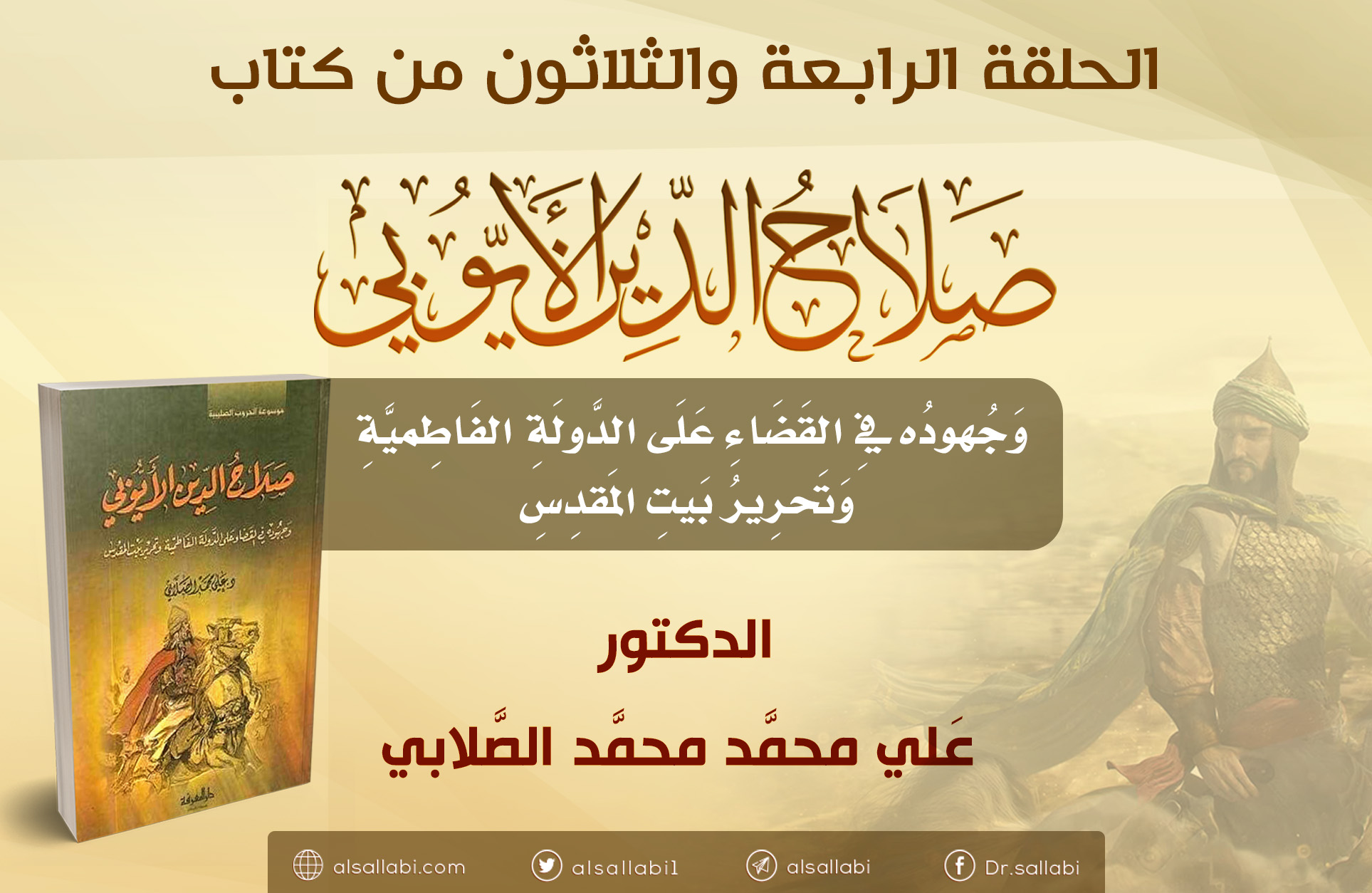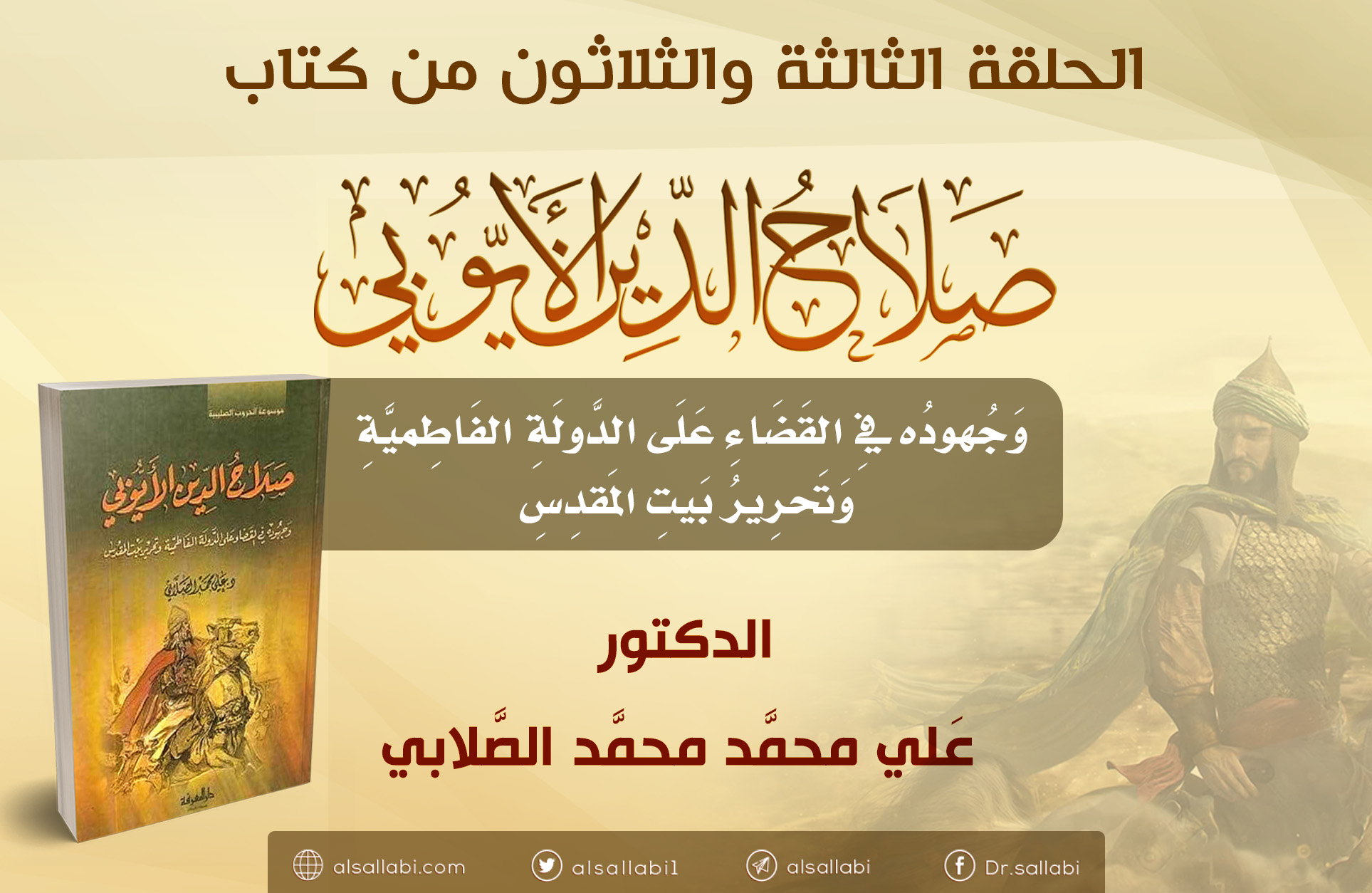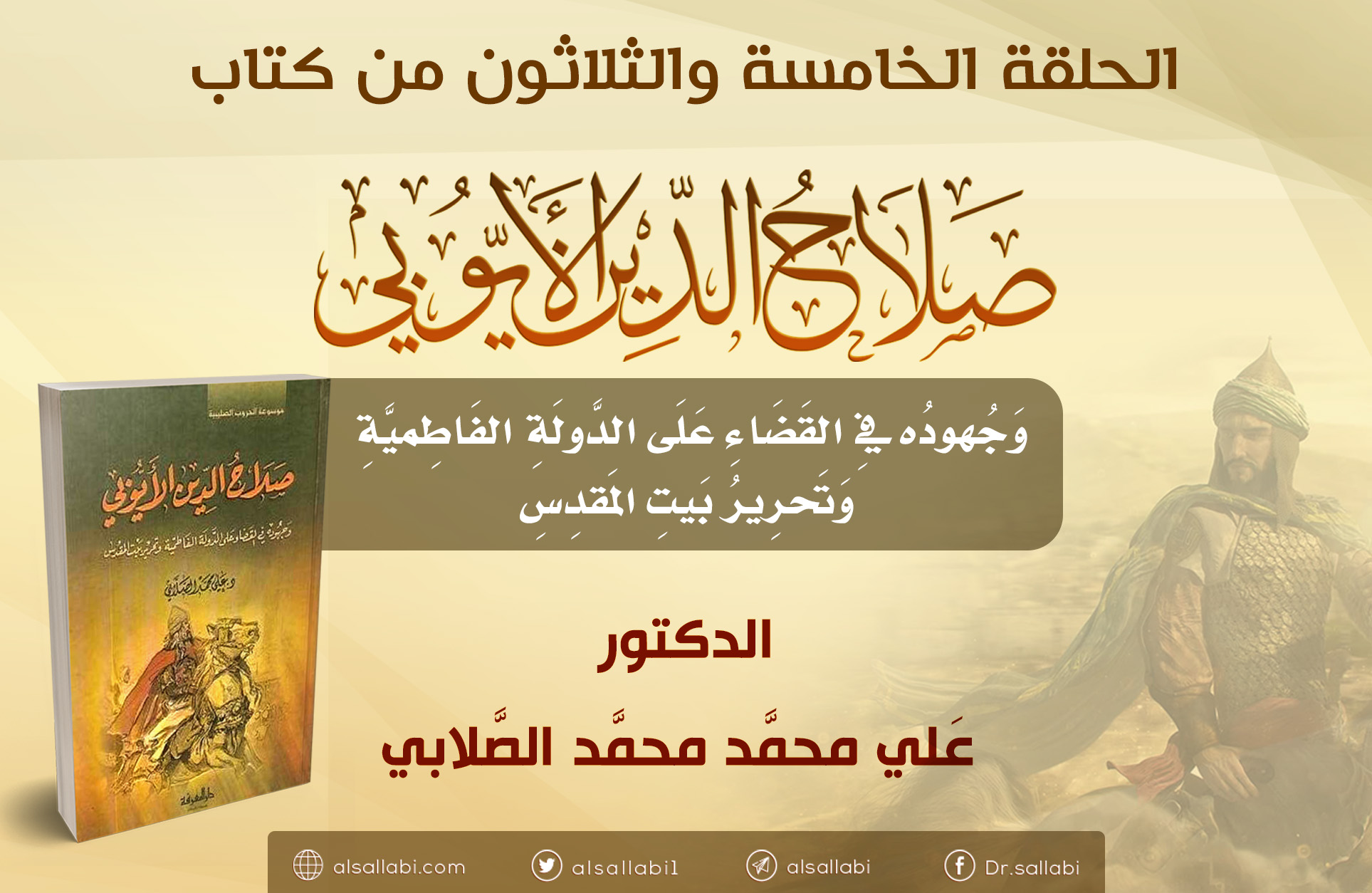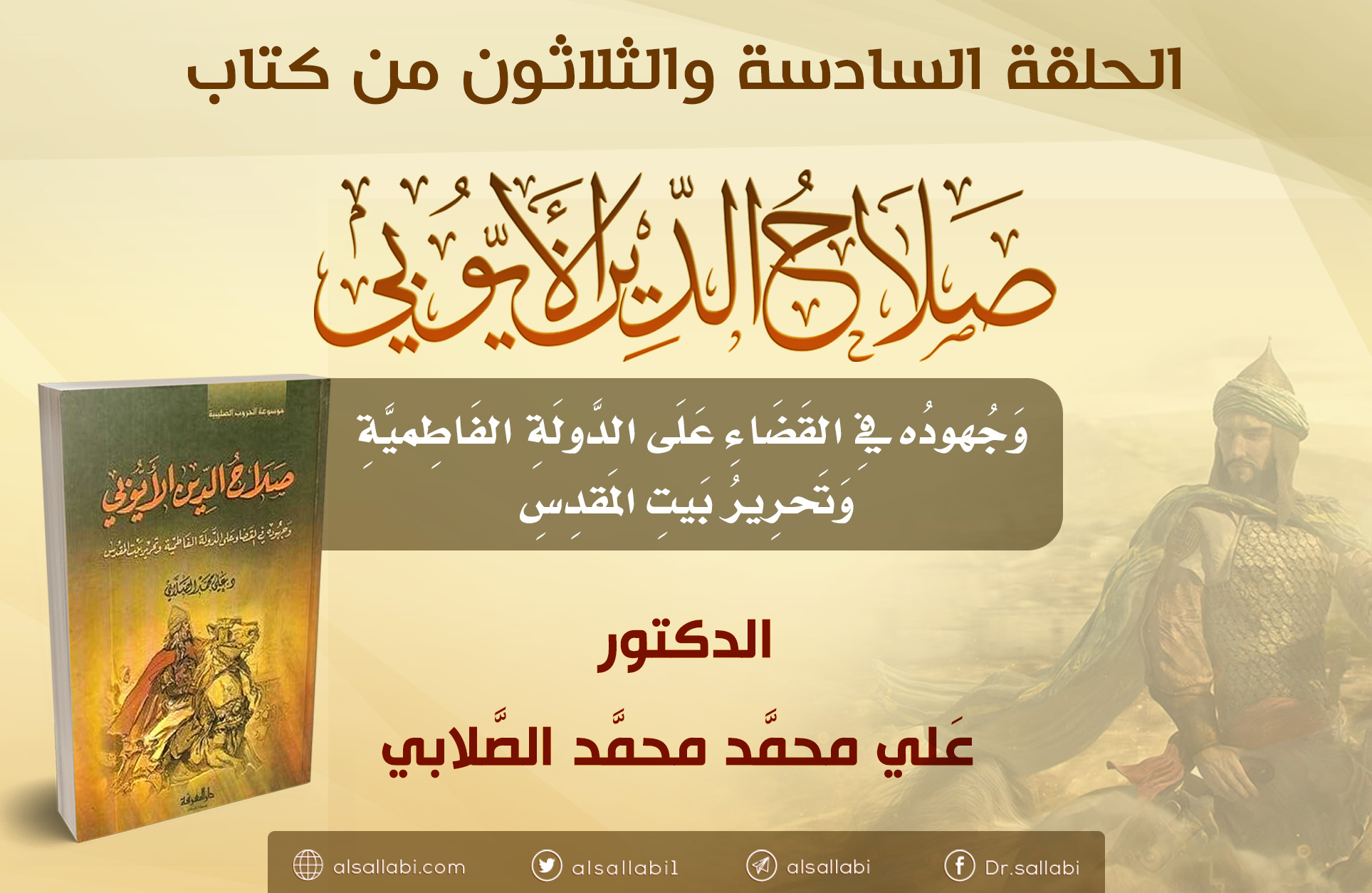في سيرة صلاح الدين: عقيدة الدولة الأيوبية
الحلقة: الرابعة والثلاثون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يونيو 2020
كانت العودة إلى هوية الأمَّة المسلمة ، وإلى عقيدة أهل السنة، والجماعة ، من أبرز معالم التجديد في العهد الزنكي، والأيوبي ، ولقد طال الانحراف ، وانتشرت البدع ، تحميها دولة ظالمةٌ ، وهي الدولة الفاطمية العبيدية بمصر ، فكانت العودة إلى تحكيم الكتاب ، والسنة من أضخم منجزات الدَّولتين النورية ، والصلاحية ، فقد أُقيم العدل ، وقُمعت البدع ، وصبغت الدولة بالصِّبغة الإسلامية الصَّافية. وقد سار صلاح الدين الأيوبي على نهج نور الدين زنكي بتطبيق الشرع في سائر أمور الدولة ، وتنفيذ العدل ، وقضى على المظالم ، وكان يشرف بنفسه لرفع المظالم ، واعتمد في ذلك على القضاة ، والفقهاء. وكان صلاح الدين قد اتصف بالإيمان ، والعبادة ، والتقوى ، والخشية من الله ، والثقة به ، والالتجاء إليه ، وكان حسن العقيدة ، كثير الذكر لله تعالى ، وصبغ دولته بعقيدة أهل السنة والجماعة التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهجها الخلفاء الراشدون ، واستمرَّ الأيوبيون بعد وفاة صلاح الدين على هذه العقيدة ، وكان صلاح الدين كثير التعظيم لشعائر الدين ، وكان مبغضاً للفلاسفة ، والمعطلة ، ومن يعاند الشريعة ، وإذا سمع عن معاند ملحدٍ في مملكته كان يأمر بقتله.
ولقد حارب المذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي ، واستطاع أن ينفذ المخطط الذي وضعه نور الدين زنكي للقضاء على الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية ، وعمل على محاربة العقائد الفاسدة في مصر ، وإعادة الفكر الإسلامي الصحيح إليها عبر استراتيجيةٍ واضحة ، وقد استفادت الدولة الأيوبية من الجهود العلمية ، والوسائل الدعوية من الدولة السَّلجوقية ، والزنكية ، والغزنوية ، فالدَّولة الأيوبية جاءت بعد دول سنية ساهمت في نشر الكتاب ، والسنة في الأمَّة الإسلامية. وقد اهتم صلاح الدين الأيوبي بالمحافظة على أصول العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة ، ونهجوا نهج المذهب الأشعري ، وحرصوا على محاربة أيَّ انحراف عنها ، والقضاء على مظاهره وكان معظم الأيوبيين علماء بأصول هذه العقيدة.
يقول ابن شداد عن صلاح الدين: وكان رحمه الله حسن العقيدة ، كثير الذكر لله تعالى ، قد أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع مشايخ العلم ، وأكابر الفقهاء ، فتحصَّل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه ، غير مارق سهم النظر فيها إلى التعطيل ، والتمويه... وقد جمع له الشيخ قطب الدين النيسابوري عقيدة تجمع ما يحتاج إليه في هذا الباب ، وكان من شدَّة حرصه عليها يعلمها الصِّغار من أولاده ، حتى ترسخ في أذهانهم في الصِّغر ، ورأيته وهم يقرؤونها بين يديه.
ولقد سعت الدولة الأيوبية إلى نشر عقيدة أهل السنة في مصر ، وكافة أرجائها ، وقد حرص صلاح الدين على أن تكون عقيدة أهل السنة هي ذات النفوذ في المؤسسات الفكرية؛ التي أنشأها:
أولاً: توسُّع الأيوبيين في إنشاء المدارس السُّنِّيَّة:
بدأت هذه المرحلة في عام 572هـ/1176م أي: بعد تمكن صلاح الدين من إخضاع معظم الشام لسلطانه ، ثم عوده إلى مصر لتدبير شؤونها ، ففي هذا العام أمر ببناء مدرستين: إحداهما للشَّافعية عند قبر الإمام الشافعي ، عرفت بالمدرسة الصلاحية ، والثانية للحنفية. وتوالى بعد ذلك إنشاء المدارس السنية في أماكن متعدِّدة من القاهرة، وغيرها من البلاد من قبل أمراء الأيوبيين ، وأعوانهم ، ولن نستطيع الحديث عن كل هذه المدارس لكثرتها؛ إذ أصبح إنشاء المدارس سنةً متَّبعةً من قبل أعيان الدولة في هذه الفترة رجالاً ، ونساء ، وإنما سنركز حديثنا حول أشهر المدارس؛ التي كان لها دورٌ في عملية التَّحويل الكبير للبيئة المصرية من المذهب الشِّيعي إلى المذهب السني.
1 ـ المدرسة الصلاحية:
بدأ بناء هذه المدرسة في عام 572هـ/1176م عند ضريح الإمام الشافعي ، وكان وقفاً على الشَّافعية. ويصفها السيوطي بقوله: إنها تاج المدارس. ثم يذكر: أنَّ التدريس بها أسند للعالم الزاهد نجم الدين الخبوشاني ، وقد زار ابن جبير هذه المدرسة في أواخر ذي الحجة من عام 578هـ/1183م ، وكان العمل في توسعتها ما يزال مستمراً ، وذكر ابن جبير: أنَّ هذه المدرسة لم يعمر مثلها في هذه البلاد ، وليس لها نظير في سعة المساحة ، والحفاوة بالبناء ، يخيل لمن يطوف عليها: أنها بلدٌ مستقلٌّ بذاته ، والنفقة عليها لا تحصى. تولى ذلك بنفسه الشيخ الخبوشاني ، وسلطان هذه الجهات صلاح الدين يسمح له بذلك ، ويقول: زد احتفالاً ، وتأنقاً ، وعلينا القيام بمؤونة ذلك. وذكر ابن جبير: أنه حرص على لقاء الخبوشاني ، لأنَّ أمره كان مشهوراً بالأندلس. ولعلَّ في إشارة ابن جبير ما يؤكد: أن صلاح الدين كان يتخيَّر أساتذة مدارسه من أهل العلم ، والفضل ، والصلاح ، ومن بين من ظهرت شهرتهم في العالم الإسلامي؛ حتى تتحقَّق على أيديهم الأهداف؛ التي يسعى إليها ، وحتى يكونوا عنصر جذب لطلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي.
2 ـ مدرسة المشهد الحسيني:
وبنى صلاح الدين مدرسة بالقاهرة بجوار المشهد المنسوب ـ ظلماً وزوراً ـ إلى الحسين ، وجعل عليها وقفاً كبيراً ، كما أشار المقريزي إليها أثناء حديثه عن المشهد الحسيني ، فقال: ولما ملك السلطان الناصر جعل به حلقة تدريس ، وفقهاء ، فوّضها للفقيه: البهاء الدمشقي ، وكان يجلس عند المحراب الذي الضريح خلفه ، فلما وزر معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ (للملك الكامل).. جمع من أوقافه ما بنى به إيوان التدريس الان ، وبيوت الفقهاء العلوية. وإذا كان الهدف الذي ابتغاه صلاح الدين من زرع المدارس السنية في مصر هو التمكين لمذهب السنة ، والقضاء على المذهب الشيعي؛ فإنَّ لإنشاء هذه المدرسة في داخل المشهد الحسيني مغزىً خاصَّاً ، فقد كان من المعاقل الأخيرة التي يلجأ إليها بقايا الشيعة في مصر ، ومن استطاع الفاطميُّون أن يستميلوا عواطفهم من عوام السنة ، ولذا كان من الضروري أن توجد مدرسةٌ في هذا المكان لتعليم الدين الصحيح ، ومحاربة ما نشره الفاطميُّون من بدع.
3 ـ المدرسة الفاضلية:
ومن المدارس الهامة التي أنشئت في هذا العصر المدرسة الفاضلية؛ التي بناها القاضي الفاضل سنة 580هـ/1184م ووقفها على الشَّافعية ، والمالكية ، وخصَّص إحدى قاعاتها لإقراء القران الكريم ، وتعليم علم القراءات على الإمام القاسم أبي محمد الشاطبي (صاحب الشاطبية ت596هـ/1294م) ووقف على هذه المدرسة عدداً كبيراً من الكتب ، قيل: إنها بلغت مئة ألف كتاب ، وجعل إلى جانبها كتَّاباً وقفه على تعليم الأيتام. ووصف المقريزي هذه المدرسة بقوله: وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس القاهرة ، وأجلِّها. كما بنى السلطان العادل (أخو صلاح الدين) مدرسة للمالكية ، وكذلك فعل وزيره صفي الدين عبد الله بن شكر (ت630هـ/1232م) إذ أقام مدرسة للمالكيَّة في موضع دار الوزير الفاطمي يعقوب بن كلِّس ، وكان ابن شاكر عالماً متفقهاً على مذهب الإمام مالك.
4 ـ دار الحديث الكامليَّة:
وكان للملك الكامل بن العادل شغف بسماع الحديث الشريف ، كما كان معظِّماً للسنَّة ، وأهلها ، راغباً في نشرها ، فأنشأ بالقاهرة أول دار لتدريس الحديث ، وهي: المدرسة الكاملية وذلك في عام 622هـ/1225م ، ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي ، ثم من بعدهم على الفقهاء الشَّافعية ، وأسند مشيختها إلى الحافظ عمر بن حسن الأندلسي (المعروف بابن دحية) ت633هـ/1235م وكان بصيراً بالحديث ، معتنياً به ، وتأدَّب الملك الكامل على يديه.
5 ـ المدرسة الصَّالحية:
أما المدرسة التي بناها الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل فقد أقامها مكان قصر الفاطميين الشرقي ، وشرع في إنشائها في عام 639هـ/1241م مستوحياً فكرتها من المدرسة المستنصرية ، حيث وقفها على المذاهب الأربعة ، ورتب فيها دروساً لهذه المذاهب في عام 641هـ/1243م. يقول المقريزي عنه: وهو أول من عمل بديار مصر دروساً أربعة في مكان. وتأتي أهمية هذه المدرسة في أنها أتاحت الفرصة للحنابلة كي يسهموا بجهودهم في حركة الإحياء السني في مصر ، ذلك أنَّهم حتى تاريخ إنشاء هذه المدرسة كانوا الفئة الوحيدة ـ من بين طوائف السنة ـ التي لم يهتمَّ الأيوبيون الأوَّلون بإنشاء مدارس لها ، ولعل السرَّ في عدم الاهتمام بأمرهم: أنهم كانوا قلَّة نادرةً. يؤكد هذا ما يقوله السيوطي عنهم ، وهو بصدد ذكر فقهائهم في مصر: هم بالديار المصرية قليلٌ جداً ، ولم أسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع ، وما بعده. ويوضح السر في هذا بقوله: إن مذهب أحمد لم يبرز خارج العراق إلا في القرن الرابع الذي ملك فيه العبيديُّون مصر ، وأفنوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة: قتلاً ، ونفياً ، وتشريداً ، وأقاموا مذهب الرَّفض والشيعة ، حتى إذا ما سقطت دولتهم؛ تراجع العلماء إليها من سائر المذاهب.
ولم تكن جهود الأيوبيين ـ في إنشاء المدارس ـ مقصورة على القاهرة وحدها ، وإنما امتدَّت إلى مدن أخرى في مصر ، ففي الفيُّوم أنشأ تقي الدين عمر مدرستين: إحداهما للشَّافعية ، والأخرى للمالكية ، وأنشأ صلاح الدين مدرسة للشافعية بمدينة الإسكندرية في عام 577هـ/1181م ، وكانت الأوقاف الكثيرة ، وتيسير سبل المعيشة في هذه المدارس للأساتذة ، والطلاب إحدى الوسائل الهامة التي أسهمت في جذب العلماء ، وطلاب العلم إلى مصر ، وقد كان من المتَّبع عند تأسيس أيِّ مدرسة أن يوقف عليها ما يكفي لاستمرار الحياة العلمية بها. يقول ابن جبير: ومن مفاخر هذا البلد (الإسكندرية) ومفاخره العائدة إلى سلطانه: المدارس ، والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب ، والتعبُّد ، يفدون من الأقطار النائية ، فيلقى كلُّ واحدٍ منهم مسكناً يأوي إليه ، ومدرِّساً يعلِّمه الفن الذي يريد تعلمه ، وأجير يقوم به في جميع أحواله ، واتَّسع اعتناء السلطان بهؤلاء الطارئين؛ حتى أمر بتعيين حمامات يستحمُّون فيها ، ونصب لهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم ، ووكل بهم أطباء يتفقَّدون أحوالهم.
وأشار ابن جبير إلى كثرة مساجد الإسكندرية حتى إنَّ المكان الواحد به أربعة ، أو خمسة مساجد ، وربما كانت المساجد مركَّبةً ، (أي: مكونة من مسجد ، ومدرسة) وكلُّها بأئمَّة مرتبين من قبل السلطان؛ فمنهم من له خمسة دنانير مصرية في الشهر ، ومنهم من له فوق ذلك ، ومنهم من له دونه ، وهذه منقبةٌ كبيرة من مناقب السلطان. وهذه الصورة المشرقة التي رسمها ابن جبير لجهود صلاح الدين في الإسكندرية توحي بعظم جهوده في هذا المجال بالنسبة لبقية البلاد ، ذلك أنَّ الإسكندرية ظلَّت معقلاً لأهل السنة في العصر الفاطمي ، وكان بها في أواخر هذا العهد مدرستان سنيتان: إحداهما للمالكية ، وهي مدرسة الحافظ بن عوف الزهري ، والأخرى للشافعية: وهي مدرسة الحافظ السلفي ، واستطاعت هاتان المدرستان أن تقوما بدور كبير في الحفاظ على التراث السني في مصر الفاطمية، حتى أنَّ القاضي الفاضل قد ذكر هذه الحقيقة في إحدى الرسائل التي بعث بها صلاح الدين إلى نور الدين إثر اكتشافه لأحد دعاة الفاطميين في الإسكندرية ، فيقول: ومما يطرف به المولى: أنَّ ثغر الإسكندرية على عموم مذهب السنة.
فإذا كانت أوقاف صلاح الدين في الإسكندرية هي التي حافظت على سنيتها بهذه الكثافة؛ فلا شك: أنَّها في البلاد الأخرى؛ التي لقيت دعوة الفاطميين فيها رواجاً كانت أكثر ، وأكبر ، يدُّلنا على ذلك ما قرَّره صلاح الدين لنجم الدين الخبوشاني مدرس الصلاحية ، فقد خصَّص له أربعين ديناراً في الشهر عن التدريس ، وعشرة دنانير عن النظر في أوقاف المدرسة ، وستين رطلاً من الخبز في كل يوم ، وراويتين من ماء النيل.
وقد أكمل ابن جبير لنا الصورة حينما تابع رصده لجهود صلاح الدين في القاهرة؛ كي ييسر أسباب العلم للراغبين فيه ، فيقول: ومن العجب: أنَّ القرافة كلَّها مساجد مبنية ، ومشاهد معمورة يأوي إليها الغرباء ، والعلماء ، والصلحاء ، والفقراء ، والإجراء على كلِّ موضع منها متصل من قبل السلطان في كلِّ شهر ، والمدارس التي بمصر، والقاهرة كذلك ، وحقق عندنا أنَّ الإجراء على ذلك كله نيف على ألفي دينار مصرية في الشهر.
ومن هذا يتَّضح: أنَّ صلاح الدين وهو يتابع مسيرة الإحياء السني في مصر لم يكتف بإنشاء المدارس؛ وإنما كان حريصاً أيضاً على جذب علماء السنة إليها من جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ كي يشاركوا بجهودهم في هذا الإحياء الفكري ، بعد أن كرَّس الفاطميُّون جهودهم للقضاء على علماء السنة في مصر. وقد مرَّ بنا قبل قليل ما سجَّله عليهم السيوطي من أنَّهم أفنوا من كان بها من أئمَّة المذاهب الثلاثة؛ قتلاً ، ونفياً ، وتشريداً ، حتى إذا سقطت دولتهم؛ تراجع العلماء من سائر المذاهب السنية إليها ، وكانت جهود صلاح الدين أكبر مشجع لهذه الهجرات التي قام بها العلماء السنيون إلى مصر.
وكما اهتمَّ صلاح الدين بجذب العلماء إلى مصر؛ فإنَّه اهتمَّ كذلك بجذب الصُّوفية ، فأنشأ لهم أول «خانقاه» للصُّوفية في مصر ، وجعلها «برسم الفقراء الصُّوفية الواردين من البلاد الشاسعة» ووقف عليهم أوقافاً جليلة ، وولَّى عليهم شيخاً يدبر أمورهم عرف بشيخ الشيوخ ، ويذكر المقريزي: أن سكَّانها من الصوفية كانوا معروفين بالعلم ، والصلاح ، وأنَّ عدد من كان بها بلغ الثلاثمئة ، وقد رتب لهم السلطان الخبز ، واللحم ، والحلوى في كلِّ يوم ، وأربعين درهماً في العام ثمن كسوة ، وبنى لهم حماماً بجوارهم ، ومن أراد منهم السفر؛ أعطي نفقةً تعينه على بلوغ غايته. وهذه العناية الزائدة بأمور الصوفية كانت تستهدف ـ في ظنِّي ـ غرضاً معيناً يتعلَّق بحركة الإحياء السني ، فعلى الرغم من أن التصوف المعتدل كان اتجاها له احترامه من قبل الحكام ، وعامة الناس في هذا العصر ، إلا أن الاهتمام به على هذا النحو في مصر بالذات كان عملاً مقصوداً ، ويهدف إلى تحقيق غاية معينة ، ولعلَّ السر في هذا هو: أنَّ الفاطميين في مصر قد عجزت أساليبهم المتعدِّدة ـ في الدَّعوة إلى مذهبهم ـ عن أن تتسلَّل إلى عقائد معظم المصريين ، ولكنها بسهولة أثرت في عواطفهم ، فمظاهر الحزن ، والبكاء على الحسين ، والاحتفال بموالد أهل البيت ، واحتفاء الفاطميين بهذه الاحتفالات ، وغيرها ، كلُّ ذلك ترك تأثيره في عواطف المصريين ، وما تزال بقيةٌ من اثاره موجودةً إلى اليوم.
وإذا كان صلاح الدين حاول جذب علماء السنة إلى مصر في كل مكان؛ ليشاركوا بعلومهم ، وفكرهم في حركة الإحياء السني؛ فإن هناك جانباً هاماً كان لا بدَّ من العمل على إشباعه ، وتحويله من الوجهة التي اتَّجه بها الفاطميون إلى وجهة أخرى ، هذا الجانب الهام هو الجانب العاطفي في الناس ، والذي سيطر عليه الفاطميُّون بسهولة ، وكان الصوفية من الفئات القادرة على إشباع هذا الجانب يومها: بأخلاقهم السهلة السمحة ، وزهدهم في متاع الدنيا ، وقدرتهم على مخاطبة عواطف الناس عن طريق مجالس الوعظ ، والذكر ، وغير ذلك ، وفعلاً نجح الصوفية في العصر الأيوبي في لفت أنظار الناس إليهم وإلى رسومهم ، وطقوسهم. فيحكي المقريزي: أنَّ الناس كانوا يأتون من مصر إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خانقاه «سعيد السعداء» وهم متوجِّهون إلى جامع الحاكم لأداء صلاة الجمعة ، حتى تحصل لهم البركة ، والخير بمشاهدتهم.
وقد تمكَّن صلاح الدين ، وخلفاؤه بفضل جهودهم في جذب علماء السنة إلى مصر من أن يخرجوها من عزلتها الفكرية ، وأن يعيدوا صلتها الوثيقة بمراكز الثقافة السنية في العالم الإسلامي: كبغداد، ودمشق، وقرطبة بعد أن قطع الفاطميُّون كلَّ صلةٍ لها بهذه المراكز، وتخلَّف عطاء مصر في مجال الفكر السني ما يزيد عن القرنين ونصف من الزَّمان.
ثانياً: جهود الأيوبيين في الشام والجزيرة:
وهذه العناية الزائدة بحركة البعث السني في مصر لا تعني أنَّ الأيوبيين أهملوا البلاد الأخرى التابعة لهم ، والتي لم تمرَّ بظروف مصر ، بل وجدناهم لا يألون جهداً في نشر الثقافة السنية في كلِّ بلدٍ يحلُّون به سواء في هذا: السلاطين ، والأمراء من الرجال ، والنساء ، والأعوان من الوزراء ، والقواد ، والعلماء ، والكتاب... وحرص كثير من هؤلاء على بناء المدارس ، وتشيدها في بلاد الشام والجزيرة: فصلاح الدين أنشأ مدرسة للشافعية بمدينة القدس ، وبنى مدرسة للمالكية بدمشق ، وجعل داره في دمشق عندما انتقل إلى مصر خانقاه للصُّوفية ، وأنشأ تقي الدين عمر مدرسة بمدينة الرُّها ، وأتم العزيز عثمان بن صلاح الدين مدرسة بدمشق كان أخوه الأفضل قد شرع في عمارتها ، وعرفت بالمدرسة العزيزية ، وشيَّد المعظم عيسى ابن العادل مدرسة للحنفية بدمشق عرفت بالمعظمية ، وأوقف سيف الإسلام أخو صلاح الدين على الحنابلة مدرسة بدمشق ، وأقام الأشرف موسى بن العادل دار الحديث الأشرفية بهذه المدينة ، وأنشأ القاضي الفاضل دار الحديث الفاضلية قرب الجامع الأموي، وبنت ست الشام (أخت صلاح الدين) مدرسة للشافعية بدمشق ، وكذلك فعلت أختها ربيعة خاتون ، فبنت مدرسة وقفتها على الحنابلة بدمشق أيضاً ، إلى غير ذلك من المدارس التي كثرت ، وانتشرت؛ حتى إنَّ عز الدين بن شدَّاد عدَّ منها في دمشق وحدها ثنتين وتسعين مدرسة ، موزَّعة بين المذاهب السنية الأربعة ، وذلك عدا عددٍ من الأماكن الأخرى التي كانت تشغل في التعليم ، والدري: كالجامع الأموي.
وقد نقل ابن جبير ـ أيضاً ـ صورة عن الحياة العلمية في دمشق ، وخاصَّةً داخل مساجدها ، ومشاهدها ، وذلك عندما زار هذه المدينة في عام 580هـ/1184م فيقول عن الجامع الأموي: وفيه حلقات لتدريس الطلبة ، وللمدرسين فيه إجراء واسعٌ ، وللمالكية زاوية للتدريس في الجانب الغربي ، يجتمع فيها طلبة المغاربة ، ولهم إجراء معلوم ، ومرافق هذا الجامع المكرم للغرباء ، وأهل الطلب كثيرةٌ واسعة. ويقول عن المشاهد: ولكلِّ مشهد من هذه المشاهد أوقاف معينة من بساتين ، وأرض؛ حتى إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه ، وكل مسجد يستحدث بناؤه ، أو مدرسة ، أو خانقة (خانقاه) يعيِّن لها السلطان أوقافاً تقوم بها ، وبساكنيها ، والملتزمين لها.. ومن النساء الخواتين ذوات الأقدار مَنْ تأمر ببناء مسجد ، أو رباط ، أو مدرسة ، وتنفق فيها الأموال الواسعة ، وتعيِّن لها من مالها الأوقاف. ومن الأمراء من يفعل مثل ذلك ، لهم في هذه الطريقة المباركة مسارعة مشكورةٌ.
وحظيت حلب هي الأخرى بقسط كبير من جهود الأيوبيين ، وأعوانهم ، فأنشأ بها الظاهر غازي بن صلاح الدين مدرسة مشتركة للشَّافعية ، والحنفية ، وتولي النظر والتدريس بها القاضي بهاء الدين بن شدَّاد الذي وكل إليه الظَّاهر النظرَ في أوقاف حلب كلِّها، وبنى ابن شداد المدرسة الصاحبية للشافعية ، وبجوارها أقام داراً للحديث ، ظلت مجمعاً لأهل الحديث يسكنون بها ، ويقرؤون ، ويسمعون ، ويكتبون حتى محنة التتار ، ووقف عليها قريةً من قرى حلب ، وبالقرب من هذه الدَّار بنى داراً للصُّوفية. وبقيت حلب طيلة عهد الأيوبيين منارةً للعلم ، يقصدها الطلاب من أنحاء شتى بفضل الله ، ثم الجهود العلمية التي نهض بها ابن شدَّاد؛ حيث اعتنى بترتيب أمورها ، وجمع الفقهاء بها ، فعمرت في أيامه المدارس الكثيرة ، وقصدها الفقهاء من البلاد المختلفة ، وكثر الاشتغال بالعلم ، والإفادة منه. ويذكر ابن خلكان: أنه التحق بالمدرسة التي أنشأها ابن شدَّاد هو ، وأخوه. وكان ابن شدَّاد يدرِّس فيها بنفسه ، ويرتِّب معه أربعة من الفقهاء الفضلاء للإعادة ، كما يشير ابن خلكان إلى أنَّ العلماء بحلب في أيام ابن شدَّاد كانت لهم حرمة تامة ، ورعاية كبيرة ، وخصوصاً جماعة مدرسته ، فإنهم كانوا يحضرون مجالس السُّلطان ، ويفطرون في رمضان على سماطه ، وكان للقاضي عقب صلاة الجمعة درسٌ في الحديث يسمعه المصلُّون. ويذكر ابن واصل: أنه توجَّه إلى حلب في أواخر عام 627هـ/1230م لِيَدْرس الفقه ، والأصول ، والنحو ، واللغة ، ويتبرك بلقاء ابن شدَّاد ، وكان نزوله بالمدرسة الصَّاحبية.
يمكنكم تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/66.pdf