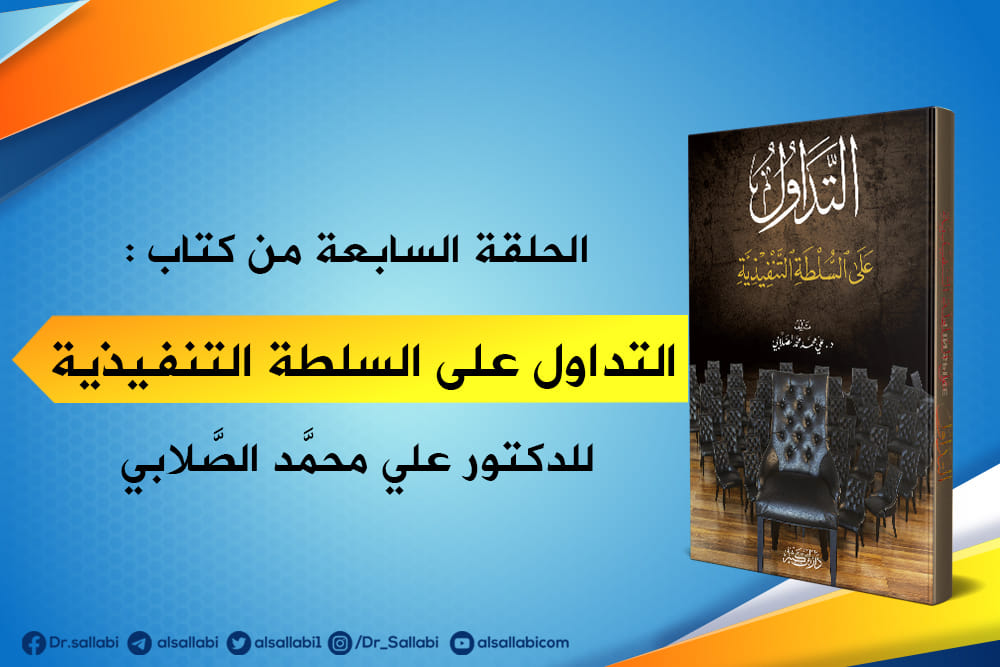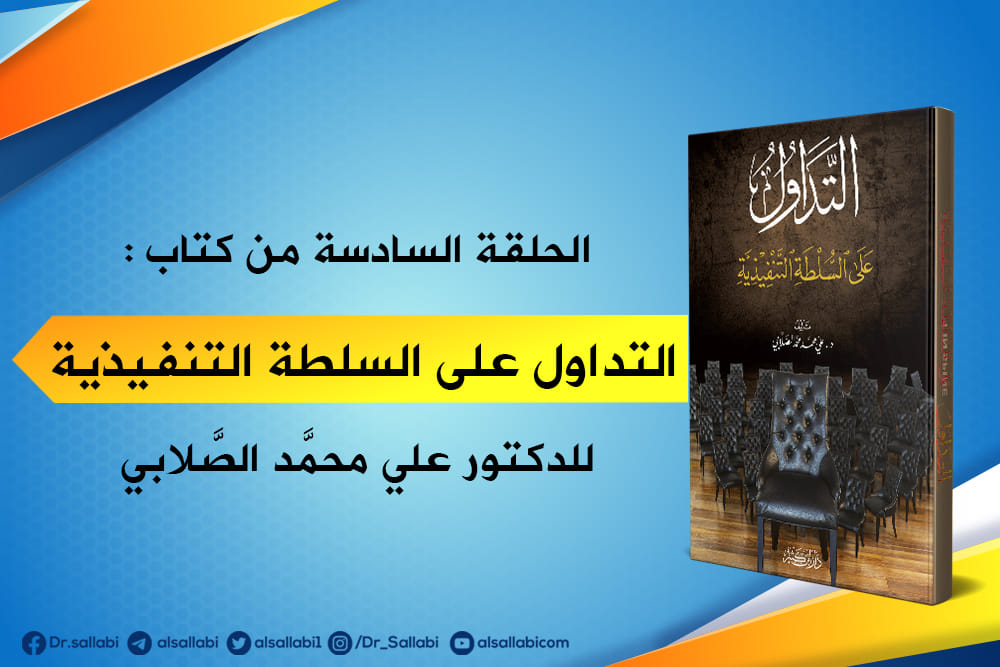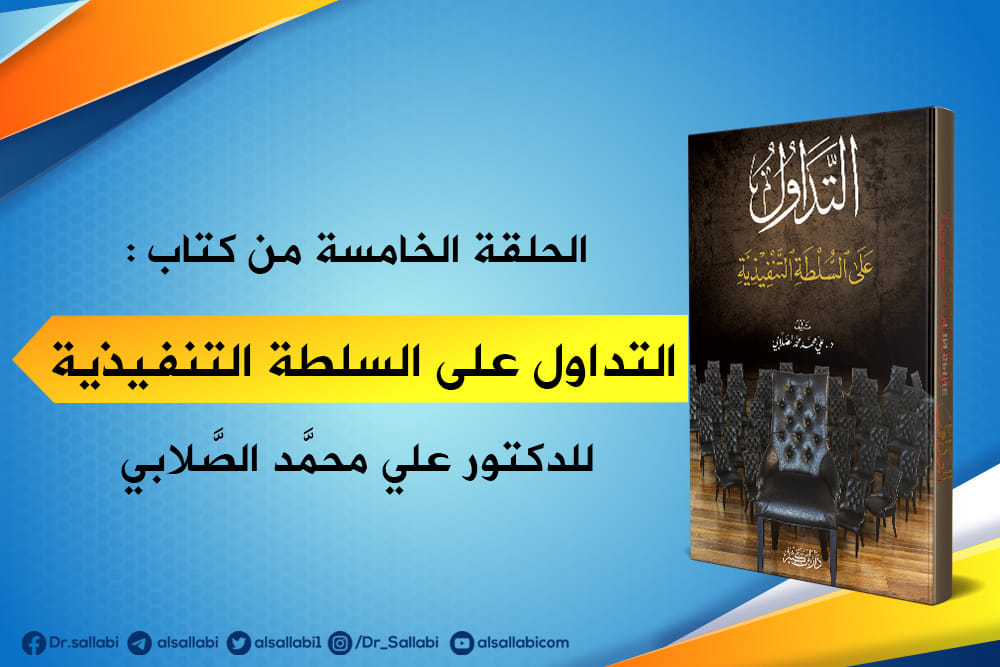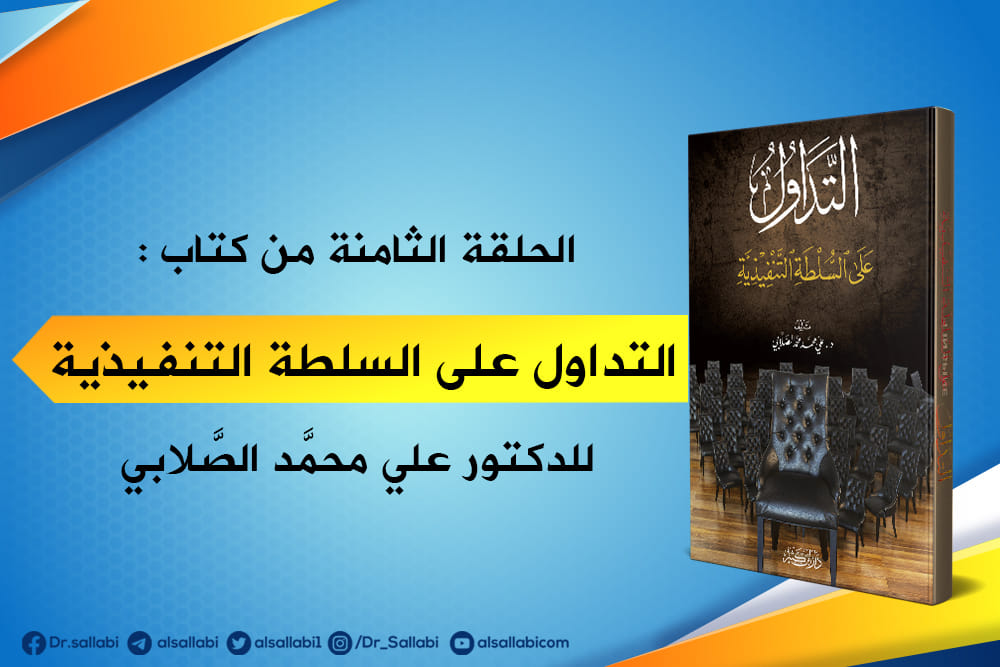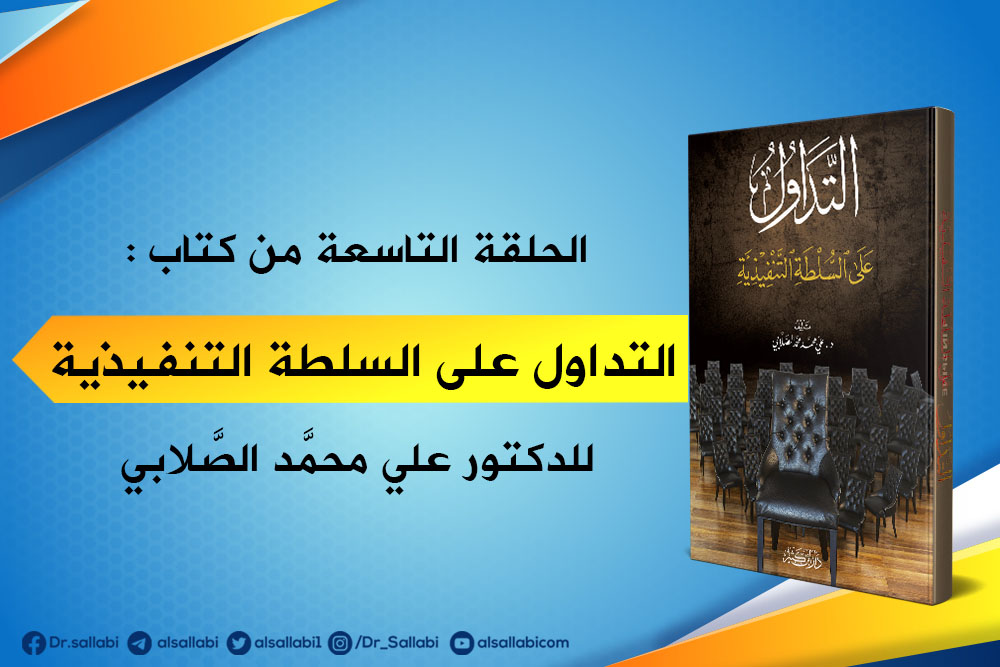(ألقاب من يتولى السلطة التنفيذية العليا)
الحلقة: 7
بقلم: د. علي محمد الصلابي
ربيع الآخر 1443 ه/ نوفمبر 2021
1ـ أمير المؤمنين:
هو اللقب الثاني الذي أطلق على من تولى السلطة التنفيذية العليا في الترتيب الزمني من حيث خلع الألقاب على ولاة أمور المسلمين، وأول من لقب به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسمى بخليفة رسول الله؛ لأنه تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الأمر دعوه خليفةَ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الصحابة استثقلوا هذا اللقب لكثرته وطول إضافته، وأنه يتزايد فيما بعد دائماً، فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسبه، ويدعون به مثله، ثم أطلق عليه لقب أمير المؤمنين، وفي رواية: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراق: أن أبعث إلي برجلين جَلْدين نبيلين، أسألهما عن العراق وأهله، فبعث إليه صاحب العراق بليد بن ربيعة، وعدي بن حاتم، فقدما المدينة، فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخلا المسجد فوجدا عمرو بن العاص، فقالا له: يا عمرو، استأذن لنا على أمير المؤمنين، فدخل عمرو فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا بن العاص؟ لتخرجن مما قلت، قال: نعم، قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين، فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه، إنه أمير ونحن المؤمنون، فجرى الكتاب من ذلك اليوم.
وفي رواية: أن عمر رضي الله عنه قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فهو سمى نفسه.
وبذلك يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي بأمير المؤمنين، وأنه لم يسبق إليه.
وإذا نظر الباحث في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن جميعهم قد اتفقوا على تسميته بهذا الاسم، وسار له في جميع الأقطار في حال ولايته.
وإذا كان لقب الخليفة يبرز الطابع الديني والاتصال القوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لقب أمير المؤمنين أقرب لإظهار المعنى الدنيوي؛ لأنه يعني أن المؤمنين قد أصبحوا قوة، وأن رئيس الدولة قد صار المتصرف في شأن هذه القوة، كما أن لقب أمير المؤمنين يشعر بأن اختيار الحاكم، أو الرئيس، أو الخليفة، متروك للمؤمنين، وهم أصحاب الحق في اختيار أميرهم.
2 ـ الإمام:
الإمام هو اللقب الثالث من ألقاب من يتولى السلطة التنفيذية العليا، وقد ورد لفظ «الإمام» في القرآن الكريم بمعنى «القدوة» في قوله تعالى: َ {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ *} [البقرة:124] .
قال القرطبي:«الإمام»: القدوة، ومنه قيل لخيط البناء: إمام، وللطريق: إمام؛ لأنه يؤم فيه للمسالك، أي: يقصد.
وفي التنزيل: َ {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا *}[الفرقان: 74]، قال القرطبي: أي: قدوة يقتدى بنا في الخير.
وأخذ من هذا المعنى الإمام في الصلاة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به».
وتسمية الخليفة بالإمام يشعر بالصبغة الدينية التي يتصف بها الخليفة، والتي تجعله صالحاً لأن يقتدي به الناس في أمورهم، والعنصر الديني يعد من أبرز ألوان الإمامة، وإن كانت الإمامة في حقيقتها تشتمل على المعنى الديني والدنيوي.
وورد لفظ «الإمام» بمعنى من يتولى أمر المسلمين في أحاديث عدة، منها:
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه».
قال الحافظ في تفسير «الإمام العادل»: والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين فعدل به.
وينبغي أن يعلم أن الخلافة والإمامة وإمارة المؤمنين والملك لا يقصد منها في نصوص القرآن إلا الرئاسة بمعناها العام، ولا يقصد منها الدلالة على نظام معين من أنظمة الحكم، ذلك أن داود عليه السلام سمي في القرآن خليفة، وسمي ملكاً.
قال تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ}[ص: 26] .
وقال تعالى: {وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ}[البقرة :251] .
كما أن إبراهيم سمي في موضع إماماً، ووعد أن يكون المهتدون من ذريته أئمة.
قال تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ *}[البقرة: 124] .
بينما وصف ذريته في موضع اخر بوصف الملوك.
قال تعالى: {فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا *}[النساء: 54].
ووعد بني إسرائيل أن يكونوا أئمة بعد استضعافهم، واستبعاد فرعون لهم.
قال تعالى: {وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ *} [القصص: 5] .
فلما تخلصوا من ظلم فرعون، وكونوا لأنفسهم دولة مستقلة، أخذ موسى يذكرهم بنعمة الله عليهم، ويقول لهم: {اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا}[المائدة :20] .
فالخلافة والملك والإمامة مترادفات تدل على الرئاسة العليا للدولة، ولا تدل على أكثر من ذلك.
3 ـ السلطان:
السلطان في لغة العرب قد يستعمل في القدرة، ومنه قوله تعالى: {لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ *} [الرحمن: 33].
وقد يستعمل بمعنى الحجة، ومنه قوله تعالى: {فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ *}[إبراهيم: 10] .
فسـمي السـلطان سلطاناً إمـا لقدرته، وإمـا لكونه حجـة على وجـود الله وتوحيـده؛ لأنه لا يستقيم أمر العالم وما فيه من الحكم بغيـر مدبـر حكيم، ولا يستقيم أن يكون للوجود إلهان، قال تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] .
وقد عرف بعضهم السلطان بقوله: السلطان: الوالي الذي لا والي فوقه.
وذلك يدل على أن السلطان هو الذي يتولى أعلى سلطة في الدولة؛ ولذا كان يسمى بالسلطان الأعظم، وقد لقبه بذلك المتأخرون لأنه صاحب السلطة العليا في الأمة، وعرفه بعضهم بقوله: السلطان: هو الملك ومن له القدرة والسلطة على الملك، فجعل السلطان والملك بمعنى واحد.
وقال ابن خلدون:«فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية، القائم في أمورهم عليهم».
وقد ورد إطلاق لفظ «السلطان» على من يتولى أمر المسلمين في أحاديث عدة:
منها: ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة الجاهلية» ، قال الحافظ ابن حجر: قوله: فإن من خرج من السلطان، أي: من طاعة السلطان.
وقال: المراد «الميتة الجاهلية»: وهي بكسر الميم حالة الموت، كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً.
وظهر بشكل لافت إطلاق لفظ السلطان على الحاكم أو رئيس الدولة في عهد الأيوبيين والمماليك، ثم دولة بني عثمان.
وكان هذا اللقب معروفاً لدى الفقهاء والعلماء القدامى ؛ إذ نجد أن كلاً من الماوردي وأبي يعلى الفراء سمى كتابه في السياسة الشرعية بالأحكام السلطانية، وسمى ابن دقماق كتابه في التاريخ: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين.
4 ـ الملك:
ويطلق اسم الملك على من يتولى السلطنة، وهو أحد الأسماء التي أطلقت على المتولي لأمر المسلمين.
وعرف بعضهم الملك بقوله: صاحب الأمر والسلطة، على أمة أو قبيلة أو بلاد، وقال بعضهم: الملِك: ـ بكسر اللام ـ من تولى السلطنة بالاستعلاء على أمة، أو قبيلة، أو بلاد.
قال الراغب: هو التصرف بالأمر والنهي في الجمهور، وذلك يختص بسياسة الناطقين.
وقال بعضهم: الملك: الرئيس الأعلى في الدولة، وهو يقابل الخليفة أو أمير المؤمنين في عصر الخلفاء الراشدين، ويظهر من الأقوال التي عرفت الملك أنه الذي يتولى السلطنة على قبيلة أو بلاد أو أمة.
وأن الملك بتوليته هذا المنصب يتصف بالاستعلاء على رعيته، وأن الرعية تتصف بالخضوع للملك.
وأن هذا الاستعلاء والتملك لا يكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية، كما يرى ابن خلدون.
وأن لفظ «الملك» يقوم مقام «الخليفة» أو أمير المؤمنين.
وكان إطلاق لقب «الملك» على من يتولى أمور المسلمين قد ظهر بعد «الخليفة» وأمير المؤمنين في الترتيب، ولم تذكر هذه التعريفات كيفية تنصيب الملك إلا عن طريق الاستعلاء أو التسلط، غير أنه من المعروف أن الملك إنما يتولى السلطة إما عن طريق الاستيلاء عليها، وإما عن طريق الإرث، وإما عن طريق العهد إليه، بالولاية ممن سبقه.
وبذا يمكن تعريف الملك بأنه: من يتولى الحكم في قوله تعالى: َ {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا *} [الكهف:79].
وكذلك ورد لفظ «ملك» في أحاديث متعددة:
منها: ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر».
ومنها: ما رواه ابن ماجه عن أبي مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، فجعل تُرعد فرائصه، فقال: «هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد».
ويجدر بالذكر أن الألقاب التي مر ذكرها، والتي تسمى بها ولاة المسلمين من «خليفة أو أمير المؤمنين أو الإمام أو السلطان» أطلقت عليهم في الفترة التي بدأت بالخلافة الراشدة وحتى سقوط الخلافة العثمانية.
أما لقب «الرئيس» فإنه لقب محدث لم يظهر في البلاد الإسلامية إلا بعد إلغاء الخلافة، وتقطيع الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة.
يمكنكم تحميل كتاب التداول على السلطة التنفيذية من الموقع الرسمي للدكتور علي محمد الصلابي