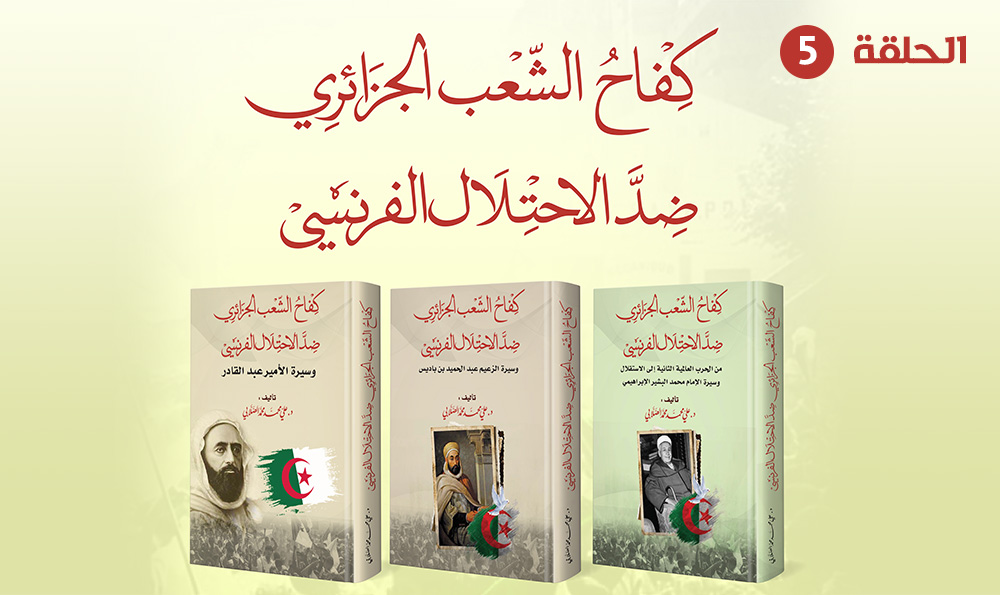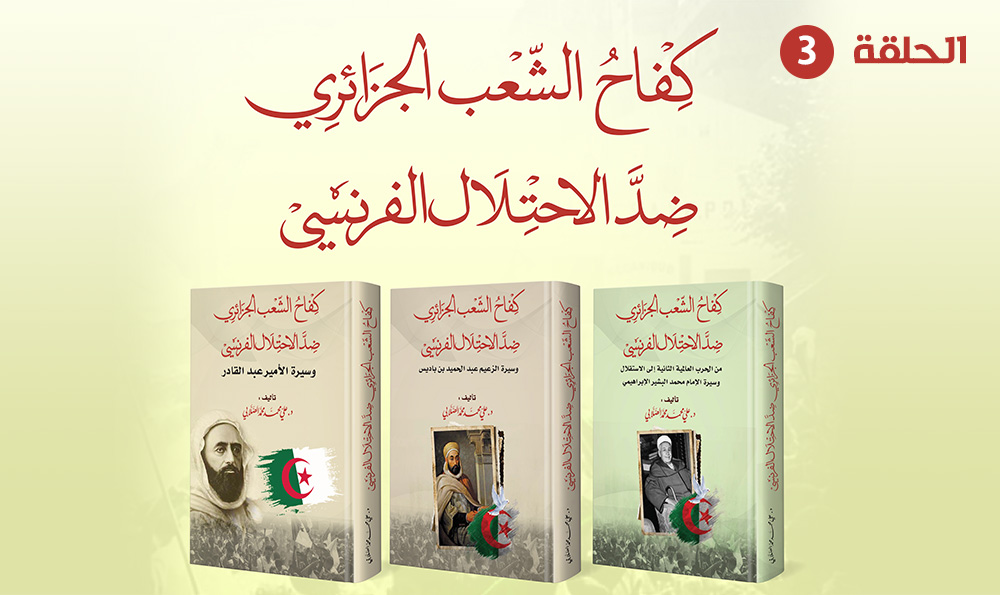من كتاب كفاح الشعب الجزائري بعنوان:
(الدولة الحفصية في تونس وليبيا)
الحلقة: الخامسة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ سبتمبر 2020
• النشأة:
اختلف علماء التاريخ في نسب أمراء بني حفص، فمنهم من أرجعهم إلى عمر بن الخطاب، كابن نخيل الذي يعتبر أول كاتب لديوان الدولة الحفصية، ومنهم من أرجعهم إلى قبيلة هنتاتة، التي تعتبر من أهم قبىء ل المصامدة على وجه الخصوص، ومن أكبر قبىء ل البربر في المغرب على وجه العموم.
وموطنها بجبال دون القريبة من مراكش. ويعتبر أبو حفص من زعماء المصامدة وله مكانة ونفوذ بين قبىء ل المصامدة، وهو من خواص ابن تومرت، وامن بدعوته، وبذل قصارى جهده في مناصرته، وكان يأتي بعد عبد المؤمن في المنزلة عند الموحدين من غير منازع، ويشترك معه في الألقاب الرئاسية، فبينما كان ابن تومرت يسمى بالإمام، وعبد المؤمن بن علي بالخليفة ؛ كان يسمى هو بالشيخ. وبلغ من احترام عبد المؤمن له وحسن تقديره إياه أن كان يأخذ برأيه في كل مشاكل الحكم، وأكرم أولاده من بعده، وأسند لهم المناصب والإمارة في الأندلس وإفريقية.
وعندما تولى الخلافة الموحدية الناصر بن المنصور أسند إلى أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهناتي أمر إفريقية، وأعطاه مطلق التصرف في إدارتها ؛ كي يستطيع القيام بأعبىء ها ويقضي على الفتن والثورات المستمرة هناك بزعامة بني غانية وأحلافهم من العرب، وكان من شروط أبي محمد الحفصي على الخليفة الموحدي أن يقيم ثلاث سنين، ريثما تترتب الأحوال وتنقطع أطماع بني غانية عنها، وأن يحكمه الناصر فيمن يبقيه معه من الجند ويرضاه من أهل الكفاية، وأن لا يتعقب أمره في ولاية ولا عزل، فقبل الناصر شروطه، ومن هنا ورث الملوك الحفصيون سلطنة تونس وإفريقية، ويعتبر الانفصال الرسمي عن الدولة الموحدية بالنسبة للحفصيين على يد أبي زكريا عبد الواحد الحفصي سنة (626هـ/1229م).
وكانت هناك عدة أسباب شجعت الأمير أبا زكريا بن عبد الواحد الحفصي على الانفصال منها:
ـ انهيار دولة عبد المؤمن في المغرب والأندلس عقب الهزيمة التي حاقت بجيوشها في موقعة العقاب سنة (1212م).
ـ رفض الخليفة الموحدي إدريس المأمون في عام (626هـ/1229م) لتعاليم ابن تومرت ثم أزال اسمه من السكة والخطبة.
ـ قتل الخليفة الموحدي إدريس أشياخ الموحدين الذين عارضوا سياسته ومعظمهم من هنتاتة، قبيلة الحفصيين.
فاستغل أبو زكريا عبد الواحد الموقف المتأزم ورفض مبايعة الخليفة إدريس المأمون، واتخذ الأسباب المذكورة ذريعة للخروج عن طاعة عبد المؤمن، والاستقلال بولايته، واعتبر نفسه أحق بميراث فكر وعقىء د وأهداف حركة ابن تومرت، ولذلك حرص الحفصيون منذ إعلانهم للانفصال عن التمسك بتعاليم ابن تومرت، وذكروا اسمه في الخطبة والسكة، كما طبقوا رسوم الموحدين واسمهم وتقاليدهم على دولتهم الناشئة، وإن كانت الظروف اقتضت تعديل بعض القضايا بحكم تغير الزمان والمكان.
واستطاع أبو زكريا بن عبد الواحد أن يشكل إمارة في تونس، وقضى على البقية من بني غانية، واستولى على قسنطينة وبجاية، ودخل تلمسان وأتته بيعة أهل طنجة وسبتة وسلجماسة، كما أتته بيعة بني مرين عندما كانوا يقاتلون الموحدين في المغرب الأقصى وكانت مناورة سياسية، دلت على دهاء ومكر زعماء المرينيين.
ودعا له عدد من ولاة الأندلس وبايعه أهل شرق الأندلس، وإشبيلية والمرية، وإلى الأمير أبي زكريا عبد الواحد، وجّه أمير بلنسية وفداً برئاسة ابن الأبار يستصرخه لنجدة أهل بلنسية فقام ابن الأبار القضاعي بين يدي أمير الحفصيين منشداً قصيدته السينية الفريدة التي قال عنها المقري أنها فضحت من باراها وكبا دونها من جارها، وهي:
أدرك بخيلك خيل الله أندلساً إن السبيل إلى منجاتها درسا
وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم يزل منك عز النصر مُلتمسا
وحاش مما تعانيه حُشاشتها فطالما ذاقت البلوى صباح مسا
ياللجزيرة أصبح أهلها جزرا للحادثات وأمسى جدها تعسا
في كل شارقة إلمام بىء قة يعود مأتمها عند العدا عرسا
وكل غاربة إجحاف نىء بة تثني الأمان حذراً والسرور أسى
تقاسم الروم ولا نالت مقاسمهم إلا عقىء لها المحجوبة الأنسا
وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا
مدىء ن حلها الإشراك مبتسما جذلان وارتحل الإيمان مبتسما
وصيرتها العوادي العىء ثات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا
فمن دساكر كانت دونها حرسا ومن كنىء س كانت قبلها كنسا
يا للمساجد عادت للعدى بيعا وللنداء غدا أثناءها جرسا
لهفي عليها إلى استرجاع فىء تها مدارس للمثاني أصبحت دُرُسا
وأربُعاً نمنمت أيدي الربيع لها ما شئت من خلع مَوْشيةٍ وكُسا
كانت حدىء ق للأحداق مونقة فصوّح النصر من أدواحها وعسى
وحال ما حولها من منظر عجب يستجلس الركب أو يستركب الجلسا
سرعان ما عاش جيش الكفر واحربا غيث الدبا في مغانيها التي كسبا
وابتز بزتها مما تحيفها تحيف الأسد الضاري لما افترسا
فأين عيش جنيناه بها خضراً وأين عصر جليناه بها سلسا
محا محاسنها طاغ أتيح لها ما نام عن هضمها حيناً ولا نعسا
ورج أرجاءها لما أحاط بها فغادر الشم من أعلامها خُنسا
خلا له الجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا
وأكثر الزعم بالتثليث منفرداً ولو رأى راية التوحيد ما نبسا
صل حبالها أيها المولى الرحيم فما أبقى المراش لها حبلاً ولا مرسا
إلى أن قال:
طهر بلادك منهم إنهم نجس ولا طهارة ما لم تغسل النجسا
وأوطىء الفيلق الجرار أرضهم حتى يطأطىء رأسا كل من رأسا
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت عيونهم أدمُعاً تهمي زكاً وخسا
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت داءً ما لم تباشر حسمه انتكسا
فاملأ هنيئاً لك التأييد ساحتها جرداً سلاهب أو خطيّة دعسا
واضرب لها موعداً بالفتح ترقبه لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى
ولقد لبى السلطان الحفصي النداء، وأرسل السفن المحملة بالعدة والعتاد والرجال والمؤن إلى المدينة المحاصرة، إلا أن تلك الإغاثة لم تفد أهل بلنسية، بسبب الحصار المحكم من قبل النصارى، مما جعل أهالي المدينة يضطرون إلى التسليم والخضوع للمعتدين النصارى الحاقدين.
وفتح أبو زكريا أبواب إفريقية للهجرة الأندلسية، وبلغ التأثير الأندلسي في الدولة الحفصية ذروته في عهد أبي عبد الله المستنصر خليفة أبي زكريا يحيى، وكان أعظم حكام دولة الحفصيين، وكان بلاطه يزخر بأهل الأندلس، الذين هاجروا إلى جواره.
لقد حققت مناورة أبي زكريا عبد الواحد السياسية أهدافها، حيث استطاع أن يمكن لبني حفص الحكم في إفريقية، وتوسع نفوذه من أحواز طرابلس شرقاً إلى مدينة الجزائر غرباً، وبدا كأنه سيعيد الوحدة إلى أقطار المغرب.
• ولاية العهد:
سلك الحفصيون في ولاية العهد مسلك تعيين الأفراد من الأسرة الحاكمة. وفي عام (633هـ/1235م) عين الأمير أبو زكريا ابنه على ولاية بجاية، وحول له معظم الصلاحيات في سىء ر أعمالها.
وتميز أبو يحيى بحسن الكفاءة وسعة العلم وكثرة الورع وحب العدل، وجعل أهل مشورته وخاصته من أهل العلم والتقوى والدين والرأي السديد.
وكانت وصية أبي زكريا لابنه مليئة بالنصح والإرشاد. ومما جعل في وصيته قبل موته في عام (647هـ/1249م).
ـ المحافظة على إقامة شعىء ر الإسلام في اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه.تفقد الجيش وحسن معاملته لأفراده حسب درجاتهم، فلا يلحق السفيه بالكبير، فيجرىء السفيه عليه، ويفسد نية الكبير، فيكون إحسانه مفسدة له في كلا الوجهين.
ـ أوصاه الأمير بعدم الجزع عند حدوث الملمات، لأن الجزع يؤدي إلى القلق والاضطراب، وبالتالي إلى الفشل في معالجة الأمور، لذا عليه أن يعالجها بالصبر والاتزان مع استشارة النبهاء، وذوي التجارب من قادة الجيش.
ـ أن يحسن اختيار مستشاريه، ممن اتصفوا بصدق القول والإخلاص في العمل، وأن لا يقتصر في استشارتهم على أحد منهم دون الاخر، بل يأخذ بارىء هم جميعاً، فإنَّ تعدد الاراء هداية لمعرفة الصواب.
ـ عليه أن يتفقد أحوال رعيته، ويراقب العمال والولاة في أعمالهم، ويبحث عن سيرة القضاة وعن أحكامهم، ومهما دعي للكشف عن ملمة فليكشفها، ولا يراع من حكمه أحداً إذا زاغ عن الصواب، ولا يقتصر على شخص واحد فقط في رفع مسىء ل وحوىء ج المتظلمين من أبناء رعيته.
ـ أوصاه بالتواضع والصفح عن الهفوات، لأنهما أنجح الطرق في معالجة الأمور.
ـ أن يعاقب بشدة كل مفسد عابث في طرقات المسلمين، وأموالهم، متمادٍ في غيه في فساد صلاحهم وأحوالهم، ومثل هذا ليس له إلا السيف.
ـ أما الحسود فعليه أن لا يقيل عثرته، لأن في إقالته ما يشجعه على القول، والقول يدفعه إلى العمل، ووبال عمله يضر غيره، فليحسم داءه قبل انتشاره ويتدارك أمره قبل إظهاره.
ـ عليه أن يزهد في الدنيا، فلا ينشغل بلهوها وزينتها بل يعمل الأعمال الحميدة المشكورة التي تخلد ذكراه في الدنيا وينال بها مرضاة الله في الآخرة.
وبعد موت أبي زكريا ؛ تولى زعامة الحفصيين ابنه أبو عبد الله محمد، الذي تسمى بالمستنصر بالله، الذي أعلن نفسه أمير المؤمنين بعد سقوط بغداد بيد التتار عام (656هـ). وكان إعلانه كأمير المؤمنين للمسلمين (657هـ/ 1259م)، وبايعه شريف مكة بالخلافة.
وحاول الحفصيون أن يستندوا إلى الأسس الشرعية اللازمة في باب الخلافة كالأصل العربي، والنسب النبوي، إلى جانب قرابتهم للموحدين، فزعموا أنهم من سلالة عمر بن الخطاب، وعمر كما تعلم من أشراف قريش وكانت إليه السفارة في الجاهلية، وقد تزوج النبي (ص) ابنته حفصة ؛ فالحفصيون بحكم هذا الأصل القرشي، وهذا النسب النبوي، وبحكم قرابتهم للموحدين، وجدوا في أنفسهم الشرعية الكافية لأن يرثوا خلافة الموحدين المنهارة، وحرص الحفصيون على الاعتزاز بهذا الأصل، وإعلانه في كل حفل ومناسبة، وتبارت أقلام كتابهم وقصىء د شعرىء هم بإطلاق اسم الدولة العمرية أو الفاروقية على الدولة الحفصية، وذكر نسبهم الذي يرجع إلى عمر الفاروق كما يقولون، فهذا ابن خلدون يمدحهم يقول:
قوم أبو حفص أب لهم وما أدراك والفاروق هو أول
ودعم موقفَ الحفصيين في إعلان الخلافة سقوطُ بغداد بيد المغول، واعتراف شريف مكة وأهل الحجاز بالخلافة الحفصية، وسارع ملك غرناطة ابن الأحمر بمبايعة الحفصيين، وكذلك المرينيين في المغرب الأقصى. يقول السلاوي الناصري: ولما بلغ بنو مرين بالمغرب وغلبوا على الكثير من ضواحيه، كانوا يدعون إلى أبي زكريا الحفصي تأليفاً لأهل المغرب، واستجلاباً لمرضاتهم وإتياناً لهم من ناحية أهوىء هم، إذ كانت صبغة الدعوة الموحدية قد رسخت في قلوبهم،واعترف بنو زيان في تلمسان في المغرب الأوسط بهذه الخلافة وبذلك ظهرت خلافة قوية في الشمال الإفريقي عاصمتها تونس، وبسطت نفوذها في بلاد الأندلس والمغرب والحجاز، وشعر حكام مصر بخطورة أهداف الخلافة الحفصية، وكانت السياسة المغربية في عهد المماليك تهدف إلى مد سلطانها على الحجاز لأسباب دينية واقتصادية وسياسية.
ومن أهم تلك الأهداف: السيطرة على البحر الأحمر وتجارته، فجميع الحكام الذين حكموا مصر واستقلوا بها كالطولونيين والإخشيديين والفاطميين «العبيديين» ؛ قد حرصوا على مد سلطانهم على الحجاز، ثم جاء الأيوبيون والمماليك والعثمانيون، فساروا على نفس هذه السياسة لدرجة أنهم لقبوا أنفسهم بلقب «خادم الحرمين».
وكان يحكم مصر في تلك الفترة (658 ـ 676هـ) السلطان الظاهر بيبرس، وكان من أقوى السلاطين الذين حكموا مصر، واستطاع أن يهزم المغول عند الحدود العراقية، والصليبين في الشام ؛ حتى صارت سيرته مضرباً للأمثال، ورأى السلطان بيبرس أن سياسة الدولة الحفصية تتعارض مع أهداف دولته، لهذا عمد إلى إحياء الخلافة العباسية في القاهرة سنة (659هـ/1261م)، فأتى بأمير من أمراء العباسيين الفارين من المغول، وبايعه بالخلافة في احتفال كبير في القاهرة، ولقبه بالمستنصر بالله، وقام الخليفة الجديد وقلد السلطان بيبرس حكم مصر والشام والحجاز، وما يغزوه من بلاد الأعداء. وبهذا العمل كسب بيبرس نفوذاً أدبياً وروحياً وسياسياً ووجه ضربة موجعة للدولة الحفصية.
وشرع بيبرس بعدة إصلاحات في الحرم النبوي الشريف، وأرسل كسوة الكعبة، وأرسل الصدقات والشموع والزيت والطيب...إلخ ثم أدى بيبرس فريضة الحج، وظهر منه خشوع وكرم متميز وأزال أنصار الحفصيين، وأمر بالدعاء للخليفة العباسي على منابر الحجاز بدلاً من الخليفة الحفصي، ووضع مندوباً تابعاً له بجانب شريف مكة، إلا أنه بعد مضي وقت قصير، ضعف نفوذ كل من الخلافتين وصار سلطانها في المنطقة التي تعيش فيها.
واستطاع المستنصر بالله أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا الحفصي أن يطور الدولة ويجعلها مقصداً للعلماء والأدباء، وأن تتخذ مكانة رفيعة على المستوى الدولي في زمانه، وجاءته سفارات من دول متعددة بعضها من السودان، وبعض آخر من أوروبا، واهتم بعاصمة الدولة وتطور العمران وازدهرت الأحوال العامة في أيامه، وأصبحت أعز أيام الدولة الحفصية.
وتعرضت الدولة الحفصية لهجمات نصرانية همجية يقودها لويس التاسع ملك فرنسا في سنة (668هـ/1270م) أي بعد عشرين سنة من غزوته الخىء بة لمصر، إلا أنها أخفقت بسبب الوباء الذي عصف بها وعصف بحياة الملك نفسه.
مات المستنصر الموحدي عام (675هـ/1277م) وبعد انقضاء القرن السابع الهجري، ضعف أمرها، وتوقف الدعاء لها في المغرب والأندلس، ثم لم تلبث أن نخرتها وأضعفتها الحروب الأهلية، واستقلت بجاية عن تونس، وانتهز بنو مرين هذه الفرصة، وأخذوا يتدخلون في شؤون الدولة الحفصية واستولوا على تونس عدة مرات.
وأصبح الشمال الإفريقي في دوامة الصراع، واستطاع الحفصيون أن يعودوا إلى حكم إفريقيا لدى انسحاب المرينيين وبزغت مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي في ولاية أبي العباس أحمد المعروف بالمستنصر (722هـ/1370م ـ 796هـ/1394م) واستطاع أن يقف في وجه هجوم من النصارى على المهدية سنة (792هـ/1390م) فهزموهم واستعادت الدولة الحفصية شيئاً من هيبتها، وتمكن ابنه أبو فارس من الاستيلاء على تلمسان، وضم بعض الإمارات التي استقلت في حياة أبيه (803هـ / 1400م) ، وعلى بسكرة سنة
(805هـ/1402م)، ثم نجح في الاستيلاء على مدينة الجزائر سنة (813هـ/1410م)، وفي عهد أبي فارس قدمت السفارات إلى تونس من جميع الأنحاء تخطب مودته، وتطلب مصالحته خاصة، ومنها سفارة من غرناطة وفاس ومصر، وتوفي أبو فارس سنة (838هـ/1434م)، وخلفه ابنه الأصغر المستنصر فحكم (14) شهراً ومات، وفي عهد أخيه أبي عمر وعثمان اشتعلت نار الفتنة بسبب أطماع أبناء عمومته بالسلطان، إلا أن أبا عمر استطاع أن يقضي على هذه الثورات سنة (850هـ/1446م) ويهزم عمه أبا الحسن.
وتقدمت تونس في مجال الحضارة في عهده، وشكلت علاقات ومعاهدات تجارية مع فرنسا وسلاطين مصر والأندلس. ثم تمزقت وحدة الحفصيين بعد وفاته، وهاجم الإسبان سواحل تونس، وتبدلت الحال حتى أصبحت حال الحفصيين يرثى لها، وعبَّر أبو محمد الحفصي عن الحال التي وصلت إليها في بيت شعر قال فيه:
وكنا أسوداً والرجال تهابنا فجاء زمان فيه نخشى الأرانب
وكان هذا الأمير قد تحالف مع الإسبان وثار عليه ابنه، فقبض عليه، وسمل عينه وخلعه من منصبه، ثم قام الإسبان بمذبحة في تونس سنة (941هـ/1534م) فكانت نهاية الحفصيين، وبدأ الصراع عليها من العثمانيين والإسبان، واستطاع العثمانيون أن يتغلبوا على الإسبان ولذلك دخلت تونس في حكم الدولة العثمانية الإسلامية عام (976هـ/1568م).
وذكر الدكتور عبادة كحيلة أن الأمر خلص للعثمانيين عام (981هـ/1573م).
• طرابلس والدولة الحفصية:
ـ اتخذ بنو حفص تونس مركزاً لسلطانهم، وأرسلوا الأمراء على طرابلس، ومن أمرىء هم على طرابلس أبو عبد الرحمن يعقوب الهرغي، وعبد الله بن إبراهيم بن جامع، ومحمد بن عيسى الهنتاتي، ويوسف بن طاهر اليربوعي، وقد حاول الأول الاستقلال بطرابلس، ولكنه لم ينجح وثار أعيان طرابلس ضده، فقبضوا عليه وقتلوه، ولم تظهر حركات انفصالية في عهد الوالي الثاني، أما الوالي الثالث فقد انفصل بطرابلس عن أمراء بني حفص في أثناء إمارة أبي عبد الله محمد (647 ـ 665م) فعاد يعلن ولاءه إليه وتبعيته لإمارته، وجاء يوسف بن طاهر اليربوعي فأعلن استقلاله التام عن الحفصيين واستبد بالأمر، لقد كانت حركة انفصال المدن عن الدولة الحفصية كثيرة، وكانت الثورات متصلة من أمير ضد أمير، وكان ذلك مما سبب الضعف والوهن للأسرة الحفصية الحاكمة. وفي مطلع القرن الثامن الهجري كان الاضطراب قد بلغ أشده، وكان زكريا بن أحمد اللحياني أحد أمراء بني حفص قد عاد حديثاً من الحج إلى طرابلس، فاجتمع حوله الناس واختاروه أميراً لهم سنة (711هـ). ورأى اضطراب الأحوال بتونس فعقد العزم على غزوها، واحتل تونس ثم سار شرقاً حتى وصل إلى برقة ثم رجع إلى طرابلس.
وأصبحت طرابلس عاصمة النشاط السياسي بإفريقيا حوالي ست سنوات، ثم انهزمت هذه الحركة أمام القوات التي قادها يحيى أبو بكر سنة (818هـ)، الذي استطاع أن يحرر تونس، ولكنه فشل في ضم طرابلس بل ظل أمراء طرابلس يهددون تونس من حين إلى آخر.
• طرابلس بين بني ثابت وبني مكي وبني حفص:
بنو ثابت عرب وشاحيون من بني سليم، ال إليهم حكم طرابلس من سنة (724هـ)، وظلوا يحكمونها بدون استقرار ـ حتى قبيل غزو الإسبان لها.
ومن ولاة بني ثابت:
ـ ثابت بن محمد (الأول) (724هـ).
ـ محمد بن ثابت (730هـ).
غزا جزيرة جربة وضمها إلى طرابلس واستعادها بنو حفص سنة (748هـ).
ـ ثابت محمد بن ثابت الثاني 750هـ:
استطاع تجار جنوى أن يخدعوا الطرابلسيين ويحتلوا المدينة في عام (755هـ) وهرب ثابت من المدينة، وحيل بين الأهالي وبين أسباب الدفاع، وغلبوا على أمرهم، فملكوا البلاد ونهبوا الأموال وتملكوا المتاع، وأسروا الرجال وسبوا النساء، ونقلوا كل ما استطاعوا إلى جنوى، فتدخل بنو مكي وهم من البربر، ونسبهم من لواته بزعامة أحمد بن مكي، وكان حاكماً لقابس وتفاوض مع الجنويين وطلبوا أن يدفع لهم خمسين ألف مثقال من الذهب العين، فقبل، وأرسل إلى السلطان أبي عنان في تونس يستنهض همته في دفع المبلغ، فلم يتفاعل، فأخرج ما عنده ووقف معه أهل قابس والجريد وتمَّ دفع المبلغ، وحرر بذلك طرابلس، وبعد ما مكث الجنويون حوالي خمسة أشهر.
وقد أرسل إليه سلطان الحفصيين أبو عنان المال الذي دفعه فاعتذر عن أخذه، وإنها لشهامة ونخوة ورجولة وموقف يدل على حميته الإسلامية القوية وعاطفته الجياشة نحو إخوانه في العقيدة.
وبعد هذا الموقف الشهم النبيل، رأى السلطان أبو عنان أن يعقد لأحمد بن مكي على طرابلس فتولاها وجعلها دار إمارته، وبقي أميراً عليها إلى أن توفي عام (766هـ).
وتولى ابنه عبد الرحمن ولاية طرابلس بعد وفاة أبيه، فكان سيء المعاملة عاجز الرأي مستبداً في الأمر كرهه الناس وسئموا حكمه.
واستطاع أبو بكر بن ثابت أن يحتل طرابلس بأسطول جاء به من مصر، ووقف الأهالي معه من أجل التخلص من ولاية عبد الرحمن بن مكي، وعمل أبو بكر بن ثابت على تحسين علاقته مع بني حفص واعترف لهم بالولاء.
وبعد وفاة أبي بكر بن محمد سنة (792هـ) ولي طرابلس ابن أخيه علي بن عمران بن محمد بن ثابت، واستطاع أن ينفصل عن الحفصيين، وتعرض لحصار عنيف استمر لمدة سنة، إلا أنه قاوم ذلك، واستطاع الحفصيون أن يدعموا ابن عمه يحيى بن أبي بكر وعين عليها رجلاً من قبله يثق فيه، وأصبحت طرابلس تابعة له، وانقرض حكم بني ثابت في طرابلس وإمارتهم عليها بعد أن حكموها نحو (79) سنة.
وتولى المنصور محمد بن عبد العزيز بن أبي العباس ولاية طرابلس عام (803هـ) واستمر في الحكم إلى وفاته عام (833هـ).
ثم تولى ولاية طرابلس عبد الواحد بن حفص، وقبل الشروع في عمله اشترط لقبولها شروطاً:
ـ أن يبقى والياً على البلاد، ولا يعزل حتى يعيد البلاد إلى مجدها التجاري ونشاطها الثقافي.
ـ أن يستقل بالإدارة ولا يردّ أمره في شيء.
ـ أن يتخذ من الجند لنفسه ما يريد.
وافق الأمير عبد العزيز الحفصي على تلك الشروط، وظهر من عبد الواحد ابن حفص حزم ورأي وإرادة، ونشر العدل ومنع الظلم، واستتب الأمن واطمأن الناس على أموالهم وأرواحهم، ونعمت البلاد بالخيرات واتسعت التجارات، وكثرت الأموال، وبقي والياً إلى أن توفي عام (858هـ) وكانت مدة حكمه (25) سنة، كانت أيام رغد وهناء على أهل طرابلس.
ويرى الشيخ الطاهر الزاوي بأن طرابلس منذ أن تولاها عبد الواحد بن حفص سنة (833 هـ) إلى أن احتلها الإسبان (916هـ) ؛ كانت في رخاء مستمر وأمن شامل، واستطاع الأهالي أن يجمعوا ثروة هىء لة كانت مضرب المثل في الشمال الإفريقي، وانغمس أهلها في متع الحياة، ووقعوا في الترف ؛ الذي أفسد عزائمهم وأخلاقهم، ووضعت روح الجهاد والكفاح والنضال في نفوسهم، فطمع الأعداء من النصارى فتكالبوا عليهم.
وحانت الفرصة للإسبان فجهزوا مئة وعشرين قطعة بحرية انضمت إليها سفن أخرى من مالطة، وشحنت بخمسة عشر ألف جندي من الإسبان، وثلاثة الاف من الإيطاليين والمالطيين. وفي (8 في ربيع سنة 916هـ) تحركت قواتهم نحو طرابلس، ووصلت أساطيلهم ليلة (الثامن عشر من ربيع سنة 916هـ الخامس والعشرين من يوليو سنة 1510م) وبدأ القتال بين النصارى الإسبان والطليان والمالطيين وبين أهالي طرابلس، ولم تكن القوات متكافئة، وسقطت المدينة في يد الأعداء، فهتكت الأعراض، وسبيت النساء وقتل الرجال، وديست المقدسات، واستمر الإفساد الإسباني في البلاد ما يقرب من عشرين سنة، ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا فيها أسوار المدينة، ثم سلمت طرابلس إلى فرسان القديس يوحنا في عام (942هـ/1535م).
واستمر فرسان القديس يوحنا حتى عام (958هـ/1551م) حيث استطاع الأبطال العثمانيون السنيون أن يُحكموا الحصار، ويحرِّروا أسر مدينتنا الحبيبة من قبضة فرسان القديس يوحنا.
• أسباب سقوط الدولة الحفصية:
ـ اعتمادها للمنهج المنحرف الذي نظر له ابن تومرت، وحرصها على تبني عقىء ده الفاسدة بعد أن انكشف زيف العقيدة التومرتية ومنهجه البدعي لكثير من أهالي الشمال الإفريقي، فأصبح الولاء ضعيفاً للفكر التومرتي حتى عند أمراء الدولة الذين تابعوا تبني منهج ابن تومرت كمناورة سياسية من أجل القضاء على بقايا دولة الموحدين.
ـ الصراع الداخلي على الحكم بين أبناء البيت الحفصي، وما ترتب على ذلك من صراع عنيف وقتال دموي.
ـ استقلال بعض المدن كإمارات مستقلة عن عاصمة الحفصيين، فتضطر أحيانا الدولة لتجريد الجيوش وتجهيزها من أجل إخضاع المدن لسلطانها، فيكلفها ذلك الكثير من الأموال والعتاد والرجال، وأحيانا تنهزم جيوش الدولة أمام مقاومة المدن الضارية.
ـ استُهدفت مدن إفريقية من قبل الإسبان النصارى والأوروبيين عموماً، فعملوا على تنصير الشمال الإفريقي والانتقام من المسلمين، واستغلال خيراتهم وثرواتهم، فدخلت الدولة في صراع معهم انتهى بالتحالف بين الإسبان والحفصيين.
ـ ظهور قوى إسلامية سنّية أصيلة متمثلة في السلطنة العثمانية، والتي استطاعت أن تهزم النصارى في ميادين البر وميادين البحر، وكان دافع الدولة العثمانية في صراعها مع النصارى ؛ نصرة الإسلام والمسلمين وحب الجهاد في سبيل رب العباد.
ـ تطلّع أهالي الشمال الإفريقي إلى قوة إسلامية سنّية تقوم بتحريرهم من الإسبان ومن الأمراء الذين تحالفوا معهم، ولم يحترموا مقدسات الأمة وعقيدتها ودينها، فوجدوا في العثمانيين بغيتهم فراسلوهم واتصلوا بهم، وتعاونوا على البر والتقوى، من أجل إعزاز الإسلام والمسلمين، ودحر النصارى الغاصبين.
ـ كان سقوط دولة الحفصيين نتيجة طبيعية لما الت إليه الحال من التنازع بين المسلمين، وعدم حرصهم على سلامة وحدة الأمة وأهدافها العظمى.
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي
الجزء الأول: تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى
من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي: