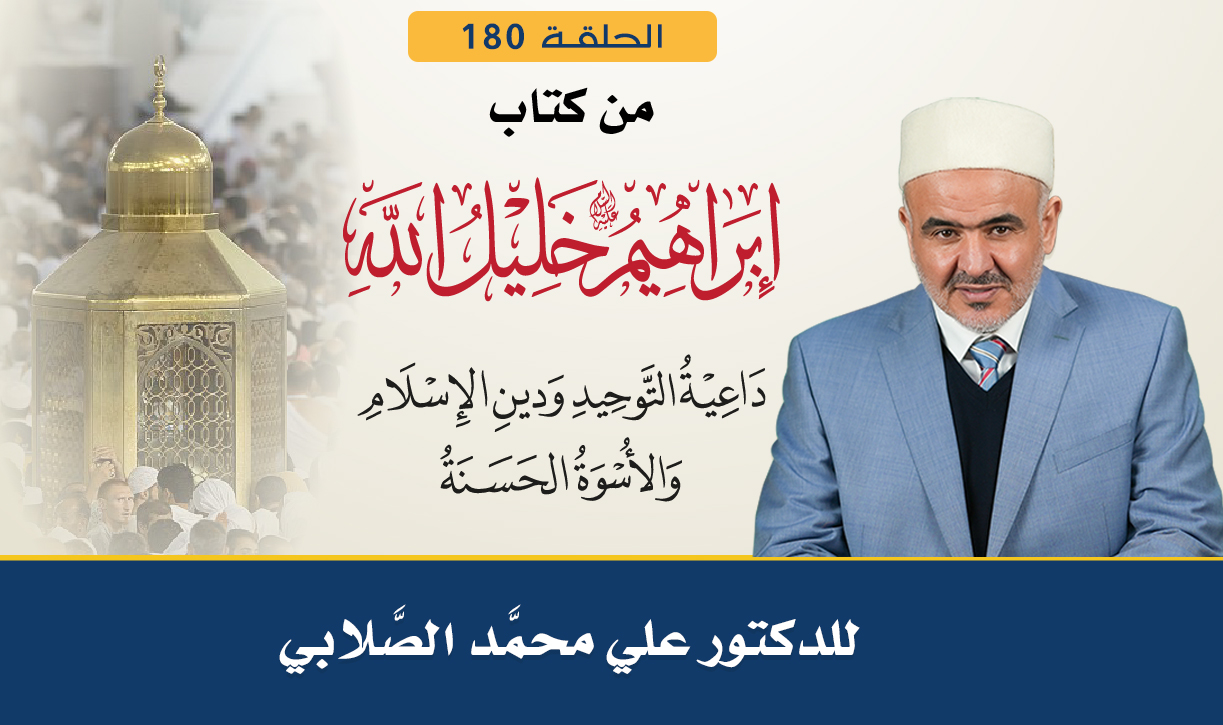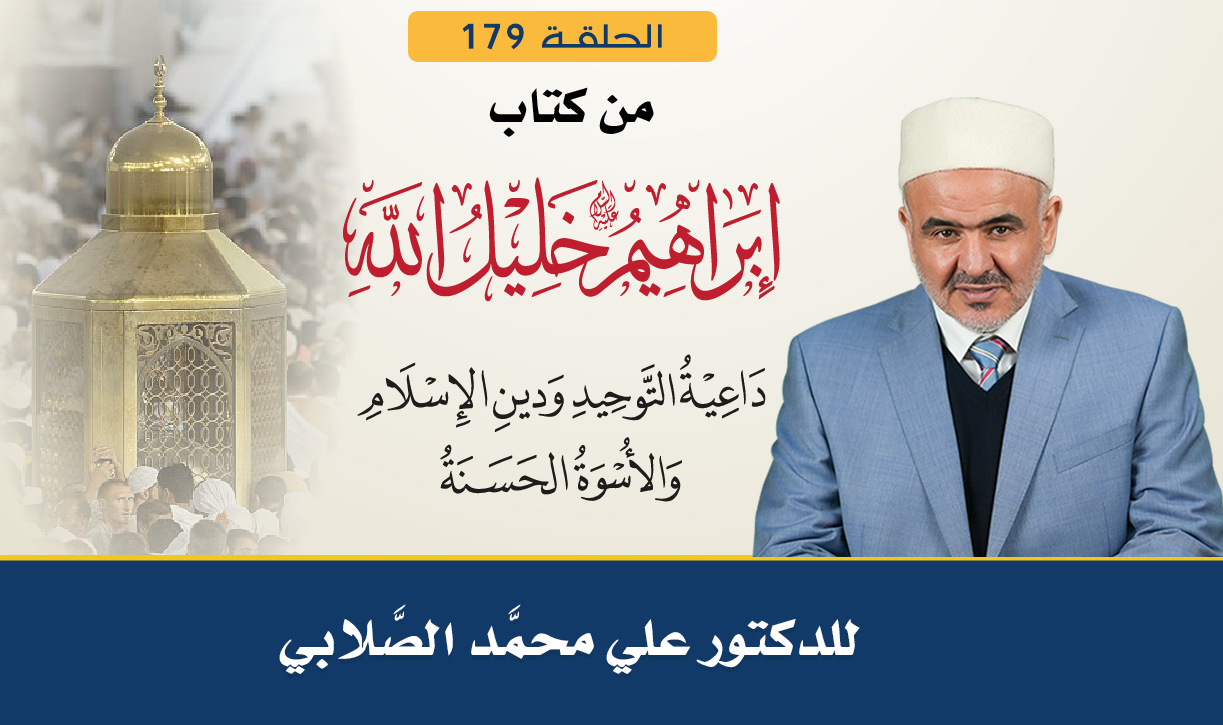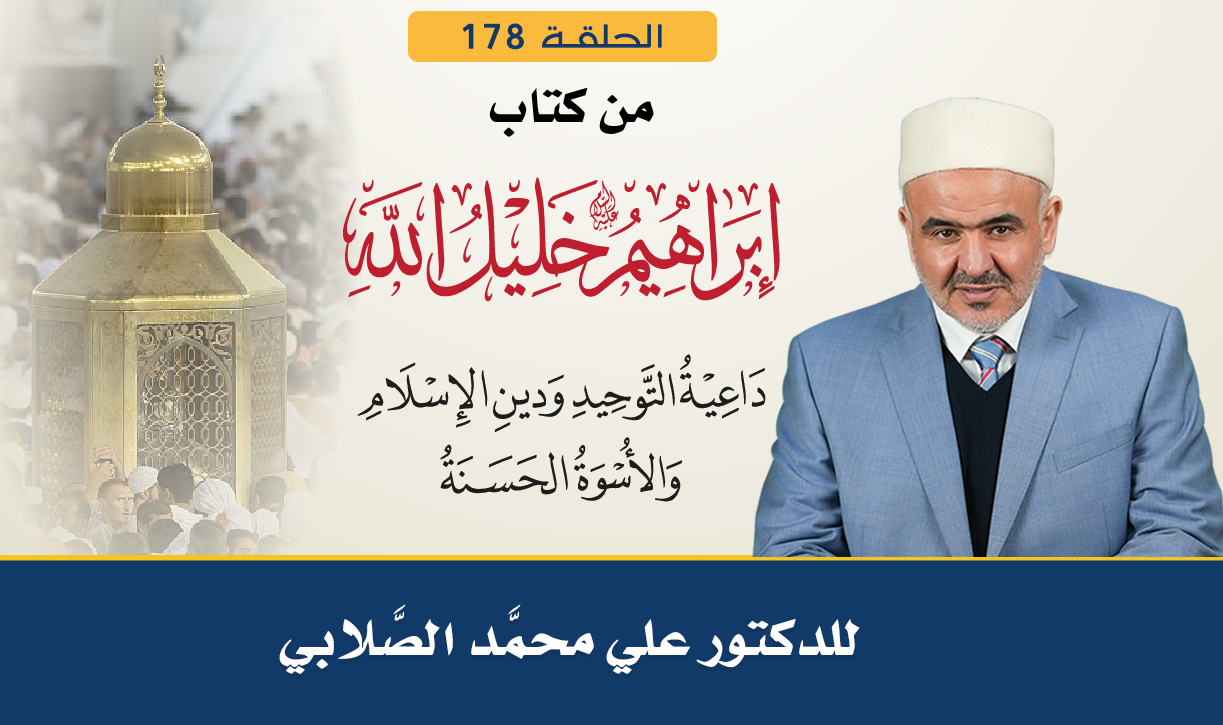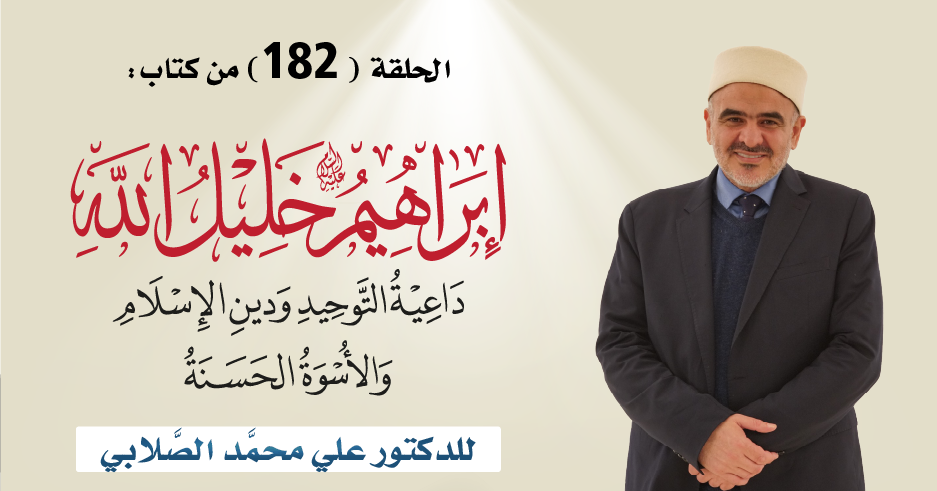تأملات في الآية الكريمة {قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ}
من كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
الحلقة: 180
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
جمادى الآخرة 1444ه/ يناير 2023م
تظهر هنا حكمة إبراهيم - عليه السّلام - وجودته في المناظرة، سواء قلنا: إن هذا من باب الانتقال من حجة إلى أوضح منها، أو قلنا: إنّه من باب تفريغ حجة على حجة(1).
وقد اختلف المفسرون، هل ذلك انتقال من دليل إلى دليل؟ أو هو دليل واحد في الموضعين؟
ذهب الزمخشري إلى القول الأول، فيقول: وكان الاعتراض عتيداً، ولكن إبراهيم - عليه السّلام - لما سمع جوابه الأحمق لم يحاجّه فيه، ولكن انتقل إلى ما لا يقدر فيه، على نحو ذلك من الجواب؛ ليبهته أول شيء، وهذا دليل على جواز الانتقال من حجّة إلى حجّة(2).
وقال أبو حيان في البحر المحيط: معنى قول الزمخشري: وكان الاعتراض عتيداً؛ أي: من إبراهيم لو أراد أن يعترض عليه بأن يقول له: أحيي من أمتّ فكان يكون في ذلك نصرة الحجة الأولى(3).
وأما القول الثاني: وهو أنه ليس انتقالاً من دليل إلى دليل، بل الدليل واحد في الموضعين وهذا قول المحققين، يقول ابن كثير: قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} أي: إذا كنت كما تدّعي أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته، وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلهاً كما ادّعيت تحيي وتميت، فأتِ بها من المغرب(4).
وهذا التنزيل على المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقين: إنَّ عدول إبراهيم - عليه السّلام - عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه ومنهم من قد يُطلق عبارة ردية، وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادّعاه نمرود في الأول والثاني(5).
وإلزام المدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة، ويشير البقاعي إلى حُسن احتجاج إبراهيم - عليه السّلام - فيقول: ولما كان من حسن الاحتجاج ترك المراء بمتابعة الحجة الملبسة، كما قال تعالى: {فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا} ]الكهف:22[، نقل الحجاج من الحجّة الواقعة في الأنفس إلى الحجّة الواقعة في الآفاق بأعظم كوكبها الشمس {سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ} ]فصلت:53[، ففي ظاهر الاحتجاج انتقال وفي طيه تقرير للأول(6).
وقوله: {فَإِنَّ اللَّهَ}؛ هذه الفاء جواب شرط مقدر، تقديره: قال إبراهيم إن زعمت أو موّهت بذلك فإن الله، ولو كانت الجملة محكيّة بالقول لما دخلت هذه الفاء، بل كان تركيب الكلام، قال إبراهيم: إن الله يأتي.
وقال الألوسي: والفاء للأول للإيذان بتعلّق ما بعدها بما قبلها، والمعنى: إذا ادّعيت الإحياء والإماتة لله تعالى وأخطأت أنت في الفهم أو غالطت، فمريح البال ومزيج الالتباس والإشكال {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ}، فالفاء رابطة بين الكلامين إِشعاراً لتنمية الحجة الأولى بالحجة الثانية(7).
كما أن من دلالة دقة المعنى وتقويته مجيء الطباق في الأسلوب بين كلمتين "يحيي" و"يميت" وبين "المشرق" و"المغرب" سلساً طيعاً غير متكلف يزيد في إيضاح المعنى وإظهاره وتقويته، وذلك عن طريق المقارنة بين الضدّين، وتصوير أحد الضدّين فيه تصور للآخر، وعلى هذا فالذهن عند ذكر الضدِّ يكون مهيأ للآخر ومستعداً له، فإذا ورد عليه ثبت وتأكد فيه( .
.
ومن اللطائف العلمية التي تستنتج مما سبق: أنّ المحاجة لإبطال الباطل ولإحقاق الحق من مقامات الرسل، لقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ}، كما أن في الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجّة؛ لأنّها سُلم ووسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل(9).
إنَّ إبراهيم - عليه السّلام - استند في مناظرته لخصمه لحقيقة في الأنفس: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ}، وحقيقة في الآفاق: {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ}، وهما حقيقتان كونيتان هائلتان، وهما - مع ذلك- مكررتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار، لا تحتاجان إلى علم غزير، ولا إلى تفكير طويل، فالله أرحم بعباده أن يكلهم في مسألة الإيمان به والاهتداء إليه، إلى العلم الذي قد يتأخر أو يتعثر وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ للبدائيين، إنما يكلهم في هذا الأمر الحيوي الذي لا تستغني عنه فطرتهم، ولا تستقيم دونه حياتهم، ولا ينتظم مع فقدانه مجتمعهم، ولا من دونه يعرف الناس من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم وآدابهم، يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الجميع، والتي تفرض نفسها فرضاً على الفطرة، فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجئ إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد.
والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري، فالكائن الحي يبحث عن الطعام والشراب والهواء، كما يبحث عن التناسل والتكاثر، بحثاً فطرياً ولا يترك الأمر في هذه الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج أو حتى ينمو العلم ويغزر وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى الدمار والبوار.. والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والهواء سواءً بسواء، ومن ثم يكله الله فيه إلى تلاقي القطرة بآياته المبثوثة في صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق(10).
مراجع الحلقة الثمانون بعد المائة:
(1) قصص القرآن، محمد صالح بن العثيمين، ص48.
(2) تفسير الزمخشري "الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل"، الرمخشـري، (1/489).
(3) البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسي، (2/300).
(4) تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، (1/686).
(5) المرجع نفسه، (1/686 - 687).
(6) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، (1/504).
(7) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسي، (3/19).
(8) التناسب القرآني في آية قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرود، مريم نافل الدويلة، ص51.
(9) المرجع نفسه، ص51.
(10) في ظلال القرآن، سيد قطب، (1/229).
يمكنكم تحميل كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي