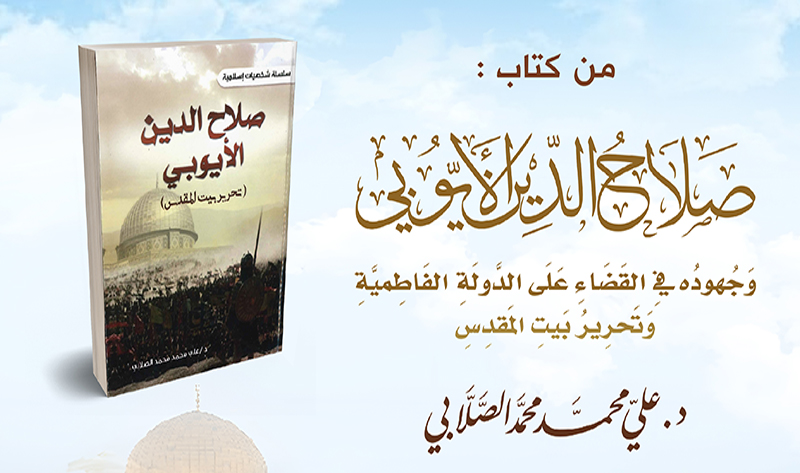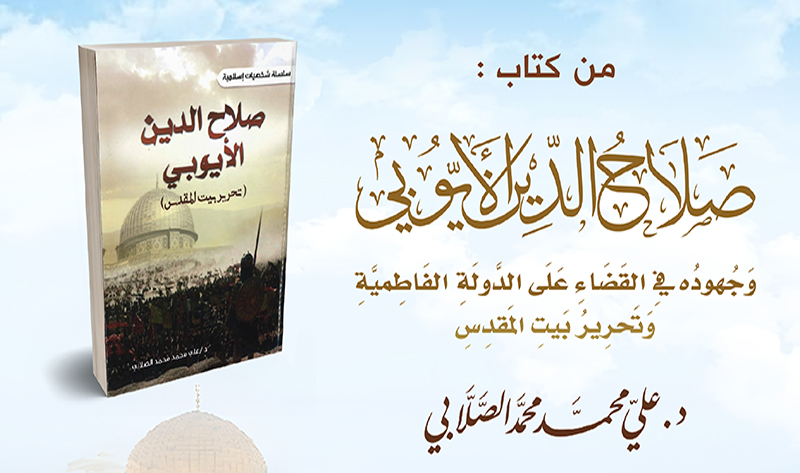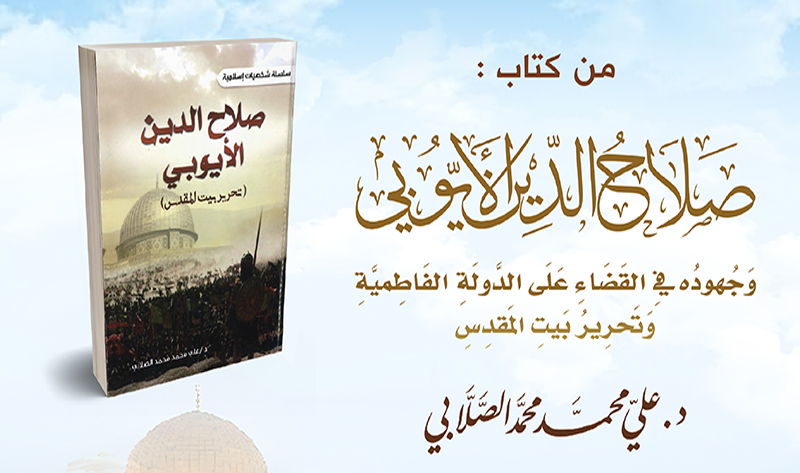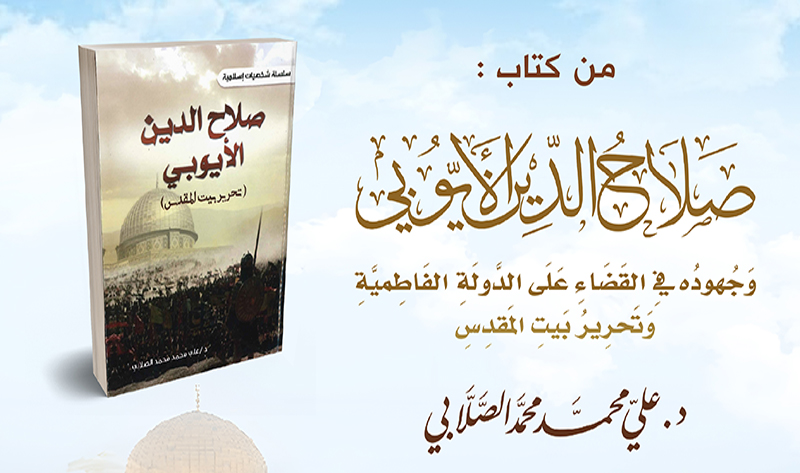في سيرة صلاح الدين الأيوبي:
مكانة الحافظ السلفي ودوره في الدولة الأيوبية (1):
الحلقة: الرابعة و الأربعون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يونيو 2020
هو الحافظ أبو الطَّاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السِّلفَي الأصبهاني، وهو من علماء المشارقة؛ الذين هاجروا إلى مصر ، واستقرُّوا بالإسكندرية ، ونفع الله بهم نفعاً عظيماً في نشر مذهب أهل السنَّة.
1 ـ قدومه إلى الإسكندرية:
نزل السِّلفي الإسكندرية سنة 511هـ وكان عمره قد بلغ السادسة والثلاثين عاماً ، وكان قد تجمَّع لديه خبراتٌ واسعةٌ ، وحصل على علمٍ وفيرٍ ، وبلغ من النضج الفكريِّ ، والتخصُّصيِّ في ميدان علم الحديث مبلغ العلماء المتخصصين ، فهو قد رحل إلى بلادٍ كثيرة ، فأتيح له أن يلتقي بأعدادٍ كثيرة من العلماء ، وكبار المحدثين ، أتقن على أيديهم الرواية ، وقواعد التحديث ، وعلوم المصطلح ، وانتخب من كتبهم كثيراً من المختارات الجيدة ، والفوائد النادرة ، ونسخ بخطِّه السريع الأجزاء الكثيرة. وكان أيضاً ذا خبرةٍ ، وتجربةٍ في الكتابة ، والتأليف ، فقد سبق له أن ألَّف معجماً لشيوخه في أصبهان ، ومعجماً اخر لشيوخه في بغداد. وكانت له درايةٌ سابقةٌ بالتحديث ، والتعليم ، فهو قد زاول ذلك فعلاً في أوائل سنة 492هـ في بلده بأصبهان ،... وكذلك أثناء إقامته في دمشق ، حيث اشتغل بالتدريس من سنة 509هـ إلى 511هـ.
ولم تكن ثقافة «السِّلَفي» حين قدومه مقتصرةً على الحديث وحده ، وإنما كان أيضاً فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي ، فهو قد درس الفقه في نظامية بغداد على يد شيخه أَلْكيا الهرَّاسي ، وفخر الإسلام الشاشي ، ويوسف بن علي الزنجاني. وكان السِّلَفي أيضاً متقناً لعلم القراءات ، عارفاً بحروفها ، ووجوهها ، قد تتلمذ في ذلك على علماء القراءات المشهورين في عصره. يقول الذهبي: نقلت من خط الحافظ عبد الغني المقدسي نقل خطوط المشايخ «للسِّلَفي بالقراءات ، وأنه قرأ بحرف عاصم على أبي سعد المطرز ، وقرأ برواية حمزة ، والكسائي
على محمد بن أبي نصر القصَّار ، وقرأ لقالون على نصر بن محمد الشيرازي ، وقرأ برواية قُنبل على عبد الله بن أحمد الخرقي ، وقد قرأ على بعضهم في سنة 491هـ ، وفضلاً عن إلمام السِّلفي بالحديث ، ومعرفته بالفقه ، وعلم القراءات قبل أن يستقرَّ في الإسكندرية؛ فقد كان مُلمَّاً أيضاً بالأدب ، واللغة العربية ، فقد درس ذلك كلَّه أيام كان في بغداد على يد العالم اللغوي المشهور أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي شيخ الأدب في «النظامية». وكان شاعراً ينظم الشعر ، ويتذوَّقه ، ويحبُّ سماعه ، ويختم كلَّ مجلس من مجالسه التي أملاها على طلاب الحديث في سَلَماس بأبياتٍ من شعر الحكمة النَّصيحة.
أحبَّ السلفي الإسكندرية ، وأهلها ، فقد أكرموا وفادته ، ورأى: أنَّها المكان المناسب لإقامته ، حيث يمكنه فيها أن يفيد ، ويستفيد ، فأقلع ـ مؤقتاً ـ عن نية مغادرتها إلى بلاد الأندلس ، وقرَّر أن يتَّخذها دار إقامته ولو إلى حين ، ، كان قراره هذا يرجع في حقيقته إلى عدَّة أسباب بالإضافة إلى إكرام ، وحبِّ أهل الإسكندرية له ، منها ما يلي:
* موقع الإسكندرية الجغرافي المتوسط لبلدان العالم الإسلامي ـ وبخاصةٍ بين الحجاز في المشرق ، وبين المغاربة ، والأندلس في المغرب ـ جعلها أشبه بملتقى الحجَّاج الأندلسيين ، والمغاربة الذين كانوا يستريحون فيها من وعثاء السفر أياماً أثناء توجُّههم إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ، وكذلك أثناء عودتهم منه إلى بلادهم ، فكانوا ينتهزون فرصة استراحتهم فيها ، فيلتقي علماؤهم ، وأدباءهم بعلمائها ، وأدبائها ، فيُسمعون ، ويَسمعون منهم ، ويتبادلون معهم ضروباً من المعرفة ، والثقافة ، فيفيدون ، ويستفيدون.
* كانت الإسكندرية في مطلع القرن السادس الهجري ملتقى كثيرٍ من علماء الشام؛ الذين كانت بلادهم مسرحاً للحروب الصليبية ، والتي سقط بعض مدنها في أيدي الصليبيين ، كالقدس ، والرَّملة ، وكثير من مدن الساحل الفلسطيني؛ مما اضطر أولئك العلماء إلى هجرتها ، والنزوح عنها.
* نزوح عدد كبير من علماء صقلية المسلمين إلى الاسكندرية بعد أن احتلَّ النورمان جزيرتهم في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ، ونزوح عدد اخر من علماء الأندلس على أثر الهزات السياسية المتلاحقة التي أصيب بها بعض المدن الأندلسية؛ مما دفع الكثيرين من العلماء إلى الهجرة ، وطلب الأمن ، كما فعل الفقيه المالكي المشهور أبو بكر الطرطوشي ، وغيره.
* تمتُّع أهل الإسكندرية بحرية الاعتقاد الديني ـ إذا ما قورنوا بأهل القاهرة ـ رغم انطوائهم رسمياً تحت نفوذ الخلافة الفاطمية الشيعية ، فقد كانوا سِّنيين على مذهب الإمام مالك ، وهذه الحرية النسبية جعلت الوافدين إلى مصر يتوجَّهون إلى الإسكندرية ـ بدلاً من القاهرة ـ للإقامة فيها بعيدين عن ضغوط المذهب الفاطمي الشِّيعي؛ الذي يتنافى مع اعتقادهم السني.
هذه الأسباب ، وغيرها رغبت الحافظ السِّلفي في البداية أن يقيم في الإسكندرية ، ثم ما لبث أن رسخت فيها قدمه ، وتقدَّمت بها سنه ، وأخيراً تزوَّج ـ وقد قارب الستين عاماً ـ من «ستِّ الأهل» الإسكندرانية ، فثقل بذلك حِمْله ، ثم ألقى عصا الترحال بعد ذلك نهائياً عندما بنى له والي الاسكندرية العادل ابن السلار «مدرسته العادلية» وعهد إليه بالإشراف عليها ، والتدريس فيها ، فاستقرَّ به المقام ، وطاب له الحال ، ولم يبرح تلك المدينة؛ التي أحبَّها إلى أن توفاه الله تعالى.
2 ـ نشاطه العلمي ومدرسته:
بدأ الحافظ السِّلَفي تدريسه للحديث منذ وصل إليهاسنة 511هـ حتى إذا ما توفي محدِّث الإسكندرية انذاك الشيخ أبو عبد الله الرازي المعرف بابن الخطاب سنة 525هـ؛ جلس مكانه ، وأصبح بذلك شيخ الإسكندرية ، ومحدِّثها المتفرد دون منازع ، ثم أخذت شهرته ، وسمعته تتزايد يوماً بعد يوم ، وراح حُجَّاج الأندلس يتناقلون أخباره في كلِّ مكانٍ نزلوا به ، فتسامع به طلاب الحديث في مصر ، وخارجها ، فشدُّوا إليه الرِّحال ، وتوافدوا على الإسكندرية من كلِّ حَدَبٍ ، وصوب؛ ليلتقوا بمحدثها الكبير ، وحافظها المتقن ، فنشطت بذلك دراسة الحديث ، وروايته فيها ، وأصبحت لها مكانتها المرموقة في هذا الميدان من الدراسة. يقول: والإسكندرية تبع لمصر، ما زال بها الحديث قليلاً حتى سكنها «السِّلَفي» فصارت مرحولاً إليها في الحديث ، والقراءات.
3 ـ المدرسة العادلية «السِّلَفية»:
ظل السِّلَفي يلقي دروسه في المسجد حيناً ، وفي منزله حيناً اخر زهاء ربع قرن إلى أن ولي المدينة أبو الحسن علي بن السلار الملقب بالملك العادل ، فاحتفل به ، وزاد في إكرامه ، وبنى له مدرسةً سميت «المدرسة العادلية» نسبة إلى منشئها «العادل» ثم عرفت بعد ذلك بالمدرسة السِّلَفية نسبة إلى مدرسها السِّلَفي. وقد بيَّن الدكتور جمال الدين الشيال في كتابه: أعلام الإسكندرية: أنها أنشئت في سنة 544هـ وكذلك ذكر الدكتور حسن عبد الحميد صالح بأن المدرسة بُنِيتْ سنة 544هـ وقد أشارت المصادر التاريخية إلى أنَّ ابن السيار كان سنياً من أصلٍ كرديٍّ ، وأنَّه أظهر اعتناقه لعقيدة أهل السنة أثناء ولايته لثغر الإسكندرية ، ثم أخذ يراسل نور الدين محمود حاكم حلب طمعاً في مساندته ضدَّ السلطة الفاطمية ، فتوطَّدت بينهما صداقُةُ ، وودٌّ ، وأمدَّه بالعون الماديِّ؛ لأنَّ ابن السلار كان سنياً مثله ، ولأنَّ نور الدين كان يطمع أن يفتح مصر أيضاً ، وربما أشار نور الدين محمود على ابن السَّلار في مراسلتهما أن يطبِّق نفس التجربة التي طبقت في سوريا بشأن تقويض المذهب الفاطمي الشِّيعي ، والقضاء عليه عن طريق بناء المدارس ، فبنى ابن السلار هذه المدرسة ، ووكل رعايتها ، والتدريس فيها إلى محدِّث الإسكندرية السُّني الحافظ «السِّلَفي».
وكان طبيعياً أن يكون هذا كلُّه أثناء ولاية ابن السلار على الإسكندرية ، وقبل أن يستولي على الوزارة في 15 شعبان سنة 544هـ وقد تخوف الخليفة الفاطمي «الظافر» وأحسَّ بخطورة ابن السلار ، وأثر مدرسته السنية ، واستقطاب أهل السنة حوله ، فتخوَّف منه ، وأخذ يكيد له ، وعهد بالوزارة إلى نجم الدين بن مصال الوزير الشِّيعي؛ الذي ينحدر من أصل مغربي ، فأغضب ذلك ابن السَّلار الرجل السني ، فجمع أنصاره من أهل الإسكندرية السنيين ، وسار بهم إلى القاهرة ، فدخلها بعد أن هزم ابن مصال عند الجزيرة في 14 رمضان سنة 544هـ ، وقد لا نكون مغالين إذا قلنا: إن السبب الحقيقي بين ابن السلار ، وبين ابن مصال إنما هو نزاع بين عقيدة أهل السنة التي يساند الدَّعوة إليها نور الدين محمود ، وبين المذهب الفاطمي الشيعي الذي يمثله الخليفة الفاطمي. لقد كان لإنشاء هذه المدرسة فرحةٌ عظيمة في نفوس أهل الإسكندرية ، واعتبروا بناءها هديةً كبيرةً من واليهم ابن السلار ، ومن واجبهم أن يشكروه عليها ، فانبرى شعراؤهم يمدحونه ، ويثنون عليه ، ويعبرون له عمَّا في نفوسهم من الغبطة ، والابتهاج.
وقد تولَّى الحافظ «السِّلَفي» الإِشراف على هذه المدرسة ، فجعل منها مركز إشعاع لإعادة أهل مصر لعقيدة أهل السنة ، ومنتدى لأهل الفكر ، والثقافة ، فكان يلتقي فيها علماء الحديث ، وطلابه ، ورجال الفقه ، والقراءات ، والأدباء ، والشعراء ، ورجال التاريخ ، وأصحاب الحكايات ، فنمت ، وازدهرت ، وكثر روَّادها ، والمتأثِّرون بما يُلقى فيها من دروس ، وما يعقد فيها من لقاءات ، وندوات ، ومحاضرات ، وقد تجلَّى تأثيرها واضحاً في أهل الإسكندرية بالذَّات من موقفين واضحين: أولهما: يوم خرجوا مع واليهم ابن السلار للاستيلاء على الوزارة في القاهرة ، وثانيهما يوم وقفوا يحاربون مع صلاح الدين ، ويناصرونه ضدَّ الوزير الفاطمي (شاور) وحلفائه الصليبيين ، فلم يخذلوه ، أو يتخلَّوا عنه رغم الحصار الشديد؛ الذي فرض عليهم ثلاثة شهور ، بل حاربوا معه جنباً إلى جنب ، وبذلوا له كلَّ ما يملكون من قوةٍ ، ومالٍ ، ورجالٍ إلى أن فكَّ شاور ، والصليبيون الحصار.
وقد احتفظ صلاح الدين الأيوبي لأهل الأسكندرية بهذا الجميل ، فلما أزال الدولة الفاطمية ، وأقام على أنقاضها دولته الأيوبية؛ أولى الإسكندرية اهتماماً خاصاً ، ورعايةً كبيرةً ، وذلك لأهمية موقعها الاستراتيجي في الدِّفاع عن مصر من ناحيةٍ ، ولما كان لأهل الإسكندرية من مكانةٍ طيبة عنده لمَّا ساندوه في وقفتهم البطولية حين حاصره «شاور» في مدينتهم سنة 562هـ ، فوقفوا يذودون عنه ، ويقدِّمون له كلَّ ما يملكون من رجالٍ ، ومالٍ ، وسلاح ، ولهذا ليس بمستغرب أن نرى صلاح الدين يأمر منذ اللحظة الأولى لتوليه سلطنة مصر بإصلاح سور الإسكندرية ، وتحصين أبراجها ، وقلاعها ، وإدخال بعض المنشات فيها. وليس هذا فحسب بل نراه يسافر بنفسه في سنة 572هـ إلى الإسكندرية؛ ليشاهدها ، ويرتِّب قواعدها ، وأمر بعمارة أسوارها ، وأبراجها ، وفي هذه الزيارة تفقَّد صلاح الدين الأسطول الحربي ، ورأى ما ال إليه من خرابٍ ، وإهمالٍ ، فأمر بتجديده ، وتعميره ، وبناء سفن جديدة تضاف إليه ، وأفرد له ميزانيةً خاصَّةً ، وأنشأ له ديواناً خاصاً ، وعين له قائداً ، سمَّاه «صاحب الأسطول».
وظلَّت الإسكندرية محل رعاية صلاح الدين ، وعنايته ، يوصي بالإنشاءات فيها ، ويتفقَّد أحوالها ، ويتابع الاهتمام بها إلى أن وافته الفرصة لزيارتها مَرّةً ثانية في سنة 577هـ فزارها ، ووقف بنفسه على ما تم فيها من إصلاحات ، وتفقد المنشات التي أمر ببنائها ، وأمر بسرعة إنجازها ، يقول العماد الأصفهاني في وصف هذه الزيارة: وتوجَّه السلطان بعد شهر رمضان سنة 577هـ إلى الإسكندرية على طريق البحيرة ، وخيم عند السَّواري ، وشاهد الأسوار؛ التي جدَّدها ، والعمارات؛ التي مهَدها ، وأمر بالاتمام ، والاهتمام. وفي هذه الزيارة حظيت الإسكندرية من صلاح الدين بتأسيس كثير من المنشات العمرانية ، والمرافق العامة ، فأنشأ فيها مدرسةً كبيرة للطلاَّب الغرباء ، يتعلَّمون فيها مختلف العلوم ، والاداب ، وبنى لهم داراً يقيمون فيها ، وحماماتٍ يستحمُّون فيها ، ومارستاناً يعالجون فيه بالمجان ، ويشرف عليه أطباء متفرِّغون.
ثم تتابع بناء المدارس في الإسكندرية في عهد صلاح الدين تتابعاً سريعاً وفقاً لسياسته العامة في الإكثار من تشييد المدارس كوسيلة فكرية للقضاء على الفكر الفاطمي الشيعي ، وقد كثر عدد المدارس في سنواتٍ قليلةً كثرةً لفتت أنظار المؤرخين؛ الذين زاروا الإسكندرية، وكتبوا عنها. يقول ابن خزيمة؛ الذي زار الإسكندرية سن 561هـ 1164م ، وأقام فيها ، وكتب وصفاً لها: وبها مئة وثمانون مدرسةً لطلب العلم بها.
وأمر صلاح الدين في هذه الزيارة الثانية بإنشاء مسجده الجامع الكبير ، ونقل الخطبة إليه ، بعد أن كانت تقام في عهد الفاطميين في مسجد العطَّارين أكبر مسجدٍ في المدينة ، ثم تبع ذلك بناء عدد كبير من المساجد بالإضافة إلى ما كان فيها من مساجد من قبل ، وقد بلغ عدد المساجد في هذه الفترة رقماً عالياً لفت أنظار المؤرخين؛ الذين زاروا المدينة ، فأخذوا يقدرونها تقديرات مختلفة، يصلون فيها أحياناً إلى حدِّ المبالغة. وقد وصف ابن جبير؛ الذي زار الإسكندرية في سنة 578هـ أي في زمن صلاح الدين ـ فيصف كثرة المساجد بها ، فيقول: وهي أكثر بلاد الله مساجد؛ حتى إنَّ تقدير الناس لها يطفف ، فمنهم المكثر ، والمقل ، فالمكثر ينتهي في تقديره إلى اثني عشر ألف مسجد ، والمقل دون ذلك لا ينضبط ، فمنهم من يقول: ثمانية الاف ، ومنهم من يقول غير ذلك ، وبالجملة فهي كثيرةٌ جداً يكون منها الأربعة ، والخمسة في موضعٍ واحد ، وربما كانت مركَّبةً ، وكلُّها بأئمة مرتَّبين من قبل السلطان. وظلَّت عناية الأيوبيين بتعمير الإسكندرية مستمرةً بعد صلاح الدين على نفس السياسة؛ حتى نهاية القرن السَّادس الهجري.
4 ـ مميزات شخصية أبي الطَّاهر السِّلَفي:
أ ـ جديته في الحياة:
كرَّس الحافظ السِّلَفي حياته كلَّها للتدريس ، والمطالعة ، والكتابة ، وإلقاء المحاضرات دون أن يُؤْثَر عنه مللٌ ، أو سأمٌ ، وكانت حياتُه كلها جادَّةٌ صارمةٌ ، كما وصفها تلميذه الحافظ عبد القادر الزهاوي بقوله: وبلغني: أنَّ مدَّة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان ، ولا فرجة سوى مرَّة واحدة ، بل كان ملازماً مدرسته ، وما كنا ندخل عليه؛ إلا ونراه مطالعاً في شيءٍ... وأنه ما رأى منارة الإسكندرية إلاِ مِنْ طاقةٍ كانت في داره. ووصفه ابن العماد أيضاً بقوله: واستوطن «السِّلَفي» الإسكندرية بضعاً وستين سنة مكباً على الاشتغال بالعلم ، والمطالعة ، وتحصيل الكتب.
ب ـ احترامه لمجلسه:
كان ـ رحمه الله ـ حليماً ، متواضعاً ، موطَّأ الأكناف ، يألف الناس ، ويألفونه ، ويتحمَّل الإساءة ، ويصبر على جفوة الغرباء ، يحبُّ روَّاده ، ويقبل على الجميع منهم بكلِّ وجهه ، ومشاعره ، لا يدَّخر وسعاً في إفادتهم ، والتلطُّف معهم ، والإخلاص لهم. وصفه خليل الصفدي بقوله: وكان لا يكاد تبدو منه جفوةٌ في حقِّ أحد ، وإن بدأته بادرها؛ حتى لا ينفصل عنه أحدٌ إلا بطيب القلب ، ومع ذلك كلِّه فلم يكن يسمح أثناء الدرس لواحد من الحاضرين أن يلهو ، أو يعبث ، أو يتحدَّث مع جاره ، أو يشغل غيره عن الإصغاء ، والمتابعة مهما كان شانه ، ومكانته ، حتى إذا ما انتهى من عبارته ، أو فكرته؛ التي يتحدث فيها؛ أتاح للحاضرين الاستفسار ، والتعليق. روى الحافظ الذهبي: أنَّ السلطان صلاح الدين ، وأخاه حضرا يوماً عنده لسماع الحديث ، وأنَّهما تحدَّثا معاً بصوتٍ منخفضٍ ، فالتفت إليهما ، وزبرهُما ، وأظهر لهما عدم الرِّضا ، وقال: أيش هذا؟ نحن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ـ وأنتما تتحدثان؟! فأصغيا عند ذلك.
ج ـ حبُّه للمطالعة وجمع الكتب:
وكان ـ رحمه الله ـ كثير المطالعة ، واسع المعرفة ، مجداً في التحصيل ، كثير البحث عمَّا يشكل ، لم يكن يشغله بعد الفراغ من التدريس إلا القراءةُ في كتاب ، أو النسخ من كتب الاخرين ، أو التحقيق ، والتعليق عليها. وقد وصفه تلميذه الحافظ عبد القادر الرَّهاوي ، فقال: ما نكاد ندخل عليه إلا ونراه مطالعاً في شيءٍ. وكان يحبُّ الكتب حباً جماً ، ويحرص حرصاً شديداً على جمعها ، وتملُّكها ، حتى لقد تجمع لديه منها مجموعاتٌ كثيرةٌ منوَّعةٌ، لم يسعفه الوقت للنظر فيها ، فلمَّا مات؛ وجدوا معظمها قد عفنت ، ولصق بعضها ببعض نتيجةً لرطوبة جوِّ الإسكندرية ممَّا أدى إلى تلف الكثير منها. وما كان يصل إليه من المال كان يخرجه.
5 ـ علاقته مع المثقفين:
كانت حلقات الدرس في المسجد أولاً ، ثمَّ في المدرسة بعد ذلك هي همزة الوصل بينه وبين كافة فئات المثقفين من الناس ، وقد استطاع من خلال تلك الحلقات أن يكون له صلاتٌ واسعةٌ مع عدد كبير جداً من علماء الحديث ، وطلابه ، ومع رجال الفكر ، والأدب ، كالكتَّاب ، والأدباء ، والشعراء ، ومع كبار موظفي الدَّولة ، كالولاة ، والقضاة ، وغيرهم ، ومع أرباب المهن ، والحرف المختلفة ، كالأطبَّاء ، والمهندسين ، والتجَّار ، والورَّاقين ، ومجلِّدي الكتب ، وأئمَّة المساجد ، والوعَّاظ ، والنُّسَّاخ ، والمؤذنين ، ومع كثير من حجَّاج المغرب ، والأندلس؛ الذين كانوا يفدون إلى الإسكندرية في طريقهم إلى الحجِّ. وأما علاقته مع الشُّعراء؛ فقد كانت طيبةً متميزةً ، يسودها الودُّ ، والتعاطف ، فقد كان يأنس بهم ، ويحب مجالستهم ، والاستماع إليهم ، ويقارضهم القصيد أحياناً، فقد كان شاعراً مثلهم ، يقول الشعر ، ويتذوَّقه ، وينقده ، وصفه الحافظ الذهبي بقوله: وكان يستحسن الشعر ، وينظمه ، ويثيب من امتدحه.
6 ـ علاقته مع العوامِّ:
كانت طيبةً للغاية ، فهم قد أنزلوه من نفوسهم منزلةً عاليةً ، وكانوا يحضرون عنده في بعض الأوقات؛ ليتبرَّكوا به لتقواه ، وصلاحه ، بل لقد كانوا يبالغون في تقديرهم ، واحترامهم له ، وأخذوا يعتقدون فيه البركة. ومن لطيف ما لواه الحافظ الذهبي في هذا المقام: أنَّ العامة من أهل الاسكندرية كانوا يهرعون إليه ـ إذا تعسَّرت امرأة في ميلادها؛ ليكتب لهم بعض الأدعية في ورقةٍ ، وكان يكتب لهم ، ولا يمتنع ، وكان نصُّ ما يكتب: اللهم إنَّهم قد أحسنوا ظنَّهم بي ، فلا تخيِّب ظنَّهم فيَّ.
يمكنكم تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي: