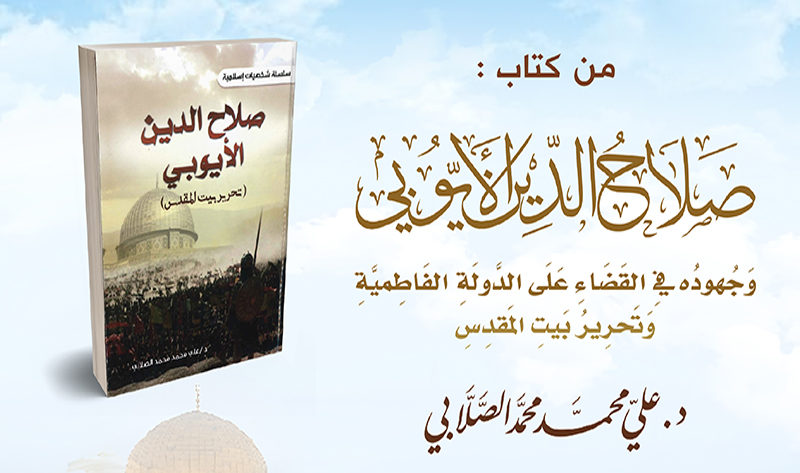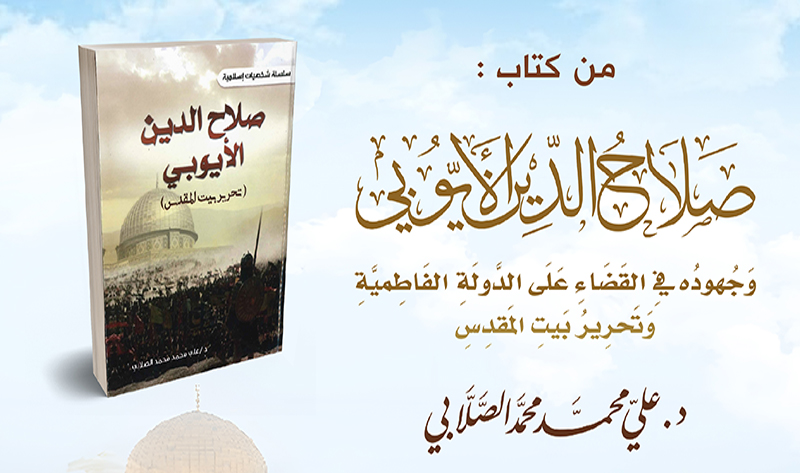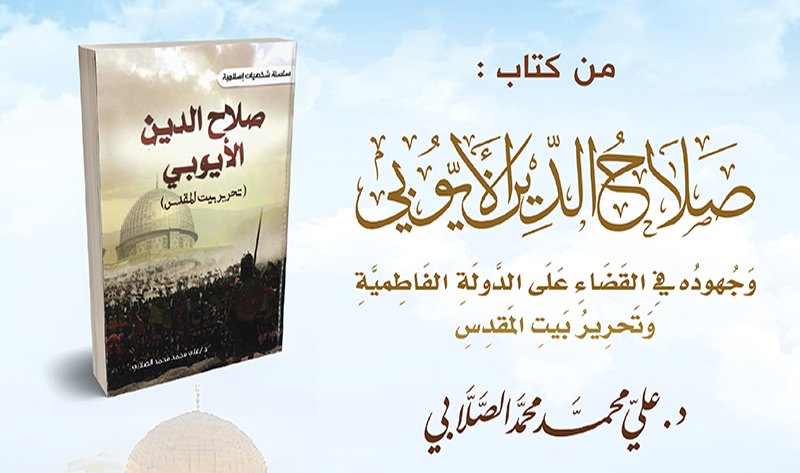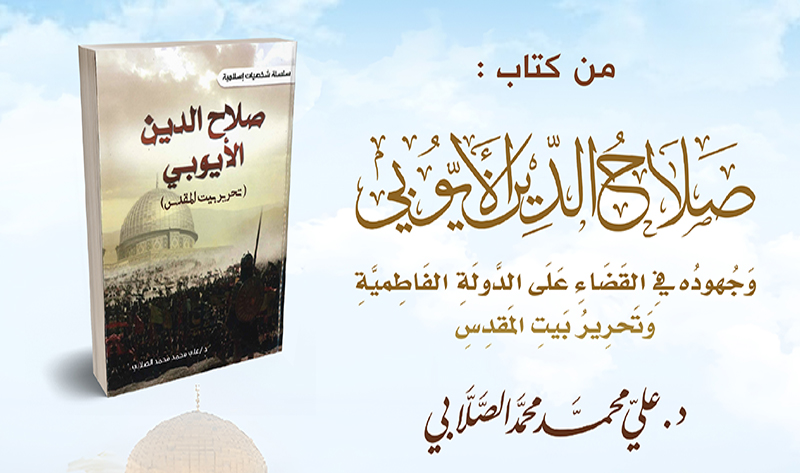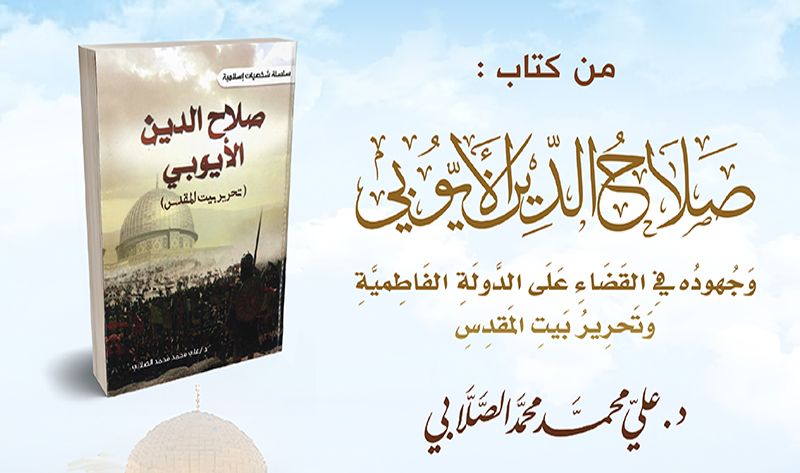في سيرة صلاح الدين الأوبي
خانقاوات الصُّوفية وصلاح الدين
الحلقة: الثالثة و الخمسون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يوليو 2020
لفظ خانقاه هو لفظ فارسي ، معناه في الأصل: المائدة ، أو المكان الذي يأكل فيه الملك ، ثم أطلق بعد ذلك على الخوانق ، أو الخانقاوات ، أو الدور التي قام على إنشائها الملوك ، والأمراء الراغبون في عمل القرب ، والمبرات لأغراضٍ كثيرةٍ ، أهمها: إيواء الغرباء من المسلمين الوافدين إلى ديارهم ، والقيام بمعيشتهم ، وتثقيفهم ، ومع أنَّ الصلوات الخمس المفروضة كانت تؤدَّى في إيوانٍ خاصٍّ للصَّلاة بهذه الخانقاوات؛ إلا أن صلاة الجمعة لم تكن تقام فيها. والخانقاه وهي بيت الصُّوفية كانت أشبه ما تكون بالمدرسة؛ لأنها كانت فعلاً مدرسة العامة ممَّن نذروا أنفسهم لحياة الزُّهد ، والتقشف ، سواء كانوا من أبناء الشعب ، أو من أرباب الحرف ، والصناعات؛ الذين عملوا على حمل مبدأ الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر في الطرق ، والأسواق ، فتشابهت الخانقاه بذلك مع المدرسة من حيث الشكل ، والوظيفة.
والخلاصة: إن الخوانق في الإسلام كانت عبارة عن دور للعلم ، والعبادة ، قامت بأدوار دينية ، و اجتماعية، وثقافية هامة في حياة المجتمع الإسلامي منذ نشأتها، فقد كانت أولاً معاهد للمذاهب الفقهية، والحديث ، وكانت ثالثاً مراكز إشعاع ثقافي بما احتوته بعض مكتباتها من الكتب المصنفة في كثيرٍ من العلوم والمعارف، وكانت وظائف الخانقاه كثيرة، ومتعدِّدة، منها: شيخ الخانقاه إمامها، وناظر وقفها، ومدرسو المذاهب، ومعيدوهم، والحكال، والجرائحي، والطبائعي، وخازن الكتب، وكاتب الغيبة، والشاهد، والمؤذن، والمزملاتي، ومشرف الحمَّام، ومشرف المطبخ، والطباخ، وخادم الشيخ، وخادم الربعات الشريفة، والبواب، والفراش، وسواق الساقية، والوقاد، ونحوهم. وإن دلَّ هذا الكم من الوظائف على شيءٍ؛ فإنَّما يدلُّ على حجم ما كان في هذه الخانقاوات من وظائف متنوعة ، كان كلُّ واحدٍ من أربابها يتقاضى نظير عمله بالخانقاه أجراً نقدياً ، راعى فيه الوقف أن يتناسب مع ثرائه المالي ، ومقامه الاجتماعي ، علاوةً على ما كانوا جميعاً يشتركون فيه من أجرٍ عيني انحصر في المأكل من الخضراوات ، واللحوم ، والأرز ، واللبن ، والعسل ، والحلوى ، ونحوها ، وفي الملبس ، والصَّابون ، وغير ذلك من الأرزاق الوافرة التي كانت توزَّع عليهم.
وقد سار صلاح الدين على نهج استاذه نور الدين ، فاهتمَّ بهذه المؤسسات ، وروَّادها من الصَّوفية ، وأحسن إليهم، واستشارهم في كثير من الأمور ، ويجلُّ علماءهم ، وجلس إليهم ، واستمع إلى نصحهم ، ووقفوا معه في حروبه ضدَّ الصَّليبيين في مواقع كثيرة. فقد نشأ صلاح الدِّين ، وترعرع مع أبيه نجم الدين أيوب الذي كان خيِّراً ، حسن السيرة ، كثير الإحسان إلى الفقراء ، والصوفية ، والمجالسة لهم. قال ابن كثير: كان شجاعاً ، كثير الصلاة ، وله خانقاه بالدِّيار المصرية ، وله بدمشق خانقاه، وقد رأى ابن خلكان في بعلبك خانقاه للصَّوفية، يُقال لها: النجمية ، وهي منسوبة إليه ، ومدحه بأنه كان كثير الصَّلاح . وكان كثير الصلاح؛ إلا أن التأثير الكبير في أخلاق ، وشخصية صلاح الدين ، جاء من سيِّده نور الدين؛ الذي تعلَّم منه طرائق الخير ، ومحبَّة أهل الله، والاجتهاد في أمور الجهاد ، وقد سار على الدرب نفسه؛ الذي سلكه سلفه ، فقبل أن يشرع بتخليص البلاد من براثن الصليبيين بقي اثنتي عشرة سنة (570 ـ 582هـ) يعمل من أجل تحقيق الوحدة ، وإعداد قوَّة الإسلام المادية ، والروحيَّة ، فزاد من إنشاء الرُّبَط ، والخوانق ، والزوايا ، وجعل منها مدارس عسكريةً، وتربويةً. قال الصفدي: وأربى على نور الدين في جميع ذلك ، وأردف كلامه هذا شعراً:
أحيا الذي قد سنَّ نور الدين
وزاد ما أمكن من تحسين
ويُعدُّ صلاح الدين أوَّل من أدخل مثل هذه المواضع على مصر. قال القلقشندي: وأمَّا الخوانق ، والربط ، فممَّا لم يُعهد بالدِّيار المصرية قبل الدَّولة الأيوبية ، وكان المبتكر لها صلاح الدين بن أيوب. ووافقه في ذلك المقريزي ، والسيوطي ، وغيرهما: إنَّ صلاح الدين أوَّل من أنشأ خانقاه للصَّوفية بمصر ، ووقف عليها أوقافاً كثيرة ، وكان سكَّانها يُعرفون بالعلم ، والصَّلاح ، ووَلَّى مشيختها الأكابر ، ومن تُرجى بركتهم مع ما كان لهم من الوزارة ، والإمارة ، وتدبير الدولة ، وقيادة الجيوش ، وتقدمة العساكر. وقد استرعت هذه الأمور الرَّحالة الأندلسي ابن جبير أثناء رحلته إلى المشرق ، فقال: ومن مناقب هذا البلد (مصر) ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سُلطانه: المدارس ، والمحارس الموضوعة لأهل الطلب والتعبُّد... وهذا السُّلطان الذي سنَّ هذه السنن المحمودة هو صلاح الدين ، المظفر ، وَصَل الله صلاحه ، وتوفيقه.
وكان ـ رحمه الله ـ أينما حلَّ ، ونزل يبني المدارس الشرعية ، الخانقاوات جنباً إلى جنب ، فخلال فتح صلاح الدين القدس سنة (583هـ) أمر المسلمين بالمحافظة على كنيسة القيامة ، وبنى بالقرب منها مدرسة للفقهاء الشَّافعية ، ورباطاً للصُّلحاء الصُّوفية ، ووقف عليها وقوفاً ، وأسدى بذلك على الطائفتين معروفاً. وفي فتحه لعكَّا وقف نصف دار «الإستبار» رباطاً للصُّوفية ، ونصفها مدرسةٌ للفقهاءولا نجد غرابةً من صلاح الدين في فعل مثل هذه الأشياء؛ لا سيما إذا علمنا: أنَّ الفريقين قد رافقوه في معاركه ، وفتوحاته ، ويبرز المؤرخون لنا هذا الحضور ، وخاصَّةً فتح القدس. قال ابن خلكان: وكان فتحه عظيماً ، شهده من أهل العلم خلق ، ومن أرباب الخرق والزهد عالَم.
ويُعزِّز هذا الكلام قول ابن الوردي في تاريخه: وشهد فتحه كثير من أرباب الخرق ، والزهد ، والعلماء في مصر ، والشام؛ بحيث لم يتخلَّف منهم أحد. وقد كان صلاح الدين يصحب معه علماء الصُّوفية؛ لأخذ الرأي ، والمشورة ، فضلاً عن أنَّ وجودهم يُعتبر حافزاً قوياً للمريدين على القتال ببسالة ، وشجاعةٍنادرة. وقد كانت شخصية صلاح الدين محببة لأهل التصوُّف ، فقد سلك طريق الزهد ، كما أنه لم يحفظ ما تجب عليه الزكاة ، ولم يُخلِّف في خزانته إلا سبعاً ، وأربعين درهماً ناصرية وَجِرْماً واحداً ذهباً ، ولم يُخلِّفْ مُلكاً ، ولا داراً ولا عقاراً ، ولا بستاناً ، ولا شيئاً من أنواع الأملاك ، وقِنع من الدنيا في ظلِّ خيمةٍ تهبُّ بها الرياح ميمنةً ، وميسرةً.
وكان صلاح الدين يستوي عنده الذهب ، والمدر (الطين) فقد قال ابن شدَّاد: وسمعت منه في معرض حديث جرى: يُمكن أن يكون في الناس من ينظر إلى المال ، كما ينظر إلى التراب. فكأنه أراد بذلك نفسه. والروايات كثيرة تؤكِّد زهد صلاح الدين ، وتقشُّفه في مأكله ، وملبسه؛ بينما يُغدق كرمه على الفقهاء ، والصُّوفية ، ويوقف القُرى بما تملك من موارد ، وأرباح خدمةً للزَّوايا ، ودور الفقراء. وبنى صلاح الدين الخانات في الأماكن المنقطعة ، البعيدة عن العمران ، وفي الطرق الموصلة بين المدن ، وذلك لخدمة أبناء السبيل ، والمسافرين ، وقد شاهد ابن جبير الخان الذي بناه صلاح الدين في الطريق بين حمص ودمشق ، وكان يسمى بـ: «خان السُّلطان». كذلك بنى الأمير بهاء الدين قراقوش خان السَّبيل.
وقد اهتم صلاح الدين بجذب العلماء ، وكذلك بجذب الصُّوفية ، فأنشأ لهم أول «خانقاه» للصُّوفية في مصر ، وجعلها «برسم الفقراء الصُّوفية الواردين من البلاد الشاسعة» وواقف عليهم أوقافاً جليلةً ، وولَّى عليهم شيخاً يدبر أمورهم ، عرف بشيخ الشيوخ. ويذكر المقريزي: أنَّ سكَّانها من الصُّوفية كانوا معروفين بالعلم، والصلاح، وأنَّ عدد من كان بها بلغ الثلاثمئة، وقد رتب لهم السلطان الخبز ، والحلوى في كلِّ يوم ، وأربعين درهماً في العام ثمن كسوة ، وبنى لهم حماماً بجوارهم، ومن أراد منهم السَّفر أعطى نفقةً تعينه على بلوغ غايته. وهذه العناية بأمور الصُّوفية كانت تستهدف أهدافاً ، منها ما هو متعلِّق بحركة الإحياء السني ، فعلى الرغم من أن التصوُّف المعتدل كان اتجاهاً له احترامه من قبل الحكام ، وعامة الناس في ذلك العصر ، إلا أنَّ الاهتمام به على هذا النحو في مصر بالذات كان عملاً مقصوداً، ويهدف إلى تحقيق غايةٍ معينة.
ولعلَّ السر في هذا هو: أنَّ الفاطميين في مصر قد عجزتْ أساليبهم المتعددة ـ في الدَّعوة إلى مذهبهم ـ عن أن تتسلَّل إلى عقائد معظم المصريين ، لكنَّها بسهولة أثَّرت في عواطفهم ، فمظاهر الحزن ، والبكاء على الحسين ، والاحتفال بمولد أهل البيت ، واحتفاء الفاطميين بهذه الاحتفالات ، وغيرها.. كلُّ ذلك كان له تأثيره في عواطف المصريين؛ وما تزال بقيةٌ من اثاره موجودةٌ إلى اليوم ، وإذا كان صلاح الدين حاول جذب علماء السنة إلى مصر من كلِّ مكان؛ ليشاركوا بعلومهم ، وفكرهم في حركة الإحياء السني؛ فإنَّ هناك جانباً هاماً كان لابد من العمل على إشباعه ، وتحويله من الوجهة التي اتجه بها الفاطميُّون إلى وجهةٍ أخرى ، هذا الجانب هو الجانب العاطفي في النَّاس ، والذي سيطر عليه الفاطميُّون بسهولةٍ ، وكان التصوُّف السني ، وأهله من الفئات القادرة على إشباع هذا الجانب يومها بأخلاقهم السهلة السمحة ، وزهدهم في متاع الدنيا ، وقدرتهم على مخاطبة الناس عن طريق مجالس الوعظ ، والذكر ، وغير ذلك، وقد استطاع صلاح الدين ، ونور الدين من قبله الاستفادة من جموع المتصوِّفة السِّنين في حركة الإحياء السني ، والتصدِّي للتشيُّع ، والغزو الصَّليبي.
يمكنكم تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/66.pdf