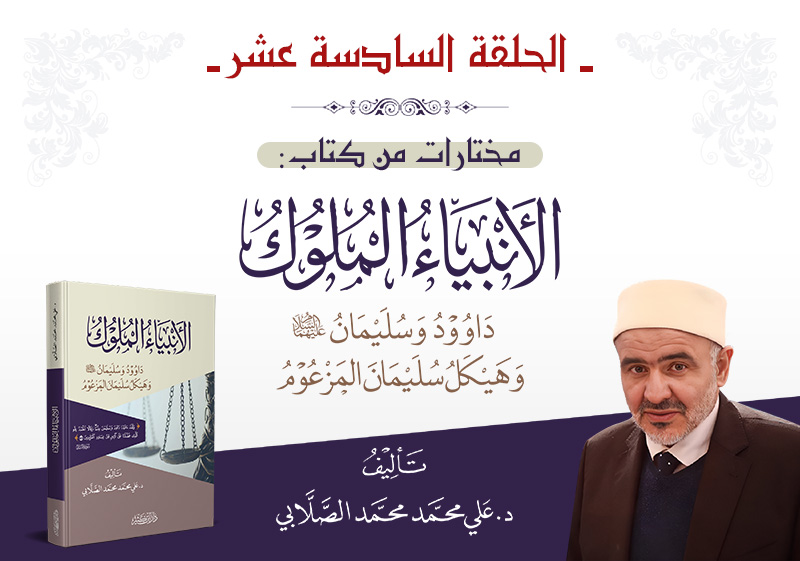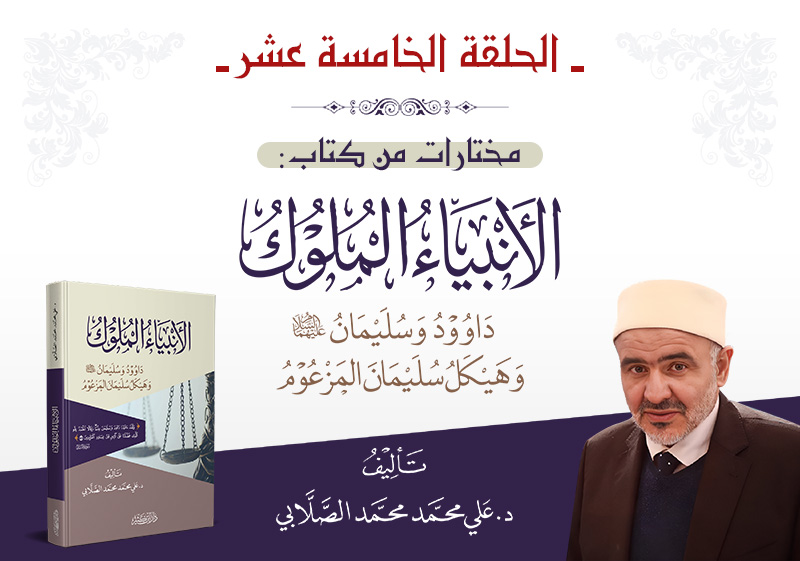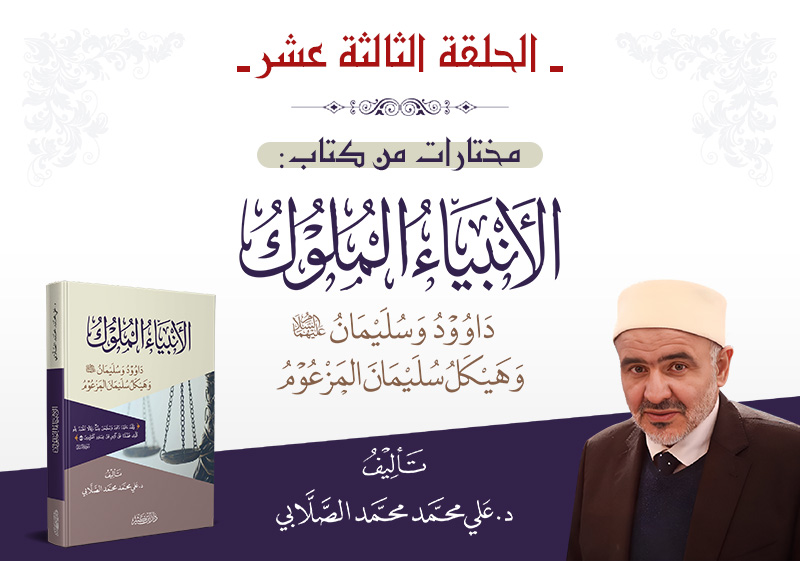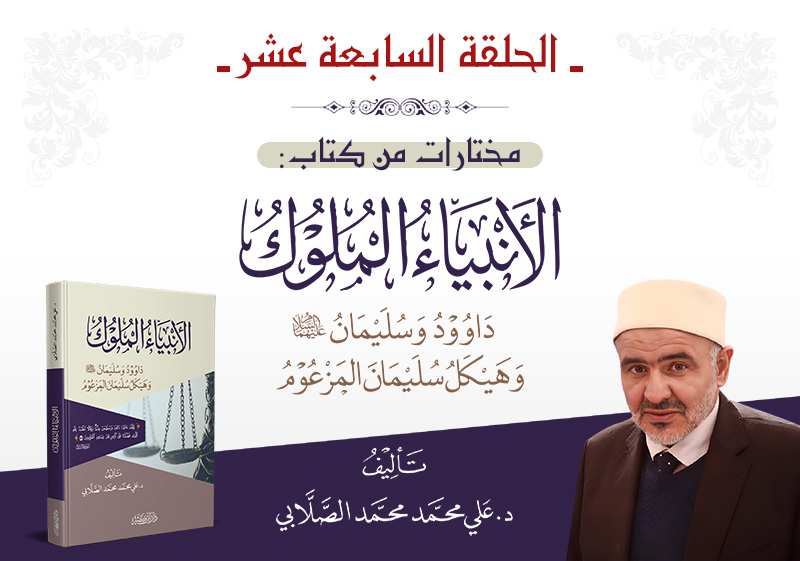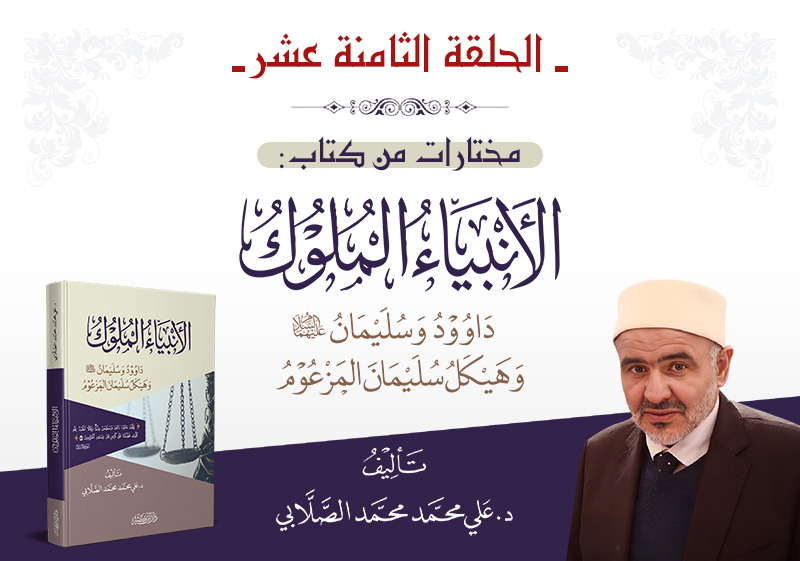من سمات وشروط الحكم الصالح في قصة داوود عليه السلام: (العلم والحكمة)
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك
بقلم د. علي محمد الصلابي
الحلقة (16)
قال الله تعالى: ﴿وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾:
كان داوود ملكاً نبياً، وعلّمه اللهُ صناعةَ الزرد، وعدة الحرب، مما يفصّله القرآن في مواضعه في مواضع قرآنية أخرى. وكان أول من جمع بين الملك والنبوة هو داوود (عليه السلام).
أ- معنى داوود: هو لفظ عربي قديم، هو من (الوداد) و (المودة) و (الرحمة) و (الود)؛ وهو العلاقة التي فيها أخذ وعطاء. و(داوود) بطبيعته لا يظلم، ولا يطغى، إنه مهيّأ من الله ليكون خليفة في الأرض ليحكم بين الناس بالحق، ويهدي إلى سواء السبيل.
ب- قال الشيخ محمد بن عثيمين (رحمه الله): ﴿وَآتَاهُ اللَّهُ﴾ ضمير المفعول به يعود إلى ﴿داوود﴾ أي: أعطاه الله ﴿الْمُلْكَ﴾ فصار ملكاً وأعطاه ﴿الْحِكْمَةَ﴾ فصار رسولاً. واجتمع له ما به صلاح الدين والدنيا، والشرع والإمارة ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ أي: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس عندهم من العلم إلا ما علَّمهم اللهُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾. فالنبي نفسه لا يعلم الغيب، ولا يعلم الشرع إلا ما أتاه الله سبحانه وتعالى، ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيه محمد (ﷺ): ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾.
وفي ﴿عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾؛ إثبات المشيئة لله، ولكن اعلمْ أن مشيئة الله تابعة لحكمته كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)﴾ [الإنسان: 29 - 30].
جـ- قال الشيخ محمد أبو زهرة (رحمه الله): وقد ذكر سبحانه العناصر التي ترشح للسلطان وحكم الناس، فكانت قوة الجسم، والحكمة، والعلم؛ ولذا قال سبحانه بعد ذكر قتله لجالوت: ﴿وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾. والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، والتدبير المحكم على وفق العلم. فالحكمة تقتضي صفتين ذاتيتين في الشخص: عقلا مدركًا نافذًا بصيرًا يرى بواطن الأمور ويتغلغل في أعماقها؛ وإرادة محكمة تجعل العمل يتلاقى مع الفكر الصحيح والإدراك السليم، فلا يكون سلطان يعارض دواعي العقل، وأحكام الفكر السليم. فليس بحكيم من يبادر بالحكم على الأشياء من غير دراسة عميقة مستقصية، وليس بحكيم من يكون عمله على غير ما تقتضيه قواعد الفكر المستقيم.
وذكر سبحانه أنه علَّم داوود علمًا كثيرًا واسعًا مما شاء أن يعلِّمه، فقوله تعالى: ﴿مِمَّا يَشَاءُ﴾ يشير إلى سعة العلم، وأنه كثير متشعب لا تحده إلا مشيئة الله وإرادته.
فعلَّمه الله سبحانه سياسة الملك، وأحوال الناس، ومنازع النفوس، وأحوال البلدان، وما تنتجه من خيرات، وغير ذلك. وكان تعليم الله سبحانه وتعالى له بالنبوة التي أفاضها سبحانه وتعالى عليه، والتجارب التي ساقها الله إليه، والذخيرة التي بين يديها من أحوال الحاكمين السابقين، والهداة المرشدين، وما أوتيه من علم التوراة، والأخبار الصحاح عن النبيين السابقين؛ وفي كل ذلك هداية وإرشاد إلى أقوم مناهج الحكم الصحيح.
إنها عناصر الحكم الصالح، فلا بد أن يكون الحاكم قوياً في جسمه، بحيث لا يخذل جسمُه إرادتَه؛ فكثيراً ما يكون ضعف الإرادة من ضعف الجسم، وضعف التدبير من تخاذل القوى البدنية عن الاحتمال، ولكن قد تكون الإرادة القوية والعزيمة الماضية في جسم ضعيف، وفي هذه الحال قد يستغني عن ذلك العنصر، وذلك إن لم يوجد شخص تتوافر فيه قوة النفس وقوة الجسم معًا، فالاعتبار الأول لقوة النفس، وقوة الجسم خادمة لقوة الإرادة وليست مقصودة لذاتها.
وإن العنصر الثاني هو الحكمة: وهي كما رأيت جعْل العمل يسير مع العقل، فلا تتحكم الأهواء والشهوات، وآفة الحكم الصالح هوى الحاكم، فإن غلبت رغبته عقله غلب الفساد حكمه، فليختبر كل حاكم نفسه، فإن رأى أهواءه هي المسيطرة فليعلم أن الشر قد استحكم، وأنه أولى به ثم أولى أن يعتزل، وإن وجد عقله هو المسيطر فليعلم أن الله أجرى عليه التوفيق.
والعنصر الثالث: الإحاطة التامة بمصالح الناس وأحوالهم: فإن الحكم عمل للمصلحة، وليس سيطرةً وتحكُّمًا، ومَن ظنَّه سيطرة وتحكُّمًا فهو ممن طمس الله بصيرته، وغلبت عليه شهوته، ثم غلبت عليه شقوته.
إن الفرق ما بين الحكم الصالح وغير الصالح دقيق في معناه، وإن كان الأثر كبيرًا في مبناه، فالحكم الصالح: أساسه أن يكون الحكم لمصلحة المحكوم وإجابة لرغبته، والحكم غير الصالح: أساسه أن يكون الحكم تحكماً في المحكوم؛ فمن تحكم في الرعية ولو باسم مصلحتها، فقد سلك سبيل الفساد، لأن التحكم ينبعث من الرغبة في السيطرة، ولو لبس لبوس المصلحة. وكما أن السيطرة تسلط، والتسلط في ذاته فساد يؤدي لا محالة إلى فساد، ويؤدي إلى موت الإرادات في الجماعة، وفي ذلك إضعاف لقوتها.
وأما الحكم المنبعث من إرادة الجماعة التي يقودها لمصلحتها، فهو يؤدي إلى الصلاح لا محالة، وإن تعثر في أخطاء أحيانا؛ لأنه من الخطأ يَتَعلم الناس الصواب، ومن الخط المعوج يُعرف الخط المستقيم.
مراجع الحلقة:
- علي محمد محمد الصلابي، الأنبياء الملوك، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 90-93.
- خالد محمد، أسماء الأنبياء ودلالاتها ومعانيها، نور حوران للنشر والتوزيع، دار العرب للدراسات، ط1، 2016م، ص215.
- محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، القاهرة، دار الفكر العربي، 1987م، ص (2/910).