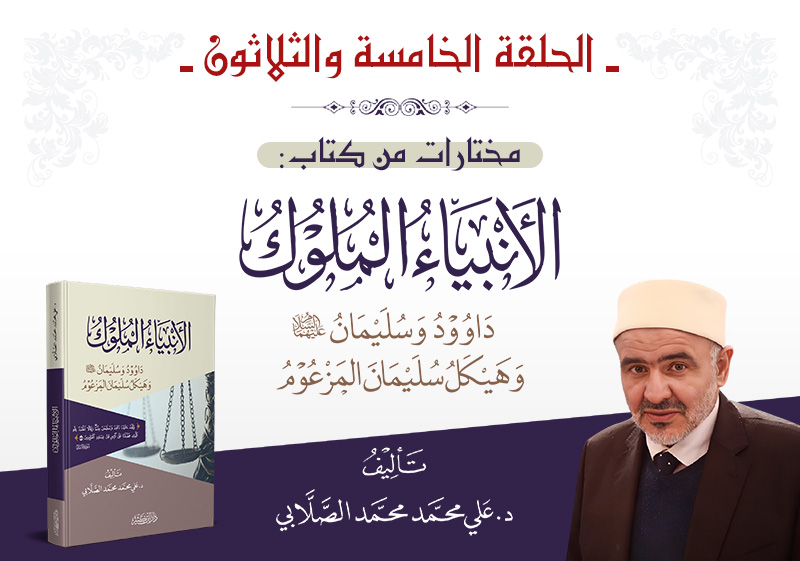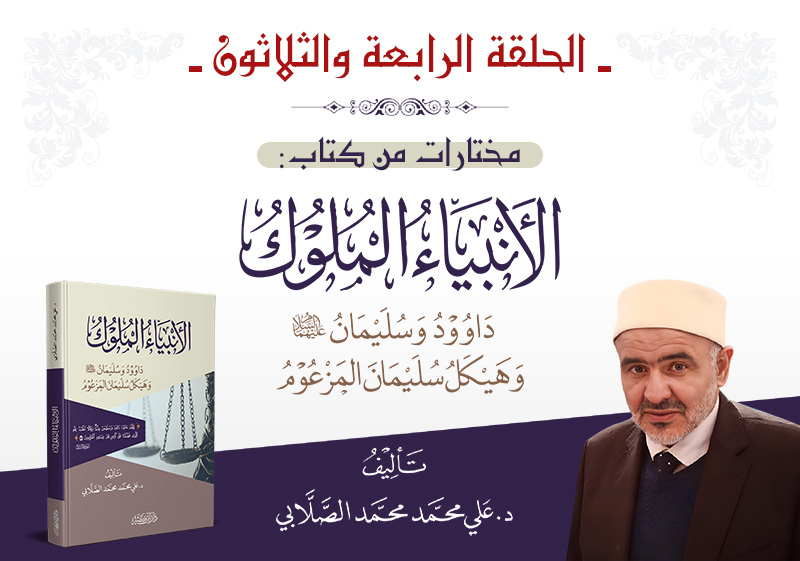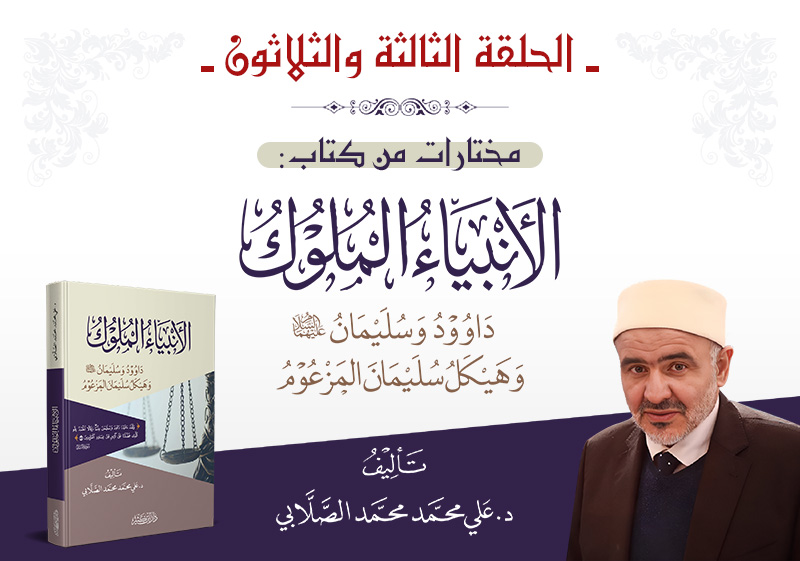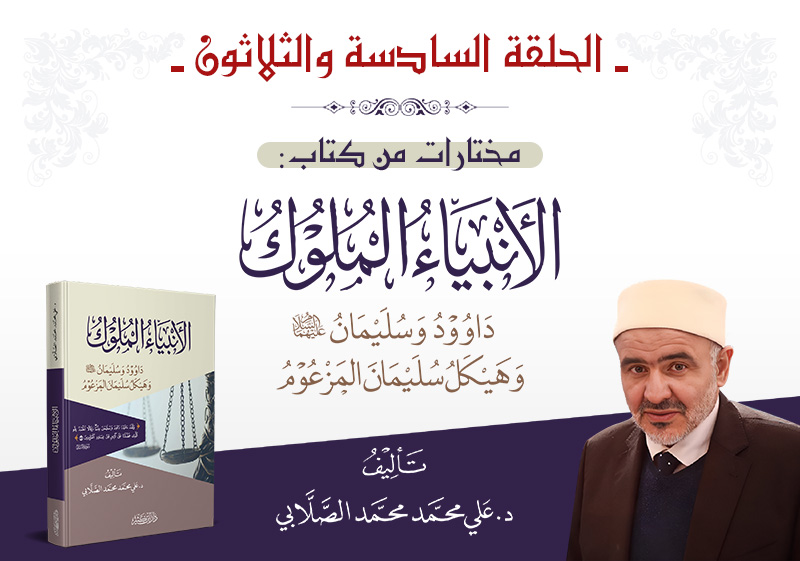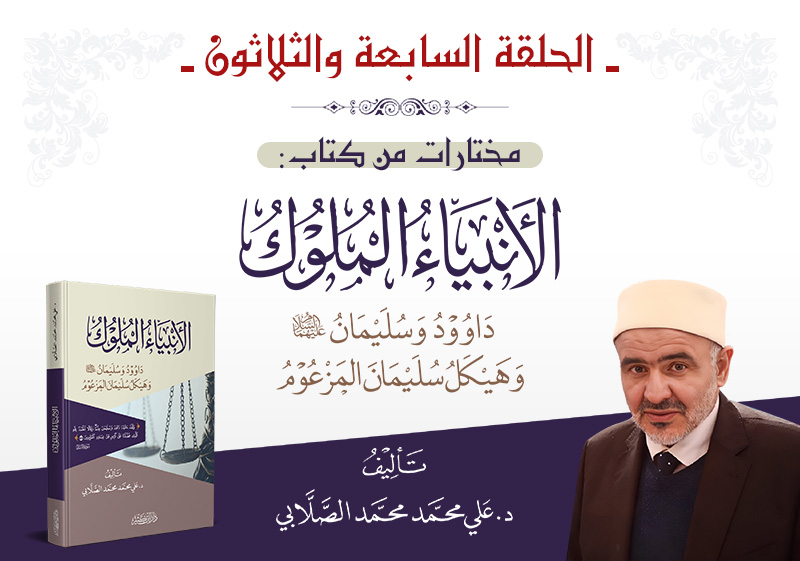تسخير الله تعالى الرياح والشياطين لسليمان (عليه السلام)
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك (عليهم السلام)
بقلم: د. علي محمد الصلابي ...
الحلقة (35)
قال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (40)﴾ [ص: 36 - 40]:
تفسير الآيات الكريمة:
1- ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾:
وكان تسخير الريح لسليمان أول نعمة أضيفت إلى ملكه، لم تكن موجودة من قبل. ومعنى: ﴿رُخَاءً﴾؛ أي: ليّنة ناعمة كالمطية التي تمشي براكبها مشياً هادئاً لا تزعجه، ولا توقعه. إلا أن بعض المفسرين قال: إن كلمة (رخاء) تتعارض مع قوله تعالى في نفس القصة: ﴿ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً﴾، وهذا صحيح، ولكن جاء ذلك في موقف آخر؛ لأن الريح في القصة لها عدة استعمالات، فالريح إن كانت تحمله للنزهة، فهي رخاء ليّنة، وإن كانت لحمل الأشياء فهي عاصفة، إذن: فالجهة في الوصف منفكّة.
- ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾: حيث قصد وأنىّ ذهب. وهذا يعني أن سليمان خاطب الريح التي لا لغة لها لكن فهمه الله، فكأنه أصبح آمراً والريح مأمورة، إذن: فهمتْ عنه الريح. فالحق سبحانه جعل لكل جنس من الأجناس لغته التي يتخاطب بها في بني جنسه، فإذا فهَّم الله إنساناً هذه اللغة، فهمها وتخاطب بها مع هذه الأجناس.
2- ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38)﴾ [ص: 37 - 38]:
سخّرنا له الشياطين، وكان منهم البنّاء، وهو الذي يعمل ويجهد طاقته في يابسة الأرض ويعمرها. والغواص: من يجهد طاقته في البحر ليخرج نفائسه.
- ﴿وَآخَرِينَ﴾؛ أي: من الشياطين: ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾: أي: مقيّدين ومكبّلين بالسلاسل. والأصفاد جمع صفد، وهو السلسلة.
فهؤلاء مقيدون، ليسوا مطلقين كالبنّاء والغوّاص، لكن لماذا قيّد الله هؤلاء، وأطلق هؤلاء؟ قالوا: لأن منهم الصالحين الطائعين، ومنهم العصاة الذين تأبُّوا على منهج الله. ومن الممكن أن يتأبّى أيضاً على رسول الله، وهؤلاء هم الذين يقيدون بالسلاسل، فكأن الصالحين يخدمونه بتوجيه الإيمان، وغير الصالحين يخدمونه بتوجيه القيود والسلاسل، يعني هؤلاء بالرغبة وهؤلاء بالرهبة.
3- ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾:
إن العطاء مناسب لطلب سليمان (عليه السلام) حين طلب ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، قال: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾، فرد الله عليه: ﴿هَٰذَا عَطَآؤُنَا﴾ وما دمت قد وهبت فسوف أجعلك تتصرف فيما وهبته لك لأنني أمَّنتك، ﴿فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾؛ يعني أنت حر في أن تعطي أو تمسك وتمنع.
وإن الحق سبحانه لم يجعل لسليمان (عليه السلام) طلاقة التصرف، إلا لأنه ضمن منه عدالة التصرف؛ لأن سليمان حين طلب الملك الواسع تعهد لله تعالى بهذه العدالة.
إن سليمان (عليه السلام) لم يطلب الملك الواسع ليتنعم به، أو يتباهى به، إنما طلبه ليسخره في خدمة الدعوة إلى الله، ولأنه سيجابه قوّة كانت أعظم القوة في هذا الوقت، ويكفي أن الله تعالى وصف هذه القوة بقوله: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾؛ أي: بلقيس.
وهنا في هذه المواجهة سيظهر أثر الملك وقيمته؛ قال عندما أرسلت بلقيس هديتها: ﴿أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ [النمل: 36]. وهنا تظهر الحكمة في أن سليمان حين طلب ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، طلبه حتى لا يتميّز عليه أحد ولا يحاول أحد أن يغريه، أو يرشيه، أو يستميله بالمال، كما حاولت بلقيس بملكها الواسع في اليمن السعيد في ذلك الوقت.
أ- قال أبو حيان في قوله تعالى: ﴿هَٰذَا عَطَآؤُنَا﴾: إشارة لما أعطاه الله تعالى من الملك الضخم، وتسخير الريح والإنس والجن والطير، وأمره بأن يمنّ على من يشاء ويمسك عن من يشاء، وقفه على قدر النعمة، ثم أباح له التصرف فيها بمشيئته، وهو تعالى قد علم أنه لا يتصرف إلا بطاعة الله.
ب- قال ابن كثير: هذا الذي أعطيناك من الملك التام، والسلطان الكامل كما سألتنا فأعط من شئت واحرم من شئت، فلا حساب عليك، أي: مهما فعلت، فهو جائز لك، احكم بما شئت فهو صواب. وقد ثبت في الصحيحين بأن رسول الله (ﷺ) لما خُيِّر بين أن يكون عبداً رسولاً -وهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره الله به- وبين أن يكون ملكاً نبياً، يُعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح، اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل، فقال له: تواضع؛ فاختار المنزلة الأولى، لأنها أرفع قدرا عند الله، وأعلى منزلة في المعاد، وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والآخرة. ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان في الدنيا نبَّه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا.
4- ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾:
- ﴿لَزُلْفَى﴾: يعني قربى، ودل على هذه القربى أن الله تعالى أعطاه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وأعطاه حريّة التصرف في هذا الملك؛ يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء. وقد أعطاه الله هذا العطاء مقابل أنه علم أنه لن يصرفه في طغيان ولا في جبروت، ولا في إذلال الناس لكن يستعمله في موضعه الذي يريده الله، فأصبح مأموناً على عطاء الله تعالى. ومعنى: ﴿وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ أي: حسن مرجع ومردٍ إلى الله يوم القيامة.
مراجع الحلقة:
- الأنبياء الملوك، علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 181-185.
- تفسير الشعراوي (21/12945-12952).
- تفسير ابن كثير، ت السلامة، (7/74).
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي