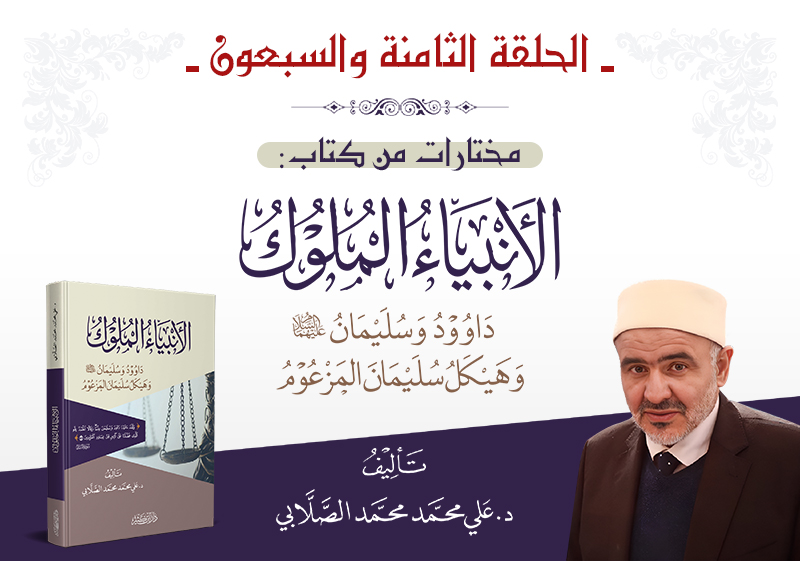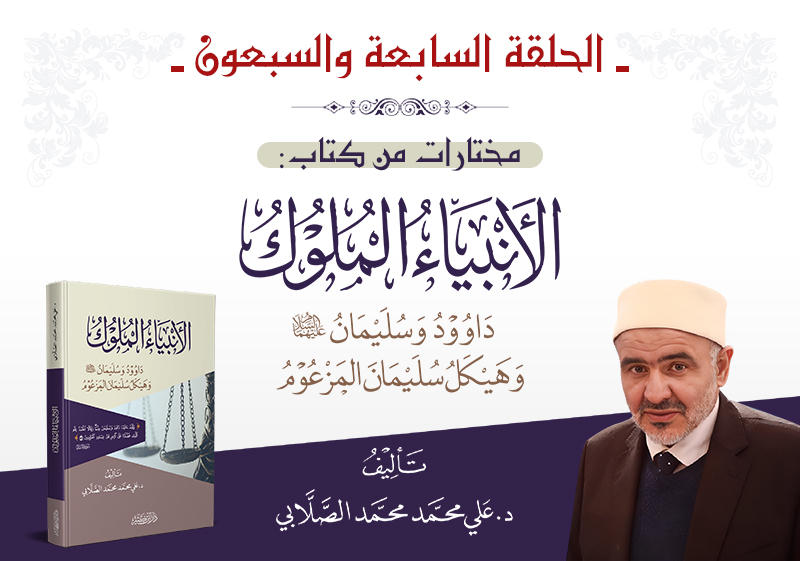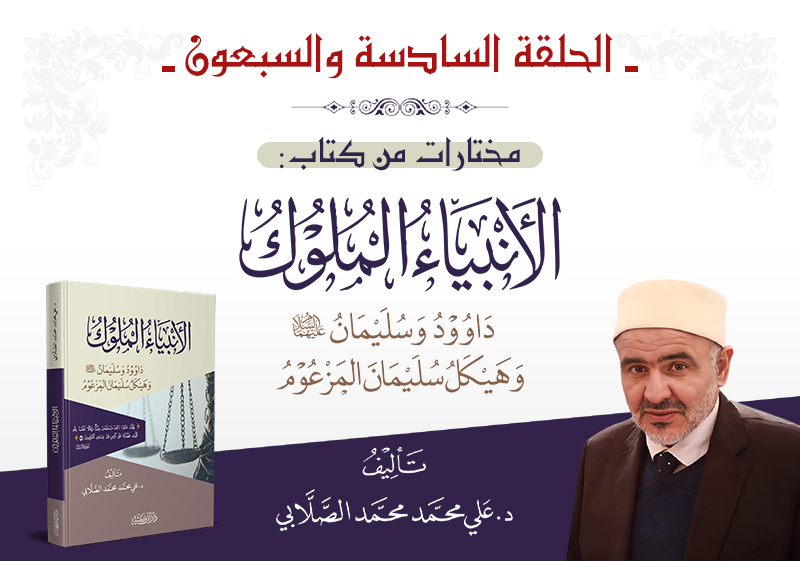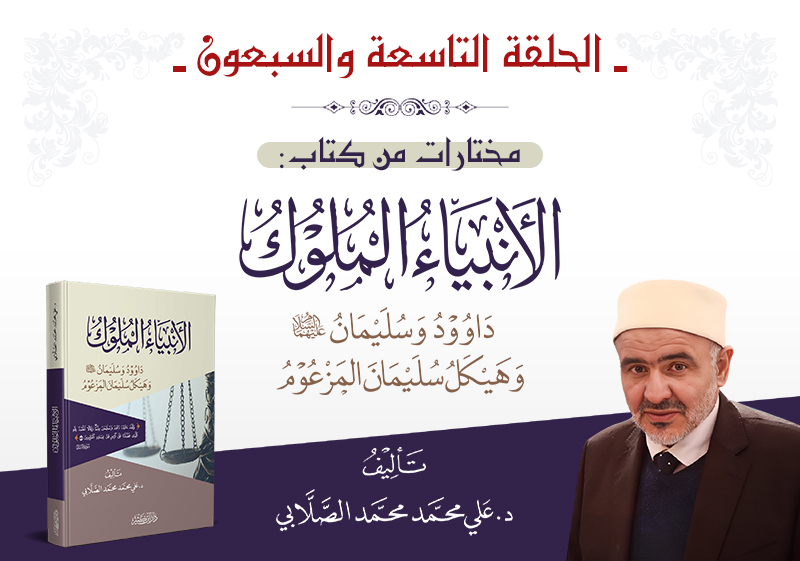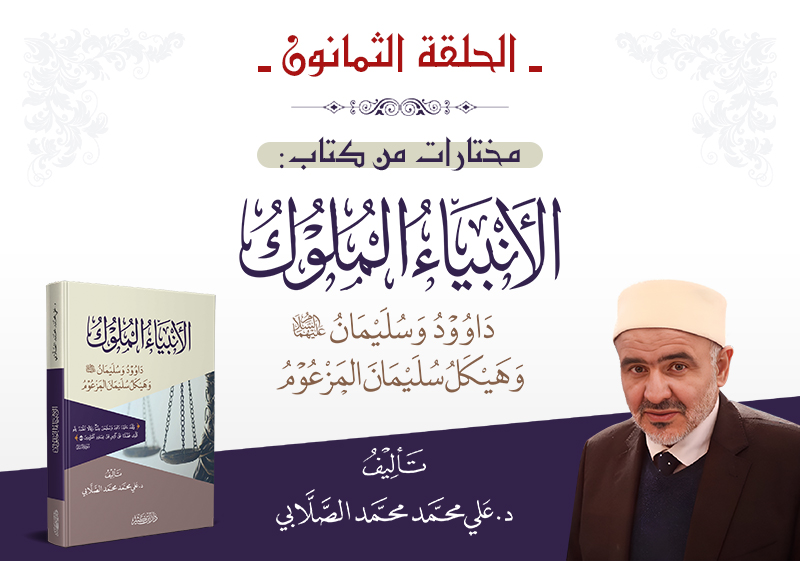﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ..
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك ...
بقلم د. علي محمد الصلابي ...
الحلقة (78)
قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾:
أي: اعملوا بطاعة الله يا آل داوود! شكراً على ما آتاكم، أو اعملوا عملاً يعبّر ويعرب ويترجم عن شكركم لله تعالى. وخصهم بالذكر مع أن الشكر واجب على سائر الخلق؛ لأنهم موضع التآسي والاقتداء ومحل الأنظار.
وإن من سعادة العبد أن يكون شاكراً لله على نعمه الدينيّة والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجل بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكراً كثيراً.
- ﴿آلَ دَاوُودَ﴾: هم أهله الصالحون، وعلى رأسهم سليمان (عليه السلام).
- وكلمة ﴿شُكْرًا﴾: منصوبة. ويجوز فيها أوجه، إحداها: أنه مفعول به؛ أي: اعملوا الطاعة، سميت الصلاة ونحوها شكراً لسدّها مسده.
الثاني: أنه مصدر من معنى: اعملوا، كأنه قيل: اشكروا شكراً بعملكم أو: اعملوا عمل الشكر.
الثالث: إنه مفعول لأجله؛ أي: لأجل الشكر.
الرابع: إنه مصدر وقع موقع الحال؛ أي: شاكرين.
الخامس: أنه صفة للمصدر ﴿اعْمَلُوا﴾ تقديره: اعمل عملاً شكراً؛ أي: ذا شكر.
قال ابن كثير: وفي الآية دليل على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية.
وروي أن داوود (عليه السلام)، قال: كيف أطبق شكرك وأنت الذي تُنعم عليّ ثم ترزقني على نعمة الشكر، فالنعمة منك والشكر منك، فكيف أطبق شكرك؟ فقال جلّ وعلا: يا داوود الآن عرفتني حق معرفتي. ومر معنا قول سليمان (عليه السلام): ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: 40].
وظاهر الآية أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان؛ ولهذا كان نبيّنا محمد ﷺ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لِمَ تَصْنَعُ هذا يا رَسولَ اللَّهِ، وقدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ؟ قالَ: «أفلا أُحِبُّ أنْ أكُونَ عَبْدًا شَكُورًا».
- ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾:
قيل: الشكور هو المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه، وجوارحه أكثرَ أوقاته، ومع ذلك لا يؤدّي حقه؛ لأن توفية الشكر نعمة تستدعي شكراً آخر لا إلى نهاية، ولذا قيل: الشكور من يرعى عجزه عن الشكر.
وقد تحدّث ابن القيم -رحمه الله- عن الشكر، وبيّن أن حقيقته: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه شهودًا ومحبَّةً، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة.
والشُّكر مبنيٌّ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبُّه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره.
فهذه الخمسة هي أساس الشُّكر، وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدةً اختلَّ مِن قواعد الشكر قاعدة. وكلُّ من تكلَّم في الشكر وحدِّه، فكلامه إليها يرجع وعليها يدور.
ولقد أحسن آل داوود وعلى رأسهم سليمان شكر نعم الله عليه، فأورثته تلك النعم مزيدًا من الخضوع لله، وتواضعاً لعباد الله، وشفقة على عيال الله، وأقام مملكة على الشكر لله، والعدل بين خلقه، والإحسان إليهم، وتحكيم شرع الله بين عباد الله تعالى.
إن من أدق تعريفات الشكر: هي أن تستخدم نعمة الصحّة في طاعة الله، ونعمة البصر في رؤية آلاء الله، ونعمة العلم لدعوة الناس إلى الحق، ونعمة اللسان لذكر الله عز وجل، ونعمة السمع في سماع الحق، ونعمة الذكاء لفهم كتاب الله، فكل هذه النِعم والأعطيات التي أكرمك الله بها بإمكانك أن ترقى بها إلى جنان النعيم، والجنة تحتاج إلى عمل.
وإن العمل هو استخدام الحظوظ، فهذا إنسان يرقى إلى الله بإتقان صنعته وهذا يرقى إلى الله بإنفاق ماله، وهذا يرقى بإنتاجه العقلي، وهذا يستخدم قلمه الأدبي في تأليف كتب تدل على الله عز وجل. وليس في الوجود إنسان بلا حظوظ، فهذه نقطة مهمة جدّاً فإذا استخدمت النعم التي أنعم الله بها عليك فيما يرضى الله وفيما خلقت من أجله؛ فهذا أعلى درجات الشكر، أما حينما تستخدم نعم الله عز وجل، فيما يغضبه وفي معاصيه؛ فهذا بعد عن الله.
- ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾: اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل، كما سمع سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هذا الدعاء من رجل يقول: اللهم اجعلني من القليل، فقال له: ما هذا الدعاء؟
فقال: أقصد هذه الآية: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾. فقال عمر: كل الناس أعلم منك يا ابن الخطاب.
وقال الألوسي في قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾: وفيها تنبيه وتحريض على الشكر.
اللهم اجعلنا من القليل الشاكر لا من الكثير الساهي اللاهي عن السبيل.
مراجع الحلقة:
- الأنبياء الملوك، علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 367-371.
- الصراع بين الحق والباطل، العنزي، ص80.
- فوائد قصص نبي الله سليمان، عبد الفتاح محمد، ص50.
- سليمان (عليه السلام) في القرآن، همام حسين يوسف سلوم، ص130.
- تفسير ابن كثير (3/529).
- التفسير الموضوعي (7/18)، البخاري، رقم 4837.
- تفسير البيضاوي (4/395) بتصرف.
- مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية (751ه)، تحقيق: عماد عامر، القاهرة، دار الحديث، 1426ه - 2005م، (2/1444).
- تفسير النابلسي (10/169).
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ، (22/121).
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي:
https://www.alsalabi.com/salabibooksOnePage/689