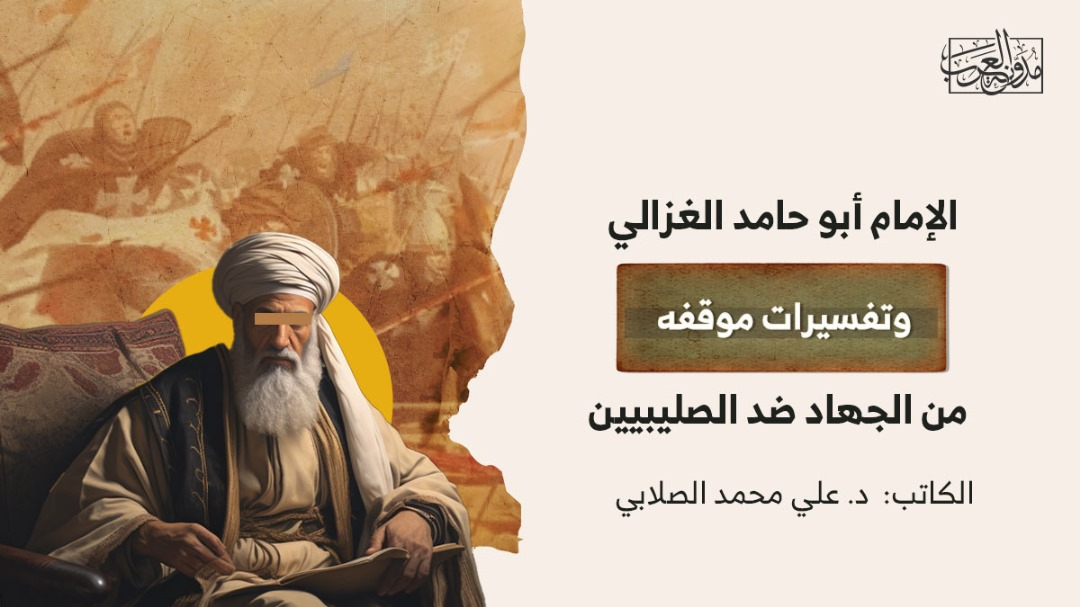الإمام أبو حامد الغزالي وتفسيرات موقفه من الجهاد ضد الصليبيين
د. علي محمد الصلابي
كان الإمام أبو حامد الغزالي من جهابذة العلماء، وأعلام التصوف القويم في التاريخ الإسلامي، وهو من رواد محاربة البِدع والعقائد المنحرفة والأفكار الضالة، وخصوصاً تلك التي دعت لها، وروجتها الفرق والتيارات الباطنية والشّيعية، فكان له فضلٌ كبيرٌ على الإسلام والمسلمين لا يَمحوه تعاقب القرون، حتى لقب بلقبٍ تفرَّد به دون غيره، وهو "حجة الإسلام"، ولكنه رحمه الله كغيره من العلماء والفقهاء لم يَسلم من الانتقاد، وإننا لا نتحدث عن تهجم أعداء الإسلام عليه، فهذا أمر طبيعي، ولكننا نتحدث عن الانتقاد والهجوم الذي تعرض له من بعض أهل العلم والفكر من المسلمين أنفسهم؛ من أصحاب الغيرة على الدين، وممن يُحبون، ويجلون الإمام الغزالي، ويسيرون على منهجه، ويستشهدون بمؤلفاته وأقواله، ولعل أبرز تلك الانتقادات أو التساؤلات هي أن الإمام الغزالي رغم ما كان عليه من سعة العِلم، وقوة الحجة، وصلابة المعتقد، وسلامة المنهج، ورغم زهده، وورعه، وحرصه الشديد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه أعرض بشكل مثير للحيرة والتساؤل عن أيّ ذِكر للجهاد العسكري الإسلامي، والقتال المفروض دينياً ضد الغزاة والمعتدين من أعداء الأمة، لا سيما وأنه رحمه الله عاصر الحروب الصليبية، والهجمة الشرسة التي شنّها الصليبيون على العالم الإسلامي، وما اِرتكبوه من مجازر، وأحدثوه من خراب في مدن وقرى بلاد الشام، فما سر هذا السكوت!؟ وكيف يمكن تفسير تجاهل عالمٍ كبير وإمام فريدٍ كالغزالي عن مثل هذا الحدث الجلل!؟ وكيف يغفل عن الدعوة إلى الجهاد والحديث عنه في ظل تلك الظروف التي كانت الأمة فيها في موضع "جهاد الدفع"!؟
فمع مجيء السلاجقة بدأ الوعي بالجهاد يدبّ من جديد في نفوس المسلمين، ولقد استطاع السلاجقة في الفترة الممتدة من دخولهم بغداد إلى سنة 490 هـ، وهو تاريخ بداية الهجمة الصليبية على الشام، اِسترجاع شمال الشام كله من أيدي البيزنطيين، بل دخلوا آسيا الصغرى، وتمكنوا من أسر الإمبراطور البيزنطي في معركة ملاذكرد الشهيرة، وهو أمر يحدث لأول مرّة في تاريخ الحروب الإسلامية البيزنطية، إلا أنه ابتداء من سنة 490 هـ، ستتخذ هذه الحروب منعرجاً جديداً، إذ ستتحول إلى حرب صليبية، وقد احتل الصليبيون عدداً من بلاد الإسلام لا سيما بيت المقدس، الذي دخلوه غازين، وأسالوا فيه الدماء أنهاراً، وقتلوا من أهله نحو ستين ألفاً، وتفككت الأمة أمام هذه الغارات الوحشية، إلا أننا لم نسمع صوتاً للإمام أبي حامد الغزالي، وهو صاحب الكلمة المسموعة، والصيت المدوي، والبيان المؤثر، والحجة البالغة، ما له لم يتحدث عن الجهاد؟! وما له لا يحرك الجماهير كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية من بعده!؟ والحق أن هذا موقف محير من الإمام أبو حامد (رحمه الله)، ومثله لا يجهل ما يجب أن يُقال، وما يجب أن يعمل في زمن الإغارة على أهل الإسلام، وقد سجل حكم الجهاد في مثل هذه الحالة، وأنه فرض عين في كتبه الفقهية، وربما يُقال: إن هذه الأحداث الكبيرة إنما برزت، وتفاقمت في العالم الإسلامي في نفس الوقت الذي اِتجه فيه الغزالي إلى حياة العزلة والتصوف سنة 488هـ، وهجر الدنيا بما فيها من صراع البقاءِ أو صراع الفناء، فكان محور تفكيره حينذاك إنقاذ نفسه من النار، ونقلها من المهلكات إلى المنجيات، فقد غزا الصليبيون أنطاكيا سنة 491هـ، ومن ثم معرة النعمان في الشهر الأخير من تلك السنة حتى قالوا: إنهم قتلوا فيها مئة ألف، ثم اجتاحوا البلاد كلها يقتلون ويدمرون، واقتحموا القدس سنة 492 هـ، وذبحوا من ذبحوا مما يذكره التاريخ ولا ينساه، وكان الغزالي لا يزال في عزلته، إذ لم يفارقها إلا في سنة 499 هـ، ولكنه بعد ترك العزلة والعودة إلى حياة الإفادة والتدريس والدعوة لم يَبدُ منه ما يدل على عنايته بهذا الأمر الذي يتعلق بمصير الأمة وسيادتها.
وقد حاول الكثير من العلماء والمفكرين المسلمين تفسير ذلك الموقف من الإمام أبو حامد الغزالي، ومن آراء بعض المعاصرين في سكوت الغزالي عن الحروب الصليبية:
- الدكتور زكي مبارك: يعتبر الدكتور زكي مبارك أحد أبرز النقاد المعاصرين الذين كتبوا عن الشيخ الغزالي، وله كتاب (الأخلاق عند الغزالي) الذي تعرض فيه لمسائل كثيرة عنه، وقد وقف وقفة قصيرة عند الغزالي، والحروب الصليبية، إذ قال فيها: أتدري لماذا ذكرت لك هذه الكلمة عن الحروب الصليبية؟ لتعرف أنه بينما كان بطرس الناسك يقضي ليله ونهاره في إعداد الخطب وتحبير الرسائل لحث أهل أوروبا على امتلاك أقطار المسلمين، كان الغزالي (حجة الإسلام) غارقاً في خلوته، منكباً على أوراده، لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة والجهاد.
- الدكتور عمر فروخ: التمس العذر في سكوت الإمام الغزالي عما جرى في القدس، قائلاً : كان الصوفية يعتقدون بأن الحروب الصليبية كانت عقاباً للمسلمين على ما سلف لهم من الذنوب والمعاصي، ولعل الغزالي قد شارك سائر الصوفية في هذا الاعتقاد.
ولعله من غير الصحيح تعميم القول بأن الصوفية لا يُشاركون في الجهاد، بل مشاركة كثير من الصوفية في حركة الجهاد ضد الصليبيين أثبتته الحقائق التاريخية في عهد السلاجقة والزنكيين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، وفي العصر الحديث هناك الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد حركة الجهاد الأولى ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان من كبار المتصوفة، وكذلك السنوسيون في ليبيا، وعلى رأسهم محمد المهدي السنوسي الذي مات مرابطاً في أحد الثغور أثناء قتاله لفرنسا في تشاد، وأحمد الشريف السنوسي، وعمر المختار من زعماء حركة الجهاد في ليبيا كانوا من الصوفية، كما شارك بعض الصوفية في الجهاد حالياً ضد الغزو الأمريكي للعراق، فالقول بأن الصوفية لا تشترك في الجهاد إطلاقاً على العموم غير صحيح.
وتحقيق المسألة هو أن من يقوم بالجهاد من الصوفية هم أتباع التصوف السني، والذي يقوم على أصول أهل السنة عقيدة ومنهجاً، مع الإكثار من العبادة والذِكر والزهد، وقد لا يخلو الأمر من بعض الأخطاء. أما التصوف المنحرف القائم على الاستغاثة بالموتى والغلو في الأشخاص، وترويج البدع والتواكل، وبث الروح الانهزامية، فهم عادة مطية للاستعمار والغزاة، ونجد للدكتور فروخ رأياً آخر في كتابه (التصوف في الإسلام) يقول فيه: ألا يعجب القارئ إذا علم أن حجة الإسلام - أبا حامد - الذي وقف بنفسه وعِلمه في خدمة الدين لحفظ الإيمان على العامة، شهد القدس تسقط في أيدي الإفرنج الصليبيين، وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك، ولم يُشر إلى هذا الحادث العظيم!؟
- العلامة الإمام الشيخ يوسف القرضاوي: حيث قال: والحق أن هذا الموقف محير من أبي حامد ـ رحمه الله ـ ومثله لا يجهل ما يجب أن يُقال... إلى أن قال: .. ولعل عذر الإمام الجليل أن شغله الشاغل كان الإصلاح من الداخل أولاً، وأن الفساد الداخلي هو الذي يمهد للغزو الخارجي، كما تدل على ذلك أوائل سورة الإسراء، فإن بني إسرائيل كلما أفسدوا في الأرض سلط عليهم عدوهم، وكلما أحسنوا، وأصلحوا ردت لهم الكرة عليهم، وقد وجه أكبر همه إلى إصلاح الفرد الذي هو نواة المجتمع، وإصلاح الفرد إنما يكون بإصلاح قلبه وفِكره، وبذلك يصلح عمله وسلوكه، وتصلح حياته كلها، وهذا هو أساس التغيير الاجتماعي، وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11]. ويدخل في ذلك إصلاح الحكام بحسن توجيههم، ونصحهم، والله أعلم بحقيقة عُذره.
- رأي الدكتور ماجد عرسان الكيلاني، حيث قال: ".. بالنسبة لموضوع الجهاد؛ يلاحَظ أن الغزالي تناول محتواه، واسمه ضمن موضوع (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ حيث اعتبره في أكثر من موضع أحد أشكال الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ مثل قوله: أفلا ينبغي أن يُبالي بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله، ودفع معاصيه. ونحن نجوز للأحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويُقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر، فكذلك قمع أهل الفساد جائز ؛ لأن الكافر لا بأس بقتله، والمسلم إن قُتل فهو شهيد، فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله، والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد، وكذلك قوله: الشرط الخامس (من شروط المحتسب): كونه قادراً، ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبه إلا بقلبه، إذ كل من أحب الله يكره معاصيه، وينكرها. وقال ابن مسعود (رضي الله عنه): جاهدوا الكفار بأيديكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا. وكذلك قوله: فنقول: وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر؟ فإن قالوا: لا، خرقوا الإجماع؛ إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتام، ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر رسول الله (ص) ولا بعده ...
ويضيف الكيلاني: إن الذي يبدو من معالجة الإمام أبو حامد الغزالي للقضايا الاجتماعية المختلفة أن موقفه من الجهاد اتصف بصفتين اثنتين، وهما:
- الصفة الأولى: إن مفهوم الجهاد عند الشيخ الغزالي ليس دفاعاً عن أقوام وأوطان وممتلكات، بل هو وسيلة لحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي السبب الحقيقي لإخراج الأمة المسلمة إلى الوجود، وما دام المجتمع الذي عاصره الغزالي قد توقف عن حمل هذه الرسالة، وفسح للمنكر أن يشيع فيه، واستساغت أذواقه هذا المنكر ...، وانتهت جماهيره عند الملبس والمأكل والمنكح كما وصفهم المؤرخ أبو شامة، فإن أيَّة دعوة للجهاد العسكري لن تكون لها فائدة؛ إلا إذا سبقه جهاد نفسي يبدل ما بأنفس القوم، ويجعلهم يتذوقون معنى التضحية بالأنفس والأموال في سبيل الله.
- الصفة الثانية: إن الشيخ الغزالي كان واعياً لمفهوم الجهاد الشامل، والمراحل التي تُطبق فيها مظاهره. فالجهاد له مظاهر ثلاث هي: الجهاد التربوي، والجهاد التنظيمي، والجهاد العسكري. والفهم الصائب لهذه المظاهر الثلاثة، وحسن ترتيبها، وتوقيتها هو أحد مظاهر الحكمة التي جعلها الله أولى طرق الدعوة إليه حين قال: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
فالدعوة إلى الجهاد العسكري، وندب العامة له في أمة متوفاة يدور فيها (الأفكار والأشخاص) في فلك (الأشياء)، سيكونون بمثابة الأموات الذين في القبور. حيث قال: ... لعل هذا الاستعراض يتضمن الجواب عن الاعتراض الذي يتهم الغزالي بالعزلة عن قضايا العالم الإسلامي .. ولعل الميادين الأربعة التالية التي تضمنتها ميادين الإصلاح عند الغزالي دليل واضح على أن الرجل اختار البدء بالجهاد التربوي في أمة ضربها الخور والتثاقل، وشاع فيها التنكر للقيم الإسلامية تمهيداً لإخراج (الحكماء السياسيين والعسكريين) الذين يقودون الجهاد التنظيمي والعسكري الذي يرفع لواء الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله، وهذه الميادين هي: نقد السلاطين الظلمة، ومحاربة المادية الجارفة، والدعوة للعدالة الاجتماعية، ومحاربة التيارات الفكرية المنحرفة.
المصادر والمراجع:
- إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، (2/309).
- الأخلاق عند الغزالي، زكي مبارك، ص 25.
- الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه، يوسف القرضاوي، ص 154 – 156.
- الإمام الغزالي، علي محمد الصلابي، ص 110-116.
- التصوف في الإسلام، عمر فروخ، ص 9.
- الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة ، ص 76.
- سير أعلام النبلاء، الذهبي، (19/339).
- هكذا ظهر جيل صلاح الدين، ماجد عرسان الكيلاني، ص 144 – 146.
الإمام أبو حامد الغزالي وتفسيرات موقفه من الجهاد ضد الصليبيين
د. علي محمد الصلابي
كان الإمام أبو حامد الغزالي من جهابذة العلماء، وأعلام التصوف القويم في التاريخ الإسلامي، وهو من رواد محاربة البِدع والعقائد المنحرفة والأفكار الضالة، وخصوصاً تلك التي دعت لها، وروجتها الفرق والتيارات الباطنية والشّيعية، فكان له فضلٌ كبيرٌ على الإسلام والمسلمين لا يَمحوه تعاقب القرون، حتى لقب بلقبٍ تفرَّد به دون غيره، وهو "حجة الإسلام"، ولكنه رحمه الله كغيره من العلماء والفقهاء لم يَسلم من الانتقاد، وإننا لا نتحدث عن تهجم أعداء الإسلام عليه، فهذا أمر طبيعي، ولكننا نتحدث عن الانتقاد والهجوم الذي تعرض له من بعض أهل العلم والفكر من المسلمين أنفسهم؛ من أصحاب الغيرة على الدين، وممن يُحبون، ويجلون الإمام الغزالي، ويسيرون على منهجه، ويستشهدون بمؤلفاته وأقواله، ولعل أبرز تلك الانتقادات أو التساؤلات هي أن الإمام الغزالي رغم ما كان عليه من سعة العِلم، وقوة الحجة، وصلابة المعتقد، وسلامة المنهج، ورغم زهده، وورعه، وحرصه الشديد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه أعرض بشكل مثير للحيرة والتساؤل عن أيّ ذِكر للجهاد العسكري الإسلامي، والقتال المفروض دينياً ضد الغزاة والمعتدين من أعداء الأمة، لا سيما وأنه رحمه الله عاصر الحروب الصليبية، والهجمة الشرسة التي شنّها الصليبيون على العالم الإسلامي، وما اِرتكبوه من مجازر، وأحدثوه من خراب في مدن وقرى بلاد الشام، فما سر هذا السكوت!؟ وكيف يمكن تفسير تجاهل عالمٍ كبير وإمام فريدٍ كالغزالي عن مثل هذا الحدث الجلل!؟ وكيف يغفل عن الدعوة إلى الجهاد والحديث عنه في ظل تلك الظروف التي كانت الأمة فيها في موضع "جهاد الدفع"!؟
فمع مجيء السلاجقة بدأ الوعي بالجهاد يدبّ من جديد في نفوس المسلمين، ولقد استطاع السلاجقة في الفترة الممتدة من دخولهم بغداد إلى سنة 490 هـ، وهو تاريخ بداية الهجمة الصليبية على الشام، اِسترجاع شمال الشام كله من أيدي البيزنطيين، بل دخلوا آسيا الصغرى، وتمكنوا من أسر الإمبراطور البيزنطي في معركة ملاذكرد الشهيرة، وهو أمر يحدث لأول مرّة في تاريخ الحروب الإسلامية البيزنطية، إلا أنه ابتداء من سنة 490 هـ، ستتخذ هذه الحروب منعرجاً جديداً، إذ ستتحول إلى حرب صليبية، وقد احتل الصليبيون عدداً من بلاد الإسلام لا سيما بيت المقدس، الذي دخلوه غازين، وأسالوا فيه الدماء أنهاراً، وقتلوا من أهله نحو ستين ألفاً، وتفككت الأمة أمام هذه الغارات الوحشية، إلا أننا لم نسمع صوتاً للإمام أبي حامد الغزالي، وهو صاحب الكلمة المسموعة، والصيت المدوي، والبيان المؤثر، والحجة البالغة، ما له لم يتحدث عن الجهاد؟! وما له لا يحرك الجماهير كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية من بعده!؟ والحق أن هذا موقف محير من الإمام أبو حامد (رحمه الله)، ومثله لا يجهل ما يجب أن يُقال، وما يجب أن يعمل في زمن الإغارة على أهل الإسلام، وقد سجل حكم الجهاد في مثل هذه الحالة، وأنه فرض عين في كتبه الفقهية، وربما يُقال: إن هذه الأحداث الكبيرة إنما برزت، وتفاقمت في العالم الإسلامي في نفس الوقت الذي اِتجه فيه الغزالي إلى حياة العزلة والتصوف سنة 488هـ، وهجر الدنيا بما فيها من صراع البقاءِ أو صراع الفناء، فكان محور تفكيره حينذاك إنقاذ نفسه من النار، ونقلها من المهلكات إلى المنجيات، فقد غزا الصليبيون أنطاكيا سنة 491هـ، ومن ثم معرة النعمان في الشهر الأخير من تلك السنة حتى قالوا: إنهم قتلوا فيها مئة ألف، ثم اجتاحوا البلاد كلها يقتلون ويدمرون، واقتحموا القدس سنة 492 هـ، وذبحوا من ذبحوا مما يذكره التاريخ ولا ينساه، وكان الغزالي لا يزال في عزلته، إذ لم يفارقها إلا في سنة 499 هـ، ولكنه بعد ترك العزلة والعودة إلى حياة الإفادة والتدريس والدعوة لم يَبدُ منه ما يدل على عنايته بهذا الأمر الذي يتعلق بمصير الأمة وسيادتها.
وقد حاول الكثير من العلماء والمفكرين المسلمين تفسير ذلك الموقف من الإمام أبو حامد الغزالي، ومن آراء بعض المعاصرين في سكوت الغزالي عن الحروب الصليبية:
- الدكتور زكي مبارك: يعتبر الدكتور زكي مبارك أحد أبرز النقاد المعاصرين الذين كتبوا عن الشيخ الغزالي، وله كتاب (الأخلاق عند الغزالي) الذي تعرض فيه لمسائل كثيرة عنه، وقد وقف وقفة قصيرة عند الغزالي، والحروب الصليبية، إذ قال فيها: أتدري لماذا ذكرت لك هذه الكلمة عن الحروب الصليبية؟ لتعرف أنه بينما كان بطرس الناسك يقضي ليله ونهاره في إعداد الخطب وتحبير الرسائل لحث أهل أوروبا على امتلاك أقطار المسلمين، كان الغزالي (حجة الإسلام) غارقاً في خلوته، منكباً على أوراده، لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة والجهاد.
- الدكتور عمر فروخ: التمس العذر في سكوت الإمام الغزالي عما جرى في القدس، قائلاً : كان الصوفية يعتقدون بأن الحروب الصليبية كانت عقاباً للمسلمين على ما سلف لهم من الذنوب والمعاصي، ولعل الغزالي قد شارك سائر الصوفية في هذا الاعتقاد.
ولعله من غير الصحيح تعميم القول بأن الصوفية لا يُشاركون في الجهاد، بل مشاركة كثير من الصوفية في حركة الجهاد ضد الصليبيين أثبتته الحقائق التاريخية في عهد السلاجقة والزنكيين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، وفي العصر الحديث هناك الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد حركة الجهاد الأولى ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان من كبار المتصوفة، وكذلك السنوسيون في ليبيا، وعلى رأسهم محمد المهدي السنوسي الذي مات مرابطاً في أحد الثغور أثناء قتاله لفرنسا في تشاد، وأحمد الشريف السنوسي، وعمر المختار من زعماء حركة الجهاد في ليبيا كانوا من الصوفية، كما شارك بعض الصوفية في الجهاد حالياً ضد الغزو الأمريكي للعراق، فالقول بأن الصوفية لا تشترك في الجهاد إطلاقاً على العموم غير صحيح.
وتحقيق المسألة هو أن من يقوم بالجهاد من الصوفية هم أتباع التصوف السني، والذي يقوم على أصول أهل السنة عقيدة ومنهجاً، مع الإكثار من العبادة والذِكر والزهد، وقد لا يخلو الأمر من بعض الأخطاء. أما التصوف المنحرف القائم على الاستغاثة بالموتى والغلو في الأشخاص، وترويج البدع والتواكل، وبث الروح الانهزامية، فهم عادة مطية للاستعمار والغزاة، ونجد للدكتور فروخ رأياً آخر في كتابه (التصوف في الإسلام) يقول فيه: ألا يعجب القارئ إذا علم أن حجة الإسلام - أبا حامد - الذي وقف بنفسه وعِلمه في خدمة الدين لحفظ الإيمان على العامة، شهد القدس تسقط في أيدي الإفرنج الصليبيين، وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك، ولم يُشر إلى هذا الحادث العظيم!؟
- العلامة الإمام الشيخ يوسف القرضاوي: حيث قال: والحق أن هذا الموقف محير من أبي حامد ـ رحمه الله ـ ومثله لا يجهل ما يجب أن يُقال... إلى أن قال: .. ولعل عذر الإمام الجليل أن شغله الشاغل كان الإصلاح من الداخل أولاً، وأن الفساد الداخلي هو الذي يمهد للغزو الخارجي، كما تدل على ذلك أوائل سورة الإسراء، فإن بني إسرائيل كلما أفسدوا في الأرض سلط عليهم عدوهم، وكلما أحسنوا، وأصلحوا ردت لهم الكرة عليهم، وقد وجه أكبر همه إلى إصلاح الفرد الذي هو نواة المجتمع، وإصلاح الفرد إنما يكون بإصلاح قلبه وفِكره، وبذلك يصلح عمله وسلوكه، وتصلح حياته كلها، وهذا هو أساس التغيير الاجتماعي، وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11]. ويدخل في ذلك إصلاح الحكام بحسن توجيههم، ونصحهم، والله أعلم بحقيقة عُذره.
- رأي الدكتور ماجد عرسان الكيلاني، حيث قال: ".. بالنسبة لموضوع الجهاد؛ يلاحَظ أن الغزالي تناول محتواه، واسمه ضمن موضوع (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ حيث اعتبره في أكثر من موضع أحد أشكال الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ مثل قوله: أفلا ينبغي أن يُبالي بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله، ودفع معاصيه. ونحن نجوز للأحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويُقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر، فكذلك قمع أهل الفساد جائز ؛ لأن الكافر لا بأس بقتله، والمسلم إن قُتل فهو شهيد، فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله، والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد، وكذلك قوله: الشرط الخامس (من شروط المحتسب): كونه قادراً، ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبه إلا بقلبه، إذ كل من أحب الله يكره معاصيه، وينكرها. وقال ابن مسعود (رضي الله عنه): جاهدوا الكفار بأيديكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا. وكذلك قوله: فنقول: وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر؟ فإن قالوا: لا، خرقوا الإجماع؛ إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتام، ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر رسول الله (ص) ولا بعده ...
ويضيف الكيلاني: إن الذي يبدو من معالجة الإمام أبو حامد الغزالي للقضايا الاجتماعية المختلفة أن موقفه من الجهاد اتصف بصفتين اثنتين، وهما:
- الصفة الأولى: إن مفهوم الجهاد عند الشيخ الغزالي ليس دفاعاً عن أقوام وأوطان وممتلكات، بل هو وسيلة لحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي السبب الحقيقي لإخراج الأمة المسلمة إلى الوجود، وما دام المجتمع الذي عاصره الغزالي قد توقف عن حمل هذه الرسالة، وفسح للمنكر أن يشيع فيه، واستساغت أذواقه هذا المنكر ...، وانتهت جماهيره عند الملبس والمأكل والمنكح كما وصفهم المؤرخ أبو شامة، فإن أيَّة دعوة للجهاد العسكري لن تكون لها فائدة؛ إلا إذا سبقه جهاد نفسي يبدل ما بأنفس القوم، ويجعلهم يتذوقون معنى التضحية بالأنفس والأموال في سبيل الله.
- الصفة الثانية: إن الشيخ الغزالي كان واعياً لمفهوم الجهاد الشامل، والمراحل التي تُطبق فيها مظاهره. فالجهاد له مظاهر ثلاث هي: الجهاد التربوي، والجهاد التنظيمي، والجهاد العسكري. والفهم الصائب لهذه المظاهر الثلاثة، وحسن ترتيبها، وتوقيتها هو أحد مظاهر الحكمة التي جعلها الله أولى طرق الدعوة إليه حين قال: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
فالدعوة إلى الجهاد العسكري، وندب العامة له في أمة متوفاة يدور فيها (الأفكار والأشخاص) في فلك (الأشياء)، سيكونون بمثابة الأموات الذين في القبور. حيث قال: ... لعل هذا الاستعراض يتضمن الجواب عن الاعتراض الذي يتهم الغزالي بالعزلة عن قضايا العالم الإسلامي .. ولعل الميادين الأربعة التالية التي تضمنتها ميادين الإصلاح عند الغزالي دليل واضح على أن الرجل اختار البدء بالجهاد التربوي في أمة ضربها الخور والتثاقل، وشاع فيها التنكر للقيم الإسلامية تمهيداً لإخراج (الحكماء السياسيين والعسكريين) الذين يقودون الجهاد التنظيمي والعسكري الذي يرفع لواء الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله، وهذه الميادين هي: نقد السلاطين الظلمة، ومحاربة المادية الجارفة، والدعوة للعدالة الاجتماعية، ومحاربة التيارات الفكرية المنحرفة.
المصادر والمراجع:
- إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، (2/309).
- الأخلاق عند الغزالي، زكي مبارك، ص 25.
- الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه، يوسف القرضاوي، ص 154 – 156.
- الإمام الغزالي، علي محمد الصلابي، ص 110-116.
- التصوف في الإسلام، عمر فروخ، ص 9.
- الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة ، ص 76.
- سير أعلام النبلاء، الذهبي، (19/339).
- هكذا ظهر جيل صلاح الدين، ماجد عرسان الكيلاني، ص 144 – 146.