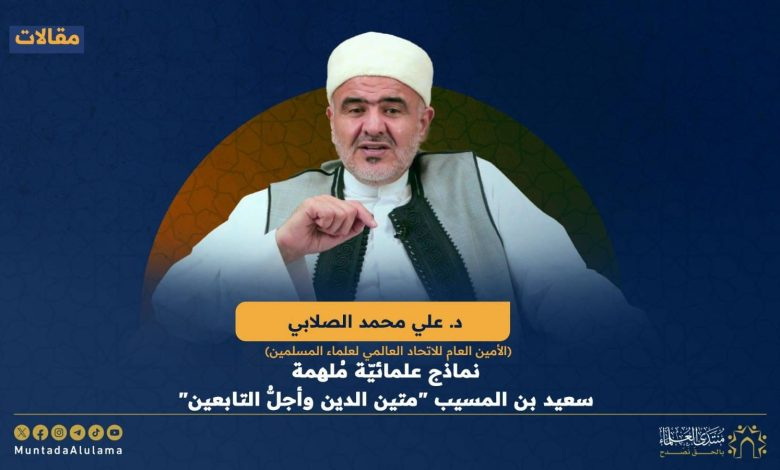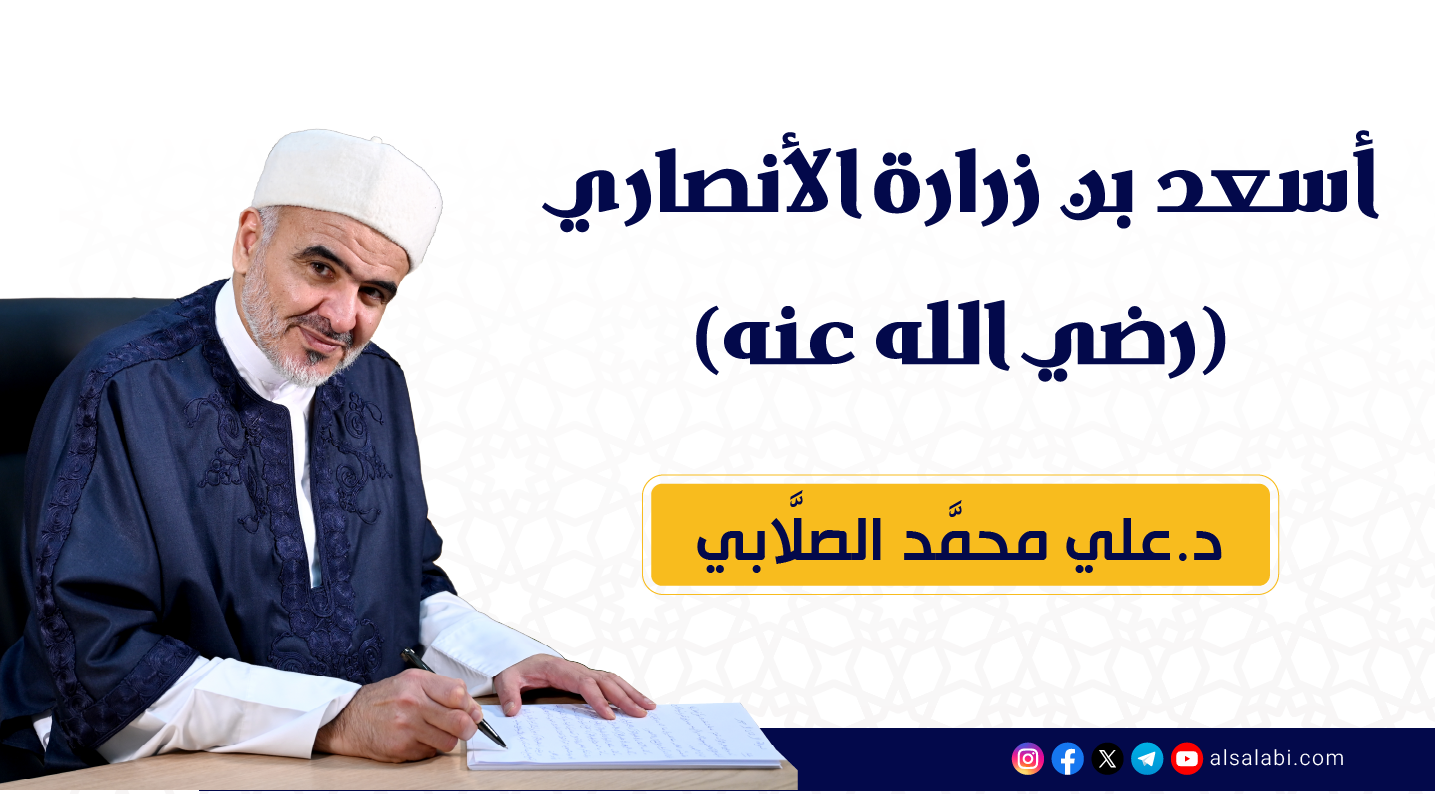التمكين والشهود الحضاري الإسلامي (45)
" سريَّة مؤتة .. فن القيادة "
بقلم: د. علي محمد الصَّلابي
تُعَدُّ غزوة مؤتة من أهمِّ المعارك الَّتي وقعت بين المسلمين والنَّصارى الصَّليبيِّين من عربٍ وعجمٍ؛ لأنَّها أوَّل صدامٍ مسلَّحٍ ذي بالٍ بين الفريقين، وأثَّرت تلك المعركة على مستقبل الدَّولة الرُّومانيَّة، فقد كانت مقدمةً لفتح بلاد الشَّام وتحريرها من الرُّومان، ونستطيع أن نقول: إنَّ تلك الغزوة هي خطوةٌ عمليَّةٌ قام بها النَّبيُّ (ﷺ) للقضاء على دولة الرُّوم المتجبِّرة في بلاد الشَّام، فقد هزَّ هيبتها في قلوب العرب، وأعطت فكرة عن الرُّوح المعنويَّة العالية عند المسلمين، كما أظهرت ضعف الرُّوح المعنوية في القتال عند الجنديِّ الصَّليبيِّ النَّصرانيِّ، وأعطت فرصةً للمسلمين للتَّعرُّف على حقيقة قوات الرُّوم، ومعرفة أساليبهم في القتال (أبو فارس، 1999، ص 64).
وقد ظهرت في هذه المعارك مشاهد البطولة والتضحية والصبر في القتال عند المسلمين الذي كانوا يواجهون عدواً يفوقهم عدداً وعدة بأضعاف مضاعفة، وإنَّ الصَّبر والثَّبات والتَّضحية الَّتي تجلَّت من كلِّ واحدٍ من الأمراء الثَّلاثة، زيد بن حراثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة رضي الله عنهم، وسائر الجند، كان مبعثها الحرص على ثواب المجاهدين، والرَّغبة في نيل الشَّهادة؛ لكي يكرمهم الله برفقة النَّبيِّين والصِّدِّيقين والشُّهداء والصَّالحين، ويدخلوا جنَّات الله الواسعة، الَّتي فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر (المصدأبو فارس، 1999، ص 66).
وخلال المعركة وبعدما استُشْهِد القادة الثلاثة جميعاً، وسقطت الرَّاية من يد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، التقطها ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عديِّ بن العجلان البلويُّ الأنصاريُّ وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجلٍ منكم، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل! فاصطلح النَّاس على خالد بن الوليد (أبو فارس، 1999، ص 61)، وجاء في (إمتاع الأسماع): أنَّ ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد، فقال: خذ اللِّواء يا أبا سليمان! فقال: لا آخذه، أنت أحقُّ به، أنت رجلٌ لك سنٌّ، فقد شهدت بدراً، فقال ثابت: خذه أيُّها الرَّجل، فو الله ما أخذته إلا لك!
فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأصبحت الخطَّة الأساسيَّة المنوطة بخالدٍ في تلك السَّاعة العصيبة من القتال أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعيِّ، فبعد أن قدَّر الموقف واحتمالاته المختلفة تقديراً دقيقاً، ودرس ظروف المعركة دراسةً وافيةً، وتوقَّع نتائجها اقتنع بأنَّ الانسحاب بأقلِّ خسارةٍ ممكنةٍ هو الحلُّ الأفضل، فقوَّة العدوِّ تبلغ (66) ضعفاً لقوة المسلمين، فلم يبقَ أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظَّم، وعلى هذا الأساس وضع خالدٌ الخطَّة التالية:
أ - الحؤول بين جيش الرُّوم وجيش المسلمين؛ ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحاب.
ب - لبلوغ هذا الهدف لابدَّ من تضليل العدوِّ بإيهامه أن مدداً قد ورد إلى جيش المسلمين، فيخفِّف من ضغطه وهجماته، ويتمكَّن المسلمون من الانسحاب، وصمد خالدٌ حتَّى المساء عملاً بهذه الخطَّة، وغيَّر في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه، فاستبدل الميمنة بالميسرة، ومقدِّمة القلب بالمؤخِّرة، وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجَّة صاخبةً، وجلبةً قويَّةً، ثمَّ حمل على العدوِّ، عند الفجر، بهجماتٍ سريعةٍ متتالية، وقويَّة؛ ليُدخل في رُوعِه: أنَّ إمدادات كثيرةً وصلت إلى المسلمين (ابن كثير، 1988، ص 4/247).
ونجحت الخطَّة؛ إذ بدا للعدوِّ صباحاً: أنَّ الوجوه والرَّايات الَّتي تواجهه جديدةٌ لم يرها من قبل، وأنَّ المسلمين يقومون بهجماتٍ عنيفةٍ، فأيقن: أنَّهم تلقَّوا إمدادات، وأنَّ جيشاً جديداً نزل إلى الميدان، وكان البلاء الحسن الَّذي أبلاه المسلمون قد فتَّ في عضد الرُّوم وحلفائهم، فأدركوا أنَّ إحراز نصرٍ حاسمٍ ونهائيٍّ على المسلمين أمرٌ مستحيلٌ، فتخاذلوا، وتقاعسوا عن متابعة الهجوم، وضعف نشاطهم واندفاعهم، فخفَّ الضَّغط عن جيش المسلمين، وانتهز خالدٌ الفرصة، فباشر الانسحاب، وكانت عملية التَّراجع الَّتي قام بها خالدٌ في أثناء معركة (مؤتة) من أكثر العمليَّات في التاريخ العسكريِّ مهارةً ونجاحاً، بل إنَّها تتَّفق وتتلاءم مع التَّكتيك الحديث للانسحاب، فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب، ولـمَّا أصبح الجناحان بمنئ عن العدوِّ وفي مأمنٍ عنه؛ عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين، إلى أن تمكَّن، وضمن سلامة الانسحاب كُلِّيّاً، ويقول المؤرِّخون: إنَّ خسارة المسلمين لم تتعدَّ الاثني عشر قتيلاً في هذه المعركة، وإنَّ خالداً قال: «لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعةُ أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحةٌ يمانيَّة».
ويمكن القول بأنَّ خالداً بخطَّته تلك، قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمةٍ ماحقةٍ وقتلٍ محقَّقٍ، وأنَّ انسحابه كان قمَّة النَّصر بالنِّسبة لظروف المعركة؛ حيث يكون الانسحاب في ظروفٍ مماثلةٍ أصعب حركات القتال، بل أجداها وأنفعها (سويد، 1989، ص 173).
وإنَّه لدرسٌ عظيمٌ في فقه القيادة يقدِّمه لنا الصَّحابيُّ الجليل ثابت بنُ أقرم العجلانيُّ عندما أخذ اللِّواء بعد استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخرِ الأمراء، وذلك أداءً منه للواجب؛ لأنَّ وقوع الرَّاية معناه: هزيمةُ الجيش، ثمَّ نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائداً، وفي زحمة الأحداث قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعلٍ، فاصطلح النَّاس على خالدٍ.
فثابت جمع المسلمين أوَّلاً، وأعطى القوس باريها، فأعطى الرَّاية أبا سليمان خالد بن الوليد، ولم يقبل قول المسلمين: أنت أميرنا؛ ذلك: أنَّه يرى فيهم مَنْ هو أكفأ منه لهذا العمل، وحينما يتولَّى العمل مَنْ ليس له بأهلٍ، فإنَّ الفساد متوقَّعٌ، والعمل حينما يكون للهِ تعالى، لا يكون فيه أثرٌ لحبِّ الشُّهرة أو حظِّ النَّفس.
إنَّ ثابتاً لم يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين - وهو ممَّن حضر بدراً - ولكنَّه رأى من الظُّلم أن يتولَّى عملاً وفي المسلمين من هو أجدر به منه، حتَّى ولو لم يمضِ على إسلامه أكثر من ثلاثة أشهر؛ لأنَّ الغاية هي السَّعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن، والطريقة المُثْلَى (الشامي، 1992، ص 376).
وفي موقف آخر في هذه الغزوة، يتجلى درسٌ نبوي في احترام القيادة، فقد قال عوف بن مالكٍ الأشجعيُّ رضي الله عنه: خرجت مع مَنْ خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مَدَدِيٌّ من اليمن.... ومضينا، فلقينا جموع الرُّوم، فيهم رجلٌ على فرسٍ له أشقر، عليه سرجٌ مذهَّب، وله سلاحٌ مذهَّب، فجعل الرُّومي يضرب المسلمين، فقعد له المَدَدِيُّ خلف صخرةٍ، فمرَّ به الرُّومي فعرقب فرسه بسيفه، وفر الرُّومي، فعلاه بسيفه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلـمَّا فتح الله للمسلمين؛ بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السَّلب، قال عوف: فأتيت خالداً، وقلت له: أما علمت: أنَّ رسول الله (ﷺ) قضى بالسَّلب للقاتل؟ قال: بلى! ولكني استكثرتُه، قلت: لتردَّنها إليه، أو لأعرفنكها عند رسول الله (ﷺ)، فأبى أن يردَّ عليه.
قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله، فقصصت عليه قصَّة المدديِّ وما فعل خالدٌ، فقال رسول الله (ﷺ): «يا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال: استكثرته، فقال: «ردَّ عليه الَّذي أخذتَ منه».
قال عوف: فقلت: دونكها يا خالد! ألم أوف لك؟ فقال رسول الله (ﷺ): «وما ذلك؟» فأخبرتُه، قال: فغضب رسول الله(ﷺ)، وقال: «يا خالد لا تردَّ عليه، هل أنتم تاركون لي أُمَرَائِي؟ لكم صَفْوَةُ أمرهم، وعليهم كَدَرُه».
هذا موقفٌ عظيمٌ من النَّبيِّ (ﷺ) في حماية القادة والأمراء من أن يتعرَّضوا للإهانة بسبب الأخطاء الَّتي قد تقع منهم، فهم بشر معرَّضون للخطأ، فينبغي السَّعي في إصلاح خطئهم من غير تنقُّصٍ ولا إهانةٍ، فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه، وإنَّما اجتهد، فغلَّب جانب المصلحة العامَّة؛ حيث استكثر ذلك السَّلَب على فردٍ واحد، ورأى: أنَّه إذا دخل في الغنيمة العامَّة؛ نفع عدداً أكبر من المجاهدين، وعوف بن مالكٍ أدَّى مهمَّته في الإنكار على خالدٍ، ثمَّ رفع الأمر إلى رسول الله (ﷺ) حينما لم يقبل خالد قوله، وكان المفترض أن تكون مهمَّته قد انتهت بذلك؛ لأنَّه - والحال هذه - قد دخل في أمرٍ من أوامر الإصلاح، وقد تمَّ الإصلاح على يده، ولكنَّه تجاوز هذه المهمَّة حيث حوَّل القضيَّة من قضيةٍ إصلاحيَّةٍ إلى قضيَّةٍ شخصيَّةٍ، فأظهر شيئاً من التَّشفِّي من خالدٍ، ولم يقرَّه النَّبيُّ (ﷺ) على ذلك، بل أنكر عليه إنكاراً شديداً، وبيَّن حقَّ الولاة على جنودهم، وكون النَّبيِّ (ﷺ) أمر خالداً بعدم ردِّ السَّلب على صاحبه لا يعني أنَّ حقَّ ذلك المجاهد قد ضاع؛ لأنَّه لا يمكن أن يأخذ رسول الله (ﷺ) إنساناً بجريرة غيره، فلابدَّ: أنَّ ذلك المجاهد قد حصل منه الرِّضا، إمَّا بتعويضٍ عن ذلك السَّلَب، أو بتنازلٍ منه، أو غير ذلك فيما لم يُذكر تفصيلُه في الخبر (الحميدي، 1997، ص 7/130).
إنَّ الأمَّة الَّتي لا تقدِّر رجالها، ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظامٌ، إنَّ التَّربية النَّبويَّة استطاعت بناء هذه الأمَّة بناءً سليماً، وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسانٍ في مكانه وأن يُحترم، ويُقدَّر بمقدار ما يقدِّم لهذا الدِّين! ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العامِّ الَّذي وصف الله به المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 54]. وفي قوله (ﷺ): «هل أنتم تاركون لي أُمَرَائِي؟!» وسامٌ اخرُ يُضاف إلى خالدٍ رضي الله عنه، حيث عُدَّ من أمراء الرَّسول (ﷺ)، وهذا من المنهاج النَّبويِّ الكريم في تقدير الرِّجال (الشامي، 1992، ص 378).
وإنَّ كثيراً ممَّن يتزعَّمون قيادة الدَّعوة الإسلاميَّة اليوم يضعون العراقيل أمام الطَّاقات الجديدة والقُدرات الفذَّة، خوفاً على مكانتهم القياديَّة وامتيازاتهم الشَّخصية وأطماعهم الدُّنيوية، وفي نفس الوقت فإن هناك الكثير من الرعية وعوام المسلمين الذي يتصيدون أخطاء القادة والامراء ليطعنوا فيهم ويحطوا من قدرتهم، لا من أجل الإصلاح وإحقاق الحق ورد المظالم، فعلى القادة والرعية معاً أن يتَّعظوا من هذه الدروس البليغة لمن كان له قلب أو ألقى السَّمع وهو شهيد.
المراجع:
1. أبو فارس، محمد عبدالقادر، (1999)، الصِّراع مع الصَّليبيِّين، دار البشير - طنطا، طبعة عام 1419هـ 1999م.
2. ابن كثير، (1988)، البداية والنِّهاية، الطَّبعة الأولى - 1408 هـ 1988 م، دار الرَّيان للتُّراث.
3. الحميدي، عبدالعزيز، (1997)، التَّاريخ الإسلاميُّ - مواقف وعبرٌ، دار الدَّعوة - الإسكندريَّة، الطَّبعة الأولى، 1418 هـ 1997 م.
4. سويد، ياسين، (1989)، معارك خالد بن الوليد، الطَّبعة الرابعة، 1989 م، المؤسَّسة العربيَّة للدراسة والنَّشر.
5. الصلابي، علي محمد، (2021)، السيرة النبوية، ج 2، ط11، دار ابن كثير، 2021، ص 351-353.
6. الشامي، صالح أحمد، (1992)، مِنْ معين السِّيرة، المكتب الإسلامي، الطَّبعة الثانية، 1413 هـ 1992م.