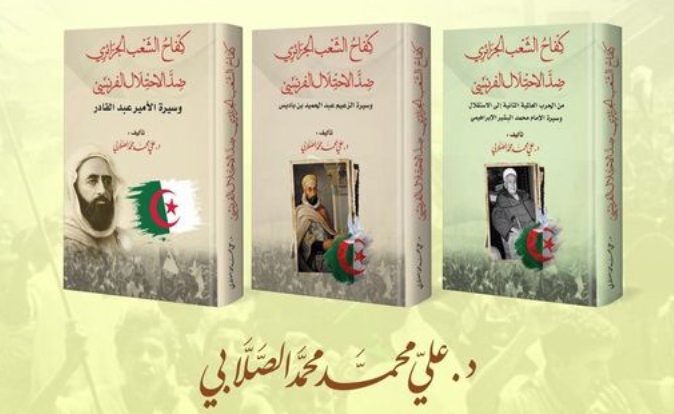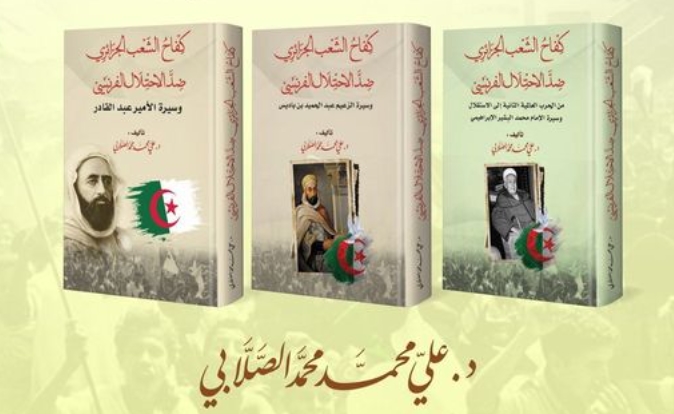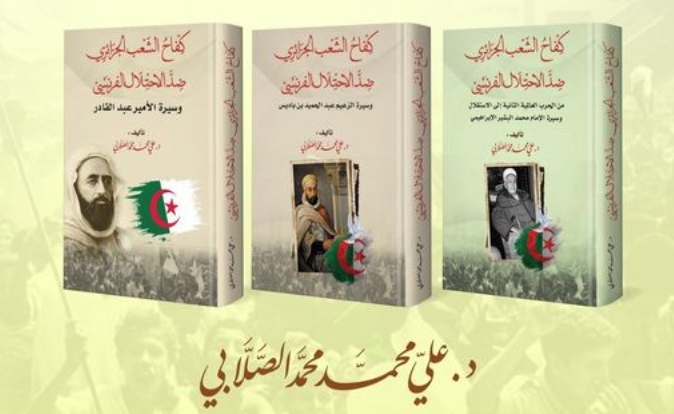من كتاب كفاح الشعب الجزائري بعنوان:
(السياسة الداخلية للأمير عبد القادر الجزائري)
الحلقة: التاسعة والثلاثون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ربيع الأول 1442 ه/ نوفمبر 2020
1 ـ الحكومة المركزية:
كان الأمير يرى أن تنظيم الجبهة الداخلية وتوطيدها هما الأساس الأول الذي ينبغي أن تقوم عليه حرب التحرير، وكان هدفه قبول التفاوض والتساهل مع العدو، وكسب الوقت لاستكمال أسباب هذا التنظيم، وكان الأمير دائم الحرص على إبعاد الطابع الفردي عن سلطته، بإشراك ممثلين عن العلماء والأشراف ورؤساء القبائل يقل عددهم أو يكثر حسب أهمية المسائل أو القرارات. وكان الأمير يدرك مدى عمق الروح الاستقلالية لدى القبائل وزعماء الطرق الصوفية، ومدى تأثير ذلك على عملية التوحيد مما يجعلها أكثر صعوبة، كما كان يدرك مدى كره هؤلاء للغزاة، وبربطه بين التوحيد والمقاومة، وكان يأمل أن يساعده كره الأجنبي على تذليل صعوبات التوحيد ولكن الأمر لم يكن سهلاً، وقد حرص الأمير على أن تكون حكومته من ذوي الخبرات الذين اشتهروا بالكفاءة والقدرة والخبرة والعلم والفضل والتقوى، وكان الأمير يطلب منهم القَسَم على التقيد بالعدل وخدمة الوطن والإخلاص، وكان هناك منادٍ في الأسواق يطلب من كل من له حاجة أو شكوى على خليفة أو قائد أو زعيم فليرفعها إلى ديوان الأمير من غير واسطة، وكان الأمير ينصف الجميع، ومن لا يرفع ظلامته إليه فلا يلومنّ إلا نفسه.
وقد أسس الأمير الديوان الذي كان مقره في المعسكر، أو المدية، أو يُنقل إبان الظروف العدوانية إلى تلك الأماكن التي يرتئي أنها الأكثر ملاءمة لظروف الحرب، وكان مطبوعاً بمركزية شديدة في القرار بالرغم من اللامركزية الإدارية الواسعة، وكان على رأس الحكومة وزير أول بمساعدة ثلاثة كتاب، كاتبان للدولة، أحدهما للحبوس، نصب عليها الحاج طاهر أبو زيد، والاخر للشؤون الخارجية، عهد بمهامها إلى الرجل المشهور ميلود بن عراش، وكانت هناك خزينتان إحداهما عامة والأخرى خاصة، وأخيراً مجلس استشاري أو مجلس الشورى، يتكون من أحد عشر عضواً، ويترأسه قاضي القضاة ؛ الذي كان على علم بكل شؤون الدولة.
لقد شرع الأمير عبد القادر في تكوين جيش وطني، وفي إنشاء المؤسسات، وفي وضع قوانين جديدة مستمدة من الشريعة الإسلامية، وصك عملة باسمه، واستطاع تأسيس دولة ذات طابع جزائري خاص، على قاعدة شعبية، وحدد الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها من خلال تنظيم المقاومة الجزائرية والتي من أهمها:
ـ نشر الأمن وتأديب الخونة العصاة.
ـ توحيد القبائل حول مبدأ الجهاد.
ـ مقاومة الفرنسيين بكل الوسائل.
ـ دفع الفرنسيين إلى الاعتراف بالجزائر، كدولة وبعبد القادر أميراً للبلاد.
2 ـ تقسيم البلاد إلى ثماني ولايات:
قام التنظيم الإداري لدولة عبد القادر على أسس فدرالية، يتمثل في وجود ( مقاطعات إدارية، يرأس كل مقاطعة خليفة للأمير، ويتواجد هؤلاء الخلفاء في:
مقاطعات إدارية، يرأس كل مقاطعة خليفة للأمير، ويتواجد هؤلاء الخلفاء في:
ـ تلمسان، محمد البو حميدي الولهاصي.
ـ معسكر، محمد بن فريحة المهاجي، ثم مصطفى بن أحمد التهامي.
ـ مليانة، محيي الدين بن علال القليعي ثم محمد بن علال.
ـ التيطري، مصطفى بن محيي الدين ثم محمد البركاني.
ـ مجانة، محمد بن عبد السلام المقراني، ثم محمد الخروبي.
ـ بسكرة، فرحات بن سعيد ثم الحسين بن عزوز.
ـ برج حمزة، أحمد بن سالم الدبنيسي.
ـ المنطقة الغربية من الصحراء، قدور بن عبد الباقي.
وبعد استيلائه على إقليم التيطري والسيطرة عليه وسط الترحيب العام ؛ قسمه إلى أربع مناطق أتبعها بمدينة المدية، وولى عليها أخاه السيد الشريف مصطفى بن محيي الدين، ثم أنشأ ديوان الإنشاء والتعمير، وولى عليه السيد الحاج مصطفى بن أحمد التهامي، وقسم الولايات إلى دوائر، ووضع على كل دائرة رئيساً، وهذه الدوائر عبارة عن قبائل تتشكل كل منها من بطون وعشائر، فجعل لكل قبيلة قائداً، وعلى كل بطن أو عشيرة شيخاً يرأسها، فكانت الأوامر تصدر إلى كل هذه المراتب عن طريق التسلسل، وكان المشايخ يرفعون القضايا المهمة إلى القيادة العليا، وهذه بدورها ترفعها تسلسلاً حتى تصل إلى ديوان الأمير.
ونجح الأمير في ربط البلاد بإدارة شرعية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقامة، فأبعد أكثر الرؤساء الذين اشتهروا بالبطش إبان الحكم العثماني، واختار معاونيه من ذوي الأخلاق الحميدة، وأخذ يعتمد على كل من يتمتع بالعلم والشرف والفضيلة، ولم يولّ أحداً محاباة ولا سلمهم زمام الأمور إلا بعد أداء القَسَم المقدس.
وكان يتم تعيين العاملين في الدولة وفق مراسيم خاصة تُحرر بقلم كاتب الديوان الخاص، ويوضع عليها خاتم الدولة، وهو خاتم كبير نقش عليه في الوسط هذا البيت:
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أكامها تجمِ
ونقش على الجوانب: الله، محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وفي دائرة صغيرة داخل الخاتم نقش «ناصر الدين عبد القادر بن محيي الدين» والتاريخ الهجري (1248هـ) لم يعتمد الأمير على تقاليد في الحكم نقلاً عمّن سبقه، بل أقام حكومة ذات طابع جزائري جديد، وتمكن من وضع تنظيمات إدارية وقضائية وعسكرية واقتصادية لدولته الفتية، وعلى الرغم من أن القبائل التي تتكون منها دولته كانت تتنافس فيما بينها، إلا أنه كون منها ما يشبه «فيدرالية ذات ثماني ولايات» يحكمها قانون موحد، وتخضع لنظام واحد ولسيادة واحدة، وقد وضع نظاماً عملياً يتلاءم مع حقائق القرن التاسع عشر وظروفه ؛ التي تقضي بإيجاد دولة حديثة، وأهم المبادئ التي تسلحت بها دولة الأمير العدل والمساواة وحقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون، واحترام النظام وحب الجهاد وكراهية المستعمر، وقد استمدت مفاهيم هذه القيم من الإسلام.
واهتم الأمير بمفهوم دولة المواطنة، وتسلحت دولته بمبدأ المساواة ؛ حتى بينه وبين مواطنيه أو بين المواطنين والحكام، وكان للقضاة وحدهم حق إصدار الأحكام، والسكان جميعاً لهم الحق في التقاضي، وطبقت المساواة حتى بين أفراد القبيلة ورئيسها، ونجح الأمير في جعل الشعب يتجاوز الشعور بالوحدة القبلية إلى الشعور بالوحدة الوطنية.
لقد استطاع الأمير عبد القادر أن يثير الجزائريين بخطابه الوطني الذي ترددت فيه عبارات: بلادكم، أرضكم، دينكم، نساؤكم، وحذر من هذا العدو الفرنسي الذي يريد أن يغل الأعناق وأن يعتدي على الشرف، وتوجه إلى كل القبائل وكل الزوايا وكل الجهات، وتجاوز خطابه بني فلان وبني فلان إلى الشعب إلى المواطنين حيثما كانوا، ومهما كان انتماؤهم القبلي أو الصوفي أو الجهوي، وربما لم تعرف الجزائر قائداً من أبنائها استعمل هذا الخطاب من قبل، فقد كان تحرك الأمير عبد القادر كرجل دولة وطنية، لا كرجل طريقة أو قبيلة أو جهة، لقد بذل جهوداً عظيمة في جمع كلمة الجزائريين لمواجهة العدو المشترك، من خلال إدارة منظمة وحكومة رشيدة، وجيش مجهز وتعبئة عامة لكل مواطنيه، وكان يهتم بالمواطن المعطي الفاعل في بناء الدولة والتصدي للغزاة. وكان يقول لا تسألوا عن أصل الرجل، بل اسألوا عن حياته وأعماله وشجاعته ومؤهلاته وستعرفون من هو، فإذا كانت مياه النهر طاهرة مقبولة فلأنها جاءت من نبع صاف.
لقد امتدت سلطة الأمير عبد القادر منذ (1838م) لتشمل الأغلبية العظمى من البلاد، وإذا كان الفرنسيون مازالوا يحتلون جزءاً من التراب الوطني، فإن العمل الذي أنجزه الأمير في بضع سنين كان عظيماً ويبدو وشيكاً على بلوغ غايته. لم يصبح الأمير السيد بلا منازع، ولا شريكاً على الجزء الأكبر والأوفر ثروة وسكناً في البلاد فحسب، لكن القبائل التي كانت مشتتة متنافرة سابقاً قد أصبحت الان موحدة تحت ظل لواء واحد، وسلطة قوية ومركزية لم يسبق لها مثيل ؛ تضمن أمن الأشخاص والممتلكات في كل مكان، بفضل قضاء فعال ومنصف بالنسبة للجميع، وفي وجود جيش عصري يضمن حماية التراب، ومستعد لمواجهة كافة الاحتمالات، وقد توجت كل الجهود الرامية إلى عصرنة البلاد وتوحيد الشعب الذي خرج من الفوضى التي تركته فيها القرون في العقود الماضية، وكللت بنجاح بفضل عبقرية الأمير، وتفانيه في خدمة المصلحة العامة، هو ومن معه من الرجال الذين أحسن اختيارهم، صحيح أن العمل لم يكن قد اكتمل، لكن قوامه وأساسه كان قد أنجز، وقد كانت تلك الجهود المباركة نواة قوية للدولة الجزائرية الحديثة.
3 ـ معايير تعيين موظفي الدولة ومناصبهم:
كان يتم اختيار موظفي الدولة من أبناء الشعب الجزائري وزعماء القبائل، والأعيان، والعلماء، وأصحاب المكانة المرموقة من ذوي الكفاءات والقدرات والملكات الإدارية والقيادية. كان كل موظف في الدولة ابتداءً من اسمى موظف وهو الخليفة إلى أبسط الشيوخ، يملك في نطاقه كامل السلطة الإدارية والعسكرية والمالية على قمة السلم، كان الخليفة بتفويض من الأمير الذي كان يمثله يملك السلطة المطلقة في ولايته التي يقود جيشها في وقت الحرب ويتحكم في اغاتها وقيادتها وشيوخها، وكان يحكم في القضايا التي تتعلق بالدولة وقضايا الاستئناف ضد أحكام وقرارات الاغات، وقد كانت تتجمع عنده الضرائب التي يرفعها الاغات والقيادة والشيوخ. ومدة خدمته غير محددة ؛ لأنه كان يختار لكفاءته وإخلاصه وقد تبين أنهم جميعاً أهل لثقة الأمير، فلم يخن أي منهم هذه الثقة على الرغم من محاولات العدو رشوتهم.
من الجهة الأخرى نجد أن انتداب الاغا كان قابلاً للفسخ، لكنه قابل للتجديد، وتدوم مدته النظرية سنتين، وكان الاغا مسؤولاً عن الأمن في نطاق اختصاصه كما كان يجند المحاربين، ويرفع محصلة الضرائب التي كان يجمعها القادة والشيوخ في منطقته، وكان هو القاضي في المسائل الخارجة عن نطاق الشريعة، بشرط الامتثال للاستئناف في قراراته أمام الخليفة، وأخيراً فقد كان يراقب قرار القيادة في حدود مسؤوليته، كانت مدة انتداب القائد تقدر بسنة مع قابليتها هي الأخرى للتجديد، وقد كان يمارس مهامه في نطاق قبيلته، وعلاوة على دوره كمقسط للضريبة المقدرة على منطقته الذي يساعده على القيام به الشيوخ، فقد كان القائد يمارس سلطة دركية، وفي زمن الحرب كان يقود كتيبة تشكل بالخصوص من الجنود غير النظاميين.
أخيراً في القادة يوجد الشيخ، وهو على العكس من رؤسائه يجب أن يكون منحدراً من نفس القبيلة ومن نفس الجزء المنوط به قيادته، وهو يستمد سلطته من ثقة مواطنيه فيه، ومن هنا تأتي أهميته الاجتماعية بالرغم من تواضع مهمته.
ويجمع هو الآخر في نطاقه الخاص وظائف الشرطة ومحصل الضرائب وضابط الحالة المدنية، غير أنه كان مسؤولاً بوجه خاص عن الأمن العام في قبيلته، وهي مهمة صعبة ومرهقة ؛ لأنه لم يكن يملك الحق في إصدار العقوبات على الجانحين فهذا امتياز خاص بالآغا.
كان الأمير يختار القيادة من الأشياخ الأكثر أهلية واستحقاقاً، ولأجل تفادي الرشوة كان الموظفون يعينون من الطبقة الميسورة، وبالإضافة إلى معاشاتهم فإنهم كانوا يتقاضون حصة من الضرائب والمخالفات «الخطايا» التي كانوا يجبونها.
4 ـ السلطة القضائية:
كانت السلطة القضائية في دولة الأمير عبد القادر منفصلة عن السلطة التنفيذية، بقدر ما كان من يمارسها منفذاً للقانون، وليس ممثلاً للأمير، مع أن هذا الأخير هو الذي يعينه، وقد كانت صلاحيته واسعة، تشمل نظام الأحوال الشخصية والميراثية، والشؤون العقارية، وكان أيضاً يصادق على العقود المحررة من طرف الكاتب الشرعي أو الموثق الذي كان يزاول وظائفه في مقر القضاء، كما كانت صلاحية القاضي تمتد حتى إلى القضايا الجنائية.
كان القاضي بطبيعة منصبه شخصية مهمة، وكان يتم اختياره لثقافته وخصاله الفاضلة، وكان يعين إما من بين العلماء المشهورين، أو عند تعذر ذلك فبامتحان، ولم تكن تخرج عن دائرة اختصاصه إلا القضايا المتعلقة بالأمن العام ؛ التي كانت من اختصاص الخليفة أو الاغا، وكان القاضي كغيره من الموظفين يقبض راتباً محترماً، وكان فوق ذلك يتبع الأرتال في تحركاتها، وهو مرفوق باثنين من المعاونين أحدهما مكلف بتنفيذ الحكم.
وكان الأمير لا يسمح إلا بالأحكام المطابقة لشريعة الله ؛ التي ما كان يعتبر نفسه إلا منفذاً لها.فالمرجعية الدستورية العليا في دولة الأمير عبد القادر القرآن الكريم، والسنة النبوية، والاسترشاد باجتهاد العلماء والفقهاء المجتهدين، وللمذهب المالكي مكانة متميزة في دول الشمال الإفريقي ؛ وإن كانت أمور الدولة لا تعتمد عليه فقط، وإنما تحتاج إلى الانفتاح على المذاهب السنية الأخرى واجتهادات فقهاء كل عصر ؛ الذين فهموا النصوص وأدركوا حكمتها وغاياتها، ولديهم من الملكات الفقهية والتربية الإيمانية الربانية ؛ التي تجعلهم يتحرون المصلحة العامة في المواضيع الطارئة التي لا يوجد فيها نصّ ملزم صريح، مع قدرة فائقة في حساب تطور الأزمان.
ومن أشهر قضاة دولة الأمير عبد القادر العلاّمة قاضي القضاة أحمد بن الهاشمي المراحي، والسيد عبد بن المصطفى المشرفي.
وكان الأمير عبد القادر حازماً في منع شرب الخمر، ولعب الميسر، وبصورة خاصة بين صفوف المقاتلين، كما حظر التدخين لكونه إسرافاً، ونهى الرجال عن استعمال الذهب والفضة إلا في الأسلحة.
كان عبد القادر حريصاً على رفع الظلم وإقامة العدل وتقوية المؤسسة القضائية، ويرى أن ذلك من أسباب قوة الشعب وصلابة الدول وعوامل النصر على الغزاة الفرنسيين، لقد واجه الاستعمار الفرنسي زعيماً فذاً، وشعباً يتكون، ودولة تبنى على أسس راسخة بزعامته.
5 ـ مجلس الشورى:
اتخذ الأمير في كل مقاطعة داراً للشورى لبحث الأمور الهامة في الدولة، وجعل انتخاب أعضاء هذه المجالس «مجالس الشورى» من قبل النّواب الذين كانوا يُدعون بالخلفاء، وربط هذه المجالس بالمجلس الأعلى للبلاد، المؤلف من أحد عشر عالماً، وبمجالس الاستئناف، وأما العلماء الأحد عشر فمنهم السادة: أحمد المحفوظي، أحمد بن طاهر بن الشيخ المشرفي، ومحمد بن مختار الورغي، ومختار بن مكي الحاج، عبد القادر بن روكس، وإبراهيم بن القاضي، وأحمد بن الهاشمي. وأما نفقات هذه المجالس فكانت تصرف من بيت المال كباقي كوادر الدولة، وأما أصحاب الوظائف الدينية وما يتعلق بها فكانت رواتبهم تصرف من خزينة وزارة الأوقاف.
كان مجلس الشورى الأعلى في الدولة الفتية ينعقد والأمير في وسطه، وكان يتفحص الطعون في قرارات القضاة، ويشكل هذا المجلس علماء أجلاء، كانوا يتمادون في التدقيق عندما تعارضهم مشاكل عويصة، إلى أن يطلبوا باسم الأمير رأي العلماء المعروفين بتعمقهم في علوم الشريعة، في الغالب كانوا يستشيرون علماء جامعة القرويين بفاس، كذلك كان يستشار علماء الأزهر في بعض الأحيان، غير أنه نظراً لبعد المسافة فإن الأمير لم يكن يلجأ إليهم إلا في الحالات الاستثنائية.
والأمير لم يكن أبداً يتخذ القرار ببساطة، كان دوماً يسشير المجلس الذي يترأسه في أغلب اجتماعاته، والذي كان في معظم الحالات يعكس صدى الرأي العام.
6 ـ الاقتصاد والمالية العامة:
لقد أنشأ الأمير نظاماً اقتصادياً تشرف عليه الدولة، الهدف منه جعل اقتصاد البلاد في خدمة الغايات القتالية بصورة خاصة، ومصلحة الفقراء والشعب بصورة عامة، فكان الجباة يخرجون مرتين في السنة لجباية الزكاة والأعشار بعد أن يُقْسِموا على القرآن الكريم بألا يظلموا أحداً وألا يعتدوا على أحد.
وأنشأ ديوان الأوقاف، وأوكل أمره إلى أبي الحاج عبد الله الجيلاني بن فريحة وأوكل أمور ديوان الأوقاف إلى السيد عبد الرحمن الحاج طاهر أبي زيد، كما أنشأ ديوان صناعة العملة ومعامل الأسلحة وكل ما يتعلق بأدوات الحرب، وأوكل أموره إلى السيد أبي البركات محمد الجيلاني، وأسند الأمور الداخلية إلى أبي محمد السيد الجيلاني بن الهادية، أما كتّاب الديوان فكانوا من السادة الأشراف، السيد أحمد بن أبي طالب، والسيد مصطفى التهامي. وكان حاجبا الخزينة هما: السيدين محمد بن الحاج علي الريحاوي، والحاج النجادي الريحاوي، وكان السيد محيي الدين بن عبد الله ناظر الإسطبلات.
كانت إيرادات الدولة الفتية تستعمل في نفقات الإدارة والجيش على الأغلب، ويجدر التوضيح هاهنا بأن كل الرواتب والمعاشات كانت تدفع نقداً وعيناً بالسلع الغذائية على وجه الخصوص وأنها كانت تتم بانتظام.
لقد بقيت عملة الأمير متداولة حتى بعد استسلامه، واستمرت كذلك إلى أن أخذت السلطة الاحتلالية سنة (1849م) إجراءات خاصة لسحبها من التداول.
وكانت الخزينة العامة قيمة معتبرة بالنسبة لذلك العصر، وتقوم بالعملة الصعبة، وقطع الذهب بما يعادل أربعة ملايين من الفرنكات الحالية، وهي نتاج الصادرات إلى إسبانيا وفرنسا من الحبوب والماشية والأصواف الاتية من الضرائب، وزيادة على ذلك فكان يوجد لحاجيات الحرب كميات ضخمة من البارود والكبريت وملح البارود والمعادن، وكانت الحبوب مخزنة في مطامير موزعة على كامل إقليم الدولة.
7 ـ التجارة:
كانت التجارة مزدهرة بفضل الأمن الذي كان مستتباً تماماً في كل الأقاليم الواقعة تحت سلطة الأمير، وكان الأمير صارماً فيما يخص قضية أمن الطرق والأسواق، وكانت العقوبات قاسية بالنسبة لمن كانوا يعترضون القوافل المحملة بالبضائع، وكان سلطان فاس معجباً بجهود الأمير ونجاعتها، وذلك أن القوافل القادمة من المغرب كانت تهاجم خلال الفترة التي قبل مجيء الأمير عبد القادر للسلطة وبيعته، مما كان يجعل المبادلات التجارية بين البلدين نادرة للغاية.
وكان الأمير يعين محتسباً، وهو ما يشبه المفتشين، وكان في نفس الوقت يعمل على التحكم في أسعار ونوعية البضائع في الأسواق، ويراقب الأخلاق التي كانت سليمة ومحترمة، ومنذ اتفاقية دي ميشال أصبح الفرنسيون الذين كانوا يحتلون الموانىء لا يستلمون أية بضاعة أساسية من دولة الأمير، من حبوب وماشية وأصواف ؛ إلا بترخيص منه. كان الإقليم الخاضع للأمير أكثر أمناً، كما كان النظام به أكثر استتباباً مما هو عليه في مناطق النفوذ الفرنسية وفي المغرب، وكانت الشرطة الفعّالة لدولة الأمير تهتم بالأخلاق الحميدة وتحارب الذميمة، وتحارب الكحول والتدخين والمقامرة... إلخ
8 ـ الدبلوماسية:
إن المعاهدة الأولى المسماة «دي ميشال» الموقعة بين الحكومة الفرنسية والأمير تختص بشروط التعيين المتبادل للممثلين، مع أنه قد كان هناك جدل بين الفرنسيين والأمير حول عبارة ممثل بالنسبة للطرف الأول وقنصل بالنسبة للثاني.
مهما كانت العبارة، فإن الأمر كان يتعلق بدبلوماسيين معتمدين عند كلا الطرفين، ذلك أنه قد اعترف ضمنياً في هذا الاتفاق ـ ولو على جزء من الإقليم ـ بالسيادة الزمنية والروحية لعبد القادر «أمير المؤمنين». كان الأمير يفضل اختيار هؤلاء الوكلاء الدبلوماسيين من بين اليهود، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم من رعاياه مثلهم مثل غيرهم من الجزائريين، وذلك لمهارتهم الدبلوماسية، وكذلك لمعرفتهم لكلتا اللغتين، وككل الدبلوماسيين فقد كان هناك ثلاثة، مهمتهم تتمثل في السهر على التطبيق الدقيق للمعاهدة، وتبادل أصحاب الجنح والجنايات والفارين من الجيش، وتطبيق الأحكام الصادرة في كلتا المنطقتين.
كانت فرنسا في هذه الفترة تحتل مدن الجزائر وهران، أرزيو، ومستغانم، وكان قناصلة الأمير حسب بن أشنهو هم على التوالي: مادوخاي «مردوش»، وبن دوران، والحاج حبيب، ومحمد بن يخو، وخالفه بن حمود.وقد كان هناك أوروبيون يمثلون الأمير في الجزائر مثل كارافيني ؛ غير أنه قد اعتبر من قبل فرنسا شخصية غير مرغوب فيها، وذلك تمهيداً لأزمة (1839م) ؛ وهذا ما زاد في حدة التوتر بين فرنسا والأمير، وهو ما أدى إلى استئناف الأعمال العدوانية.
على الرغم من الروابط الوثيقة التي كانت تجمع الأمير بسلطان فاس، فإنه لم يكن بين الدولتين علاقات دبلوماسية بالمعنى المعروف، وإنما تبادل للوفود في فاس، ومكلف واحد بالأعمال، هو الحاج بن جلون.
في فرنسا كان غالباً مبعوث الأمير إلى باريس هو ميلود بن عراش، الذي يمكن اعتباره انذاك كسفير معتمد لدى الحكومة الفرنسية.
وأخيراً، فإذا كانت هناك علاقات تجارية لهذه الدولة الفتية مع إسبانيا وخصوصاً مع إنجلترا، هذه الأخيرة التي كانت تحابي الأمير، وكانت في نفس الوقت تعمل على التقرب من فرنسا، فإنه لم يوجد أي تمثيل بين هذه البلدان والأمير، وعلى العكس من ذلك فإن الأمير كان منذ توليه وحتى الشهور الأخيرة من كفاحه على علم تام بما كان يجري ليس في فرنسا فقط، وإنما كذلك في الدول الأوروبية الأخرى.
9 ـ المخابرات:
لقد كان له مصلحة أخبار حقيقية، ويرجع الفضل في ذلك إلى مبعوثَيه ؛ اللذين كانا مركزاً كبيراً للمبادلات، وكانا له بمثابة قاعدة للإمداد، ليس لتوريد الأسلحة والذخيرة فقط، بل وكذلك لنشر وجمع الأخبار، وكان يتابع ما يصدر من جرائد أوروبية، ويكلف من يقوم بترجمتها، وحسب ميلود بن عراش سفيره فوق العادة في باريس، فإن الأمير كان له ابتداء من (1838م) عميل يتجسس لصالحه، وهو جنرال فرنسي متقاعد يقيم في باريس، حيث كان يتمتع بنفوذ كبير وكان يخبره بكل ما قد يهمه.
وكان هذا الجهاز المرتبط بالأمير يتابع تحركات الفرنسيين وعملائهم داخل القطر الجزائري بحرفية عالية.
10 ـ الثقافة:
قبل الاحتلال الفرنسي كان التعليم ينشر عن طريق الزوايا، وكان كل من العلماء والفقهاء ومثلهم الطلبة أو المدرسون هؤلاء وأولئك يجودون بعلومهم ومعارفهم كل منهم في القبيلة الخاصة به، وقد كان تعليم المواطنين من بين انشغالات الأمير منذ توليته، وهذا ليس بغريب من قبل زعيم يعترف بقيمة العلم والمعرفة والثقافة.
وهكذا فقد كانت جهوده التوحيدية تتماشى بالتوازي مع إقامة نظام تربوي عام، وقد أقيمت في الأرياف مثلها مثل المدن المدارس، حيث لم يكن التلاميذ يدرسون القرآن فقط، وإنما القراءة والكتابة والحساب، وكان هذا التعليم مجانياً، مثلما كان التعليم ذا المستوى الأعلى الملقن في الزوايا والمساجد، هاهو ذا ما كتبه الأمير حول هذا الموضوع: كان أولئك الذين يبتغون قدراً أكبر من التقدم في دراستهم يرسلون مجاناً إلى الزوايا والجوامع، فكانوا يجدون فيها طلبة قادرين على تكوينهم في التاريخ وعلوم الدين، كنت أخصص للطلبة راتباً منتظماً، كانت قيمته تتفاوت حسب علمهم وجدارتهم، وكانت أهمية تشجيع التعليم تبدو لي من الضرورة بمكان، بحيث إنني أكثر من مرة عفيت عن حكم الإعدام على مجرم ؛ لسبب وحيد هو كونه طالباً.
كان الأمير يحرص بنفسه على صيانة الكتب والمحفوظات، وكان يعطي القبائل أوامر دقيقة من أجل صيانة الكتب، ويأمر بعقوبة صارمة في حق كل من يمسك متلبساً بإتلافها أو تمزيقها، هكذا فقد أنشئت مكتبة كبيرة بتجميع المؤلفات والمخطوطات ذات القيمة، كان الكثير منها يؤخذ إثر المعارك، أو يشترى أو يسلم من قبل الجنود الذين كانوا يجزون على ذلك.
لقد أتلفت هذه المكتبة ذات الأهمية البالغة من قبل القوات الفرنسية عند سقوط الزمالة في (1843م)، وقد كان لهذا تأثير بالغ في نفس الأمير.
11 ـ الصناعة:
لم يكن بحث الأمير وتخزينه للمعادن الخالصة ضرورياً فقط لصنع عملته، بل كذلك من أجل تكوين صناعة قادرة على جعله مستقلاً عن الخارج، وقد استطاع في سنة (1839م) أن يجمع بين ألفي قنطار من الحديد ومئتين من النحاس، وقد تمخضت أبحاثه عن اكتشاف منجم للكبريت قام مباشرة باستغلاله، ومنجم آخر للرصاص، وقد جعل من مدنه قواعد صناعية بإنشاء مصانع ومخازن للبارود في معسكر، مليانة، المدية، وتاكدمت، ومعامل للسلاح في مليانة بفضل استخراج الحديد الخام من جبل زكار المطل على المدينة، كما أنه قد أنشأ مسابك المدافع في تلمسان، ولم تكن هذه المراكز مخصصة لصنع الأسلحة فقط، كذلك كانت تصنع الملابس للعسكريين والمدنيين على حد سواء.
كان الأمير دائم الانشغال والتفكير بعدم الارتباط والتبعية للخارج، ونظراً لمحدودية إمكانياته وموارده فقد كان يعوضها بالشراء من المغرب، عن طريق المكلف بأعماله في فاس، ومن وهران ومن مدينة الجزائر لكميات كبيرة من الحديد والصلب وصفائح الفولاذ والأقمشة والجوخ المخصصة بالدرجة الأولى لتجهيز جيشه، لقد كانت جبارة تلك الجهود التي قام بها الأمير بغية تعزيز البلاد بصناعة تمكنه على قدر المستطاع من تجهيز بلاده حتى يتحرر من التبعية للخارج.
يكتب الكونت دي سيفري في كتابه، عبد القادر ومساجين الحرب: كانت المشاغل والمخازن والمعامل والصناعات الحربية والسلمية والحصون والأسواق والمدن، كلها تنبعث وكأنها نتاج أعمال سحرية.
غير أنه كان يلزمه التقنيون، وقد وجد تقنيين لصناعة النقد، خاصة من الفرنسيين الذين كانوا في مجملهم من الفارين المعتنقين للإسلام.
وكان حريصاً على الاستفادة من فرنسا في جانب التقنية من خلال إرسال مواطنين إليها، ولكن محاولاته باءت بالفشل، من جراء التردد والتحفظ الذي ظهر من جانب فرنسا.
وكان يحرص على الاستفادة من الخبراء وأهل التخصص في ميادين الصناعة وعلم المعادن، واستفاد من خبير فرنسي كان مهتماً بالأبحاث المنجمية بعث به سلطان المغرب إليه ليقدم خدماته للأمير. وفعلاً بدأ التنقيب في جبل زكار واكتشف أن خام الحديد متوافر بكثرة، وقد استوردت من إسبانيا عجلة مائية ومسقط مياه يستعمل كقوة دافعة، وذلك لاستخدامها في إنشاء مصنع ذي فرن عال، ولإعطاء المشروع كامل أهميته كان الأمير يصر على معاينته بموكب من القادة السياسيين والعسكريين. وقد حضر الأمير كل مراحل العملية بكل اهتمام وقلق، وعندما صب قضيب الحديد قام الأمير أمام الملأ بتقبيل المهندس، وعندما برد الحديد أخذه الأمير بين يديه وتفحص كل أوجهه ثم عرضه على كل مرافقيه وأنصاره.
لقد كان الأمير يهتم بالتطور والرقي، وبالرغم من أن الأمير كان ابن بيئة محافظة وأسرة متصوفة ومنطقة ريفية منعزلة، ورغم أنه كان قريباً من مدينة معسكر التي كانت مقراً لسلطة باي الغرب، ثم إنه قضى بعض الوقت في التعليم بوهران التي كانت قبل فتحها (1792م) مدينة ذات طابع إسباني، وكان الأمير عميق التمسك بالدين وتعاليمه، وبنصوص القرآن والسنة، ومتمكناً من التراث العربي والحضارة الإسلامية ؛ يحفظ الشعر والأمثال والخطب والحكم، ويعرف حياة الفلاسفة والرياضيين والأطباء ؛ ومع ذلك وجد نفسه بحكم ظروف بلاده على قمة هرم السلطة، فكان عليه أن يوائم بين التقليد والتجديد، بين التراث التليد والحضارة الغربية الغازية.
وقد استجاب الأمير لضغط هذه الحضارة في عدة مجالات دون التضحية بمقدساته، فأدخل نظماً ومصانع وأجهزة لا عهد لقومه بها، وقد عرفنا ذلك عنه، وفي بعض مراسلاته مع الفرنسيين سيما مع ملك فرنسا لويس فيليب، وردت عبارات تدل على أنه كان ينتظر أن يتعاون مع الفرنسيين على إدخال المفيد من الحضارة الأوروبية إلى شعبه.
لقد كان الهدف الاسمى والأشمل لعبد القادر هو جعل عرب وأمازيغ الجزائر شعباً واحداً، ودعوتهم للمحافظة التامة على دينهم، وبعث روح الوطنية فيهم، وإيقاظ كل قدراتهم الهامدة سواء للحرب أو للتجارة أو للزراعة أو للأخلاق والتعليم.
كان الأمير ينشد توحيد الشعب وتوعيته وإلحاقه بركب العالم المتقدم وبناء دولة تجمع بين الإسلام وحاجات العصر.
كل المؤرخين الفرنسيين يذكرون رسالته المؤثرة التي بعث بها إلى الملكة أميلي في هذا المضمار: عوض أن تبعثي إلي بجبنائك الأمجاد كي يقاتلوني، فليأتوا ليساعدوني على أن أضع في بلادي أسس حضارة تكونين قد أسهمت فيها، فتكونين قد حققت هدفين اثنين تنزلين السكينة على قلبك النابض بالأمومة، وتسعدين كلاً من رعاياك ورعايانا، وعسى الله أن يحفظ لك كل ما هو عليك عزيز وغال.
لم يكن هناك رد عملي وفعلي، فروح الغزو والسيطرة التي كانت المحرك الدائم لفرنسا، لم تكن تطيق أن ترى أمة إسلامية عصرية على وجه الأرض.
12 ـ إنشاء المشافي:
اجتهد الأمير عبد القادر في تطوير دولته وأحدث أموراً كثيرة، ومن أهمها إنشاء المشافي العامة والخاصة، فكان في كل مقاطعة عدة مستوصفات ومشافٍ خاصة بالمقاتلين، تصحبهم في كل موقعة ومعركة، وعيّن لكل مشفى أربعة أطباء أكفاء يرأسهم طبيب مشهور، ومن مشاهير الأطباء في دولة الأمير: الحكيم أبو عبد الله الزراوالي، وكان عالماً بخصوص الأعشاب على اختلاف أنواعها، ومن اختصاصاته إخراج الرصاصة من العضو المصاب، بوضع نوع من الأعشاب على الجرح فتخرج الرصاصة من دون الحاجة إلى جراحة بعد وقت قصير وبسهولة ومن دون ألم. وكان إنشاء هذه المستشفيات أحد أهم المنجزات التي كان له فيها فضل كبير.
واستعان الأمير بالعلماء وفقهاء الإسلام في الجزائر والمغرب لكي يكون على ثقة عن عدم تجاوز دولته أحكام الشرع في قراراتها، ودفعته الظروف الجديدة إلى طلب التطوع من السكان لخدمة مزارع الدولة وأملاكها التابعة لبيت المال، بشكل نظام تعاوني عرف «بالتدويرة».
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول: تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى
alsallabi.com/uploads/file/doc/kitab.PDF
الجزء الثاني: كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس
alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC135.pdf
الجزء الثالث: كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من الحرب العالمية الثانية إلى الاستقلال وسيرة الإمام محمد البشير الإبراهيمي
alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC136(1).pdf
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:
http://alsallabi.com