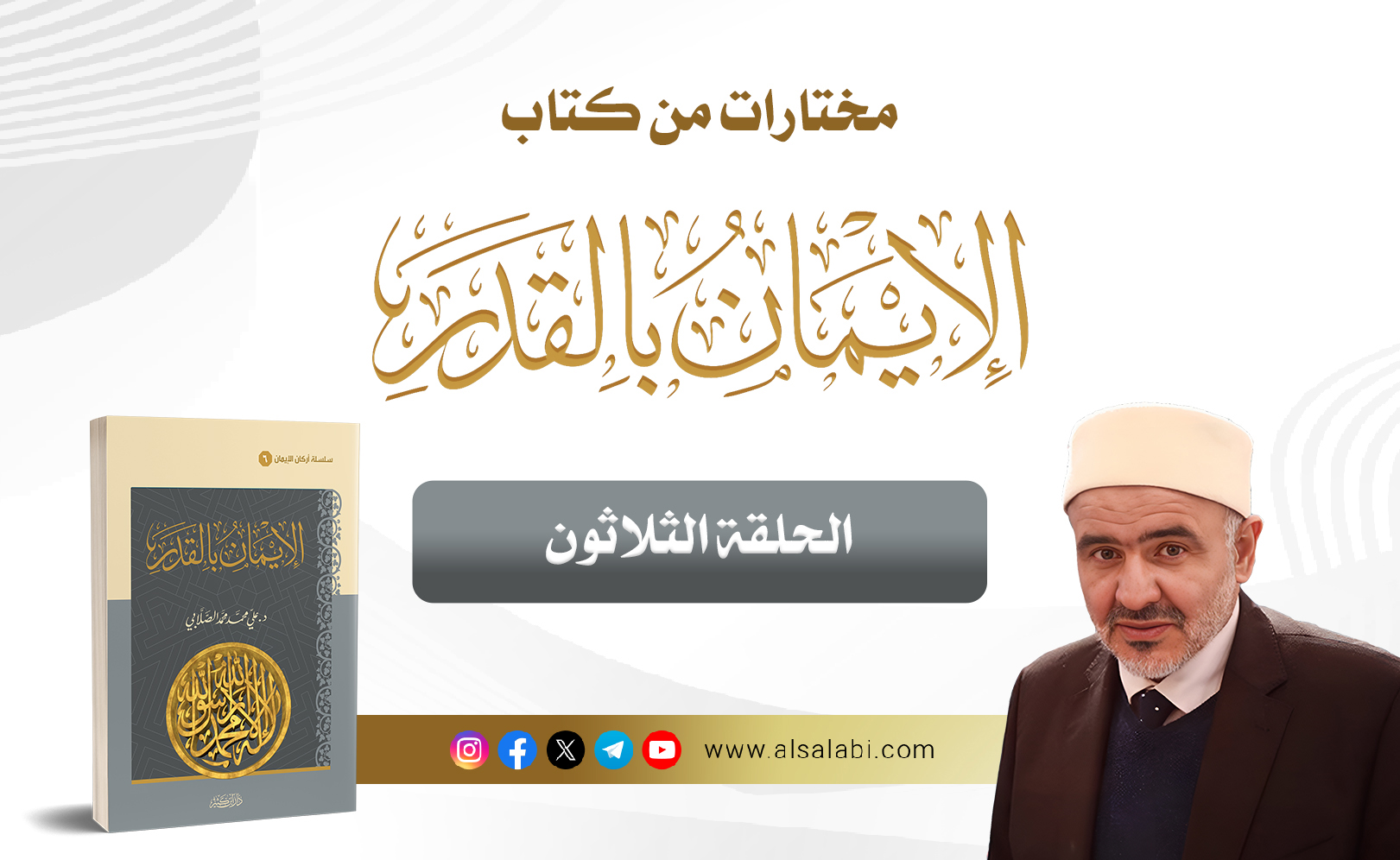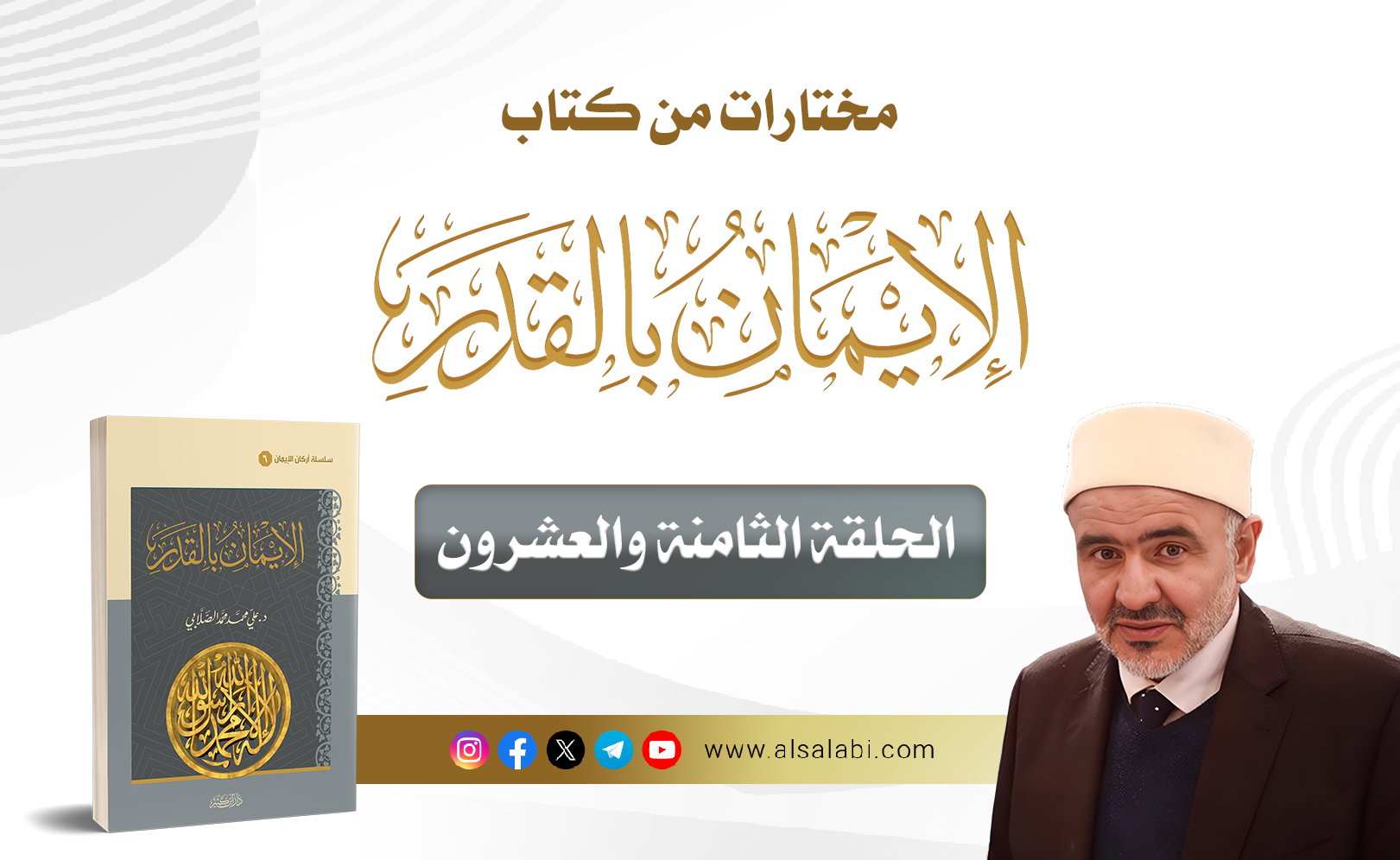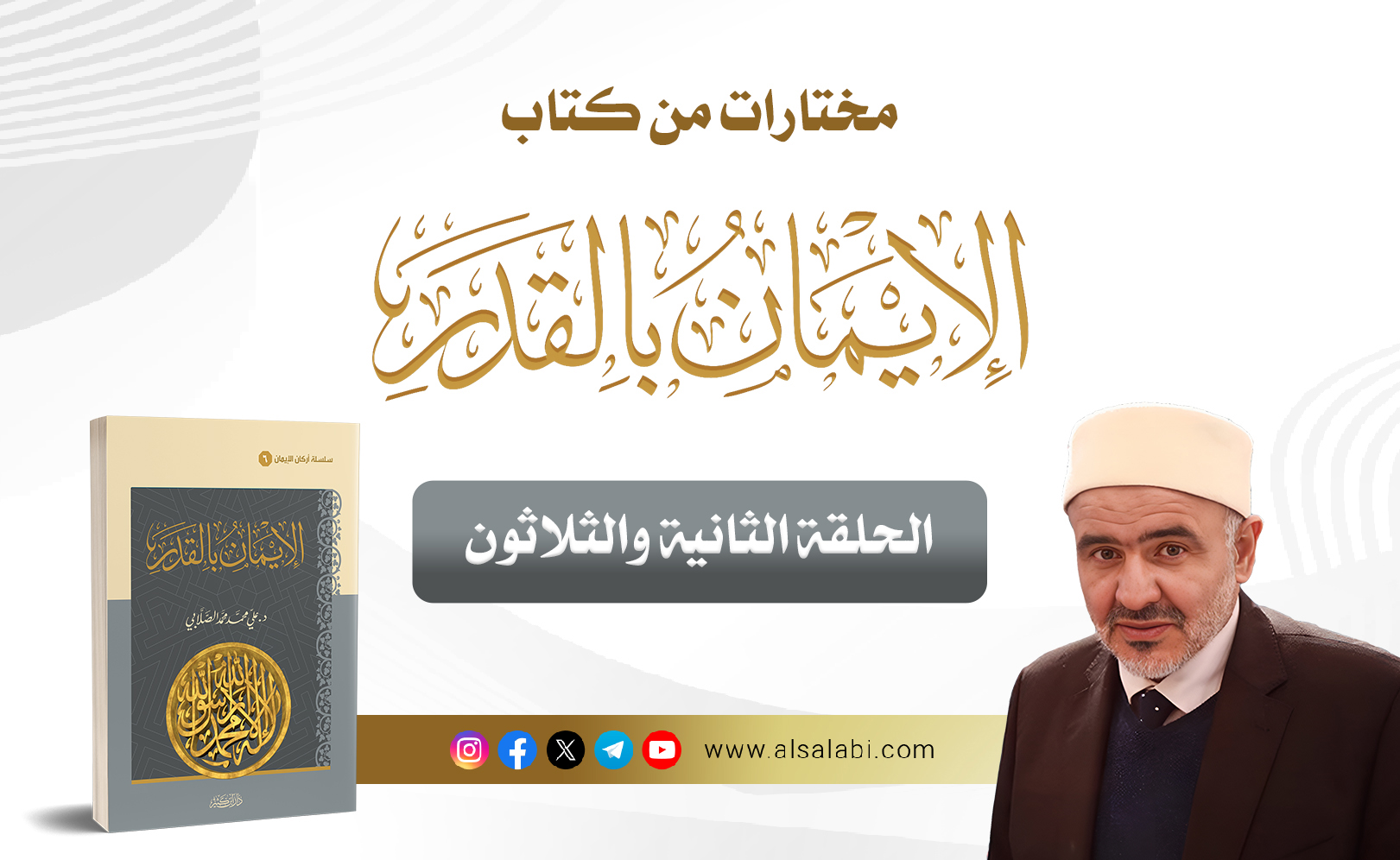الأخذ بالأسباب في السُّنة القولية لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ..
مختارات من كتاب " الإيمان بالقدر"
لمؤلفه الشيخ الدكتور علي محمد الصلّابي
الحلقة الثلاثون
على مستوى السُّنة القولية في موضوع الأخذ بالأسباب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" (1)، في الوقت الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم (2). وظاهر الحديثين يدل على التنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب، إلا أنه عند التحقيق نجد أنه صلى لله عليه وسلم أكل مع المجذوم ليبين أن الله هو الذي يمرض ويشفي، وأنه لا شيء يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها من إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، في حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتراب من المجذوم، ليبين أن هذا من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تقتضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثر شيئاً، وإن شاء أبقاها فأثرت، وفي ذلك فسحة لمقام التوكل (3) على الله، وهذا يبين أن لكل حالة مقامها التي شرعها الله عز وجل لها. ومن ذلك ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ بقوم فقال: من أنتم؟ قالوا: المتوكلون. قال: أنتم المتواكلون، إنما التوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عز وجل (4).
إن الله تعالى قدر الأشياء بأسبابها، فالقدر يتعلق تعلقاً واحداً بالسبب وبالمسبب معاً، أي أن هذا المسبب سيقع بهذا السبب، ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلاً خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلاً خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وهم بعمل أهل النار يعملون (5).
وفي المضمار نفسه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بأن الله كتب المقادير، فقالوا: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: "فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى" (الليل : 5 ـ 10) .
وفي هذا الحديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها، وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره (6).
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في هذا الحديث في شأن القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: الإيمان بالأقدار، إذ هو نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى غيره وتحجز عن شره، وذلك نظام الشرع، فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر (7).
فلا منافاة بين الأخذ بالأسباب والإيمان بالقضاء والقدر، فمن القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء، وإستجلاب الرحمة، كما أن الترس سبب لرد السهم، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان، وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح، وقد قال تعالى: "خُذُواْ حِذْرَكُمْ" (النساء : 71) ، وأن لا يسقي الأرض بعد بث البذور، فيقال : إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر ، وإن لم يسبق لم ينبت ، بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب، وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر، والذي قدر الخير قدره بسببه، والذي قدر الشر قدر لدفعه سبباً، فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته (8).
ولبيان ارتباط الأخذ بالأسباب وتناسقه مع الإيمان والقدر وفق الحكمة الإلهية يقول الرازي عن تفسير قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ" (النساء : 71) أنه لما كان الكل لقدر كان الأمر بالحذر أيضاً داخلاً في القدر، فكان قول القائل: أي فائدة من الحذر كلاماً متناقضاً، لأنه لما كان هذا الحذر مقدراً، فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في الحذر؟ (9).
وحاصل تحقيق كلام الرازي: أن القدر عبارة عن جريان الأمور بنظام تأتي فيه الأسباب على قدر المسببات، والحذر من جملة الأسباب، فهو عمل بمقتضى القدر لا بما يضاده (10).
ويؤيد ذلك من السنة النبوية ما ورد أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله (11)، وذلك لأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره، وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباً، وهذا عام في جميع الحوادث (12).
إن قدر الله تعالى وقضاؤه غير معلومين لنا، إلا بعد الوقوع فنحن مأمورون بالسعي فيما عساه أن يكون كاشفاً عن موافقة قدر الله لمأمولنا، فإن استفرغنا جهودنا وحُرمنا المأمول علمنا أن قدر الله جرى من قبل على خلاف مرادنا ، فأما ترك الأسباب فليس من شأننا ، وهو مخالف لما أراد الله منا ، وإعراض عما أقامنا الله فيه في هذا العالم، وهو تحريف لمعنى القدر (13).
---------------------------------------------
مراجع الحلقة الثلاثون:
(1) فتح البري على صحيح البخاري (10 / 158) .
(2) سنن الترمذي (4 / 266) ، صحيح الإسناد.
(3) فتح الباري (10 / 160 ـ 161) .
(4) شعب الإيمان (2 / 81) ، السنن د. مجدي ص 219.
(5) مسلم (4 / 2050) ، السنن د. مجدي ص 218.
(6) صحيح مسلم بشرح النووي (16 / 196) .
(7) شفاء العليل لابن القيم ص 53.
(8) إحياء علوم الدين (3 / 202) ، الفتاوى لابن تيمية (8 / 69 ـ 70) .
(9) التفسير الكبير للرازي (5 / 308) .
(10) السنن الإلهية د. مجدي عاشور ص 210.
(11) سنن الترمذي (4 / 399) ، حسن صحيح.
(12) مجموع الحوادث (8 / 275) .
(13) تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور (4 / 138) .
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الإيمان بالقدر في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي: