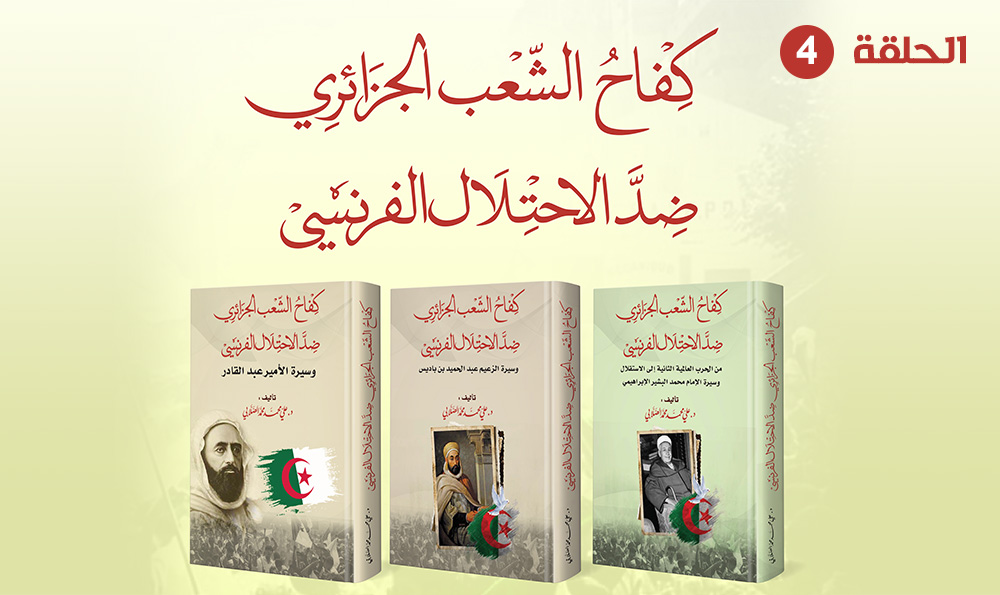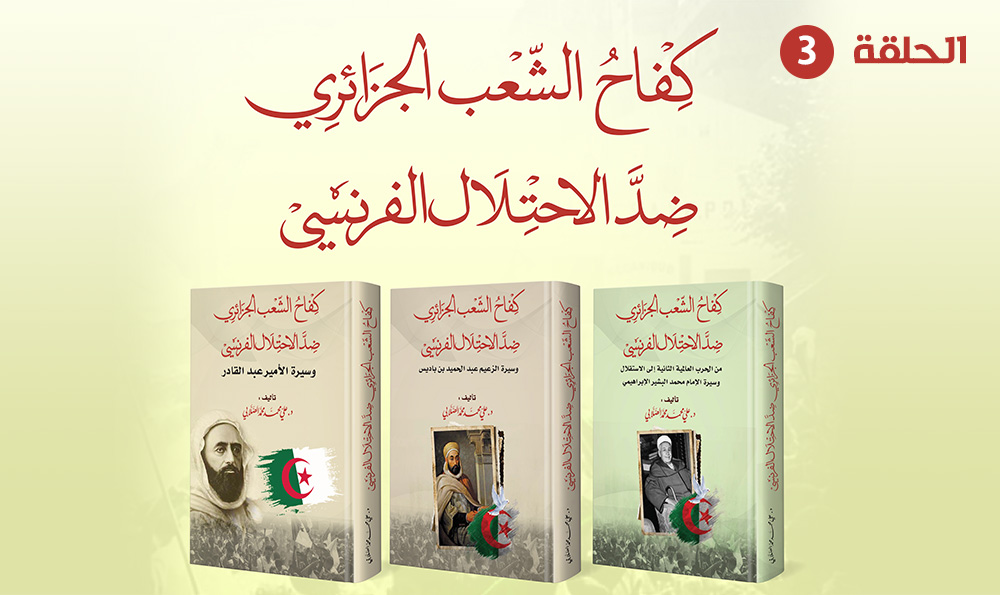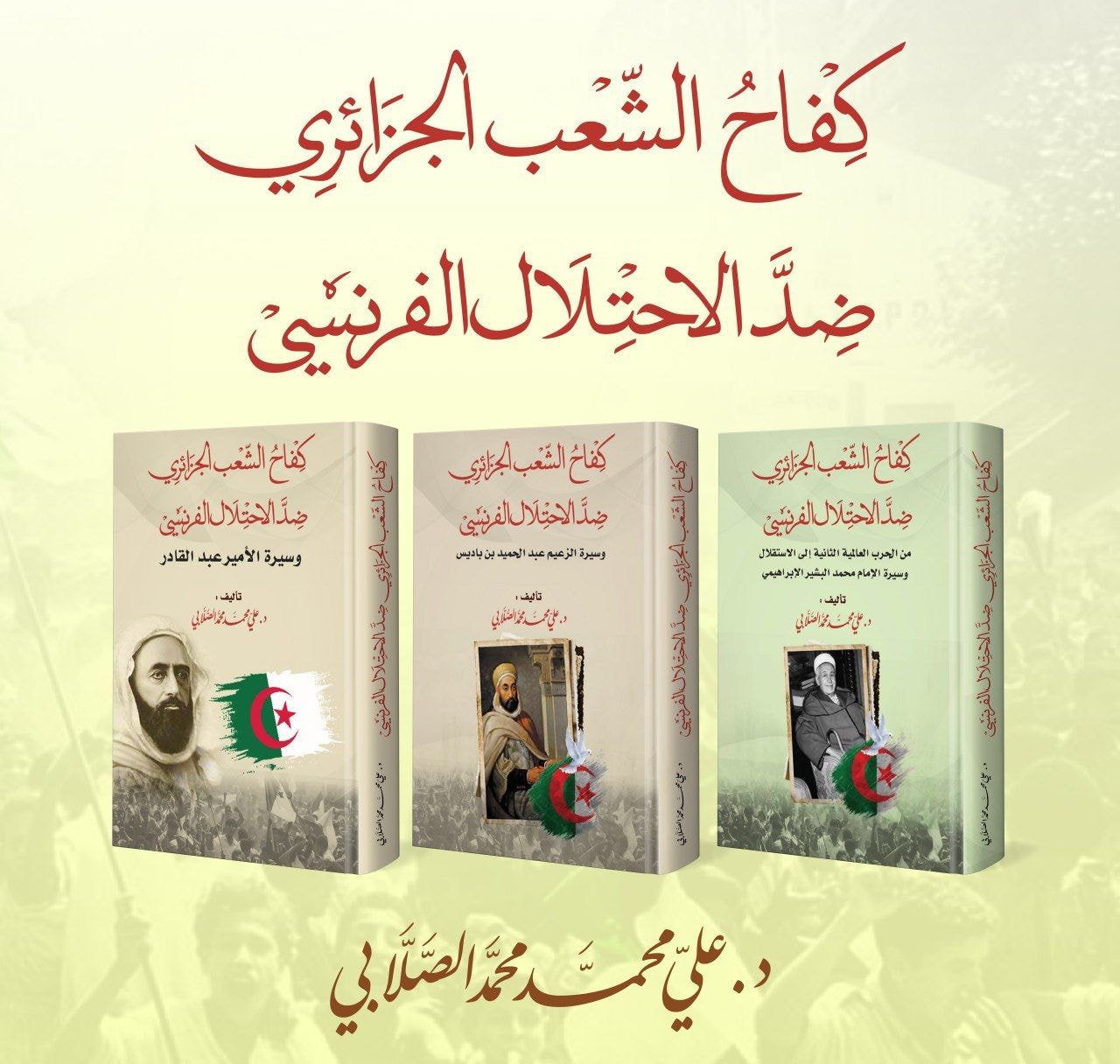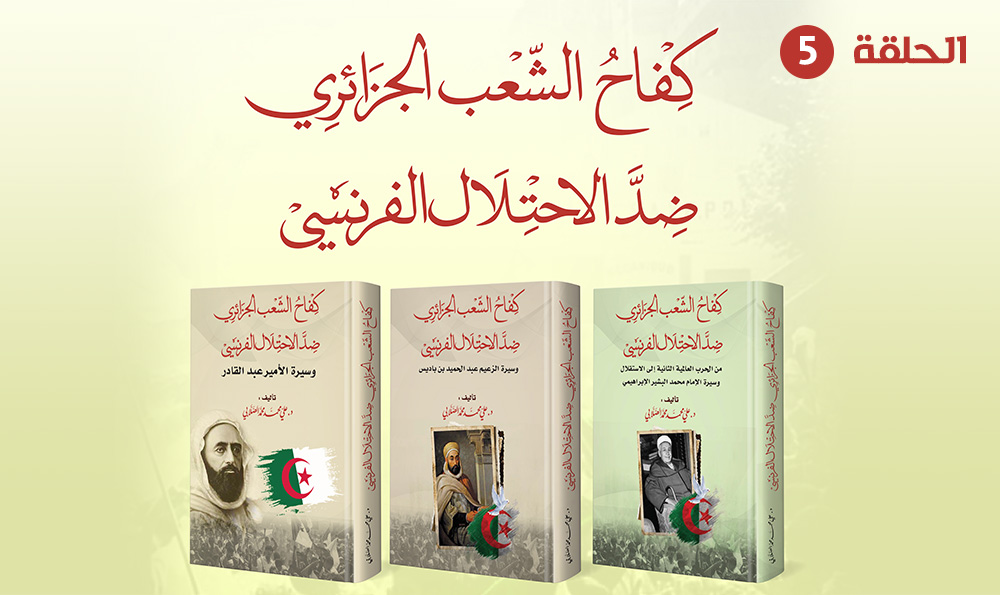من كتاب كفاح الشعب الجزائري، حلقة بعنوان
(دولة بني مرين والدولة الوطاسية والدولة السعّدية)
الحلقة: الرابعة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ سبتمبر 2020
أ ـ دولة بني مرين بالمغرب الأقصى:
استطاعت قبيلة بني مرين أن تسقط دولة الموحدين عام (668هـ/1269م) وهم يتفرعون من قبىء ل «زناتة» مثل «مغراوة» وبني «يفرن» وكانت مضاربهم في الصحراء الكبرى وتعتبر من القبىء ل البدوية المتنقلة، وقد تزعم هذه القبيلة زعماء اشتهروا بالصلاح والتقى وسلامة العقيدة والابتعاد عن الأفكار التومرتية المنحرفة، ومن أشهر زعمىء هم قبل الوصول إلى الدولة:
• عبد الحق بن محيو المريني:
كان عبد الحق أول من تزعم قبىء ل بني مرين ضد الدولة الموحدية، وأول من رسم الخطوط العريضة لدولة بني مرين، وكان قد اشتهر بالورع والتقى، وسلامة العقيدة، والابتعاد عن البدع، والأفكار الغربية، والتزم بالمذهب المالكي في سيرته.
وقد مات عبد الحق سنة (614هـ)، فخلفه بعده أبناؤه الأربعة: أبو سعيد عثمان، مات سنة (642هـ)، وأبو بكر عبد الحق، مات سنة (656هـ)، ويعقوب بن عبد الحق وهو الذي استطاع أن يقضي على الموحدين، وصار أمير المغرب سنة (668هـ/1269م) وكانت له سيرة جهادية مشرقة في الأندلس.
• المنهج الذي قامت عليه الدولة المرينية:
لا تستطيع أي حركة في المغرب أن تصل إلى القواعد الشعبية بدون رفع شعارات الإسلام، ولذلك من الطبيعي أن تستند دولتي بني مرين إلى كونهم حماة الإسلام والمسلمين، وقد أثبتت الأحداث صدق هذه الدعوة في وقوفهم مع مسلمي الأندلس ضد الخطر النصراني على دولة الإسلام هناك، إلا أن صدامهم مع الموحدين وانتصاراتهم المتتالية أقنعت بعض المؤرخين أن حركة المرينيين ذات دلالة سياسية أكثر منها دينية، وأنهم لم يكن لهم مذهب ديني يدعون له كالمرابطين والموحدين، وكانت شعاراتهم المرفوعة في حركتهم الانفصالية العمل على استتباب الأمن، والعمل لصالح الرعية.
ومن هنا كسبوا محبة الناس، إلا أن إقدام زعماء بني مرين على قتال الموحدين يدل على قناعتهم الراسخة بأن الموحدين ليسوا مؤهلين لقيادة المغرب، سواء من المنظور الشرعي أو السياسي، واتخذ زعماء بني مرين أسلوباً عسكرياً وسياسياً للوصول إلى الحكم وإسقاط الموحدين، حيث خاضوا معارك ضارية مع الموحدين، وحققوا انتصارات كبيرة عليهم. ومن أجل الحفاظ على تلك المكاسب والانتصارات استعملوا أسلوباً سياسياً بارعاً، تمثل في الاعتراف بالخلافة الحفصية في تونس وطلب العون منهم، وبذلك حققوا مكاسب متعددة، منها وقف خطر بني زيان القادم من الجزائر نحوهم، وقام بنو حفص بمساعدة بني مرين وتدمير تحالف بني زيان مع الموحدين، والاستيلاء على تلمسان عاصمة بني زيان عام (640هـ/1243م). ومن ذلك الموقف والتاريخ بدأ بنو مرين يحافظون على مظهر التبعية لبني حفص.
وعندما وصل السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور للحكم استقل بالإمارة والسلطنة وانفصل عن الحفصيين.
وقام أبو يوسف باستكمال بناء الدولة بجهود ضخمة وقوية من أجل تثبيت البناء الجديد، وفرض سيطرتها وقوتها على كافة الأقاليم، واستطاع في فترة قصيرة أن يحقق نجاحات واسعة فاستطاع أن يضبط الأمن، ويرعى مصالح العباد، وعمل على توحيد المغرب الأقصى، وضم كافة المدن التي كانت منفصلة عن دولة الموحدين.
ووضع خطوطاً دفاعية ضد الخطر الزياني القادم من الشرق واستطاع أن ينظم القبىء ل العربية، ويستخدمها في محاربة الأقاليم المنفصلة عن الدولة، واستطاع أن يضم سبتة وطنجة تحت حكمه، وبذلك ضمن مفتاح العبور إلى الأندلس، وضم إقليم سجلماسة للدولة في صفر (673هـ/1274م)، وبذلك أصبحت كل أراضي المغرب الأقصى تحت نفوذ الدولة المرينية، وأصبحت فاس عاصمة للدولة المرينية الجديدة. وفي عام (674هـ/1275م) أمر السلطان المريني ببناء عاصمة للدولة المرينية وسميت البيضاء، وأصبحت فاس القديمة مركزاً للتجارة والعلم.
• حركة التوحيد للشمال الإفريقي:
حاولت دولة بني مرين أن توحد الشمال الإفريقي تحت نفوذها، ودخلت في معارك عنيفة مع بني عبد الواد والحفصيين في المغرب الأوسط والأدنى.
واستطاع المرينيون في عصر أبي الحسن المريني (731هـ 752هـ/1331 ـ 1351م) وولده أبي عنان فارس (752هـ/1351م) أن يوحدوا الشمال الإفريقي بالقوة وعادت وحدة الشمال الإفريقي لمدة قصيرة، وأزال السلطان أبو الحسن بني زيان عن تلمسان في سنة (737هـ/1337م)، ثم أحسن إليهم وفرض لهم العطاء وتوقف عن التوسع لانشغاله بالجهاد في الأندلس، وعادت حركة التوسع في الشمال الإفريقي بعد هزيمته أمام النصارى في الأندلس، ودخل تونس في عام (748هـ/1347م) لتمتد مملكته من مصراته في ليبيا إلى السوس الأقصى وإلى رندة من عدوة الأندلس.
لم يتألف أبو الحسن الحفصيين والقبائل العربية بالمال والإحسان إليها، ففجروا ثوراتهم ضده واستطاعوا أن يهزموه على مقربة من القيروان.
وفي هذه الأثناء خرج عليه ولده أبو عنان، وطلب الزعامة لنفسه، واضطر أبو الحسن أن يتخلى عن السلطة في سنة (752هـ/1351م) ثم مات بعد شهور.
واصل أبو عنان حركة التوحيد لأقطار الشمال الإفريقي، وأزال دولة بني زيان سنة (753هـ/1352م) وتابع سيره إلى إفريقية، ودخل تونس في سنة (758هـ/1357م) إلا أن انفجار الثورات على مستوى المغرب كله خصوصاً في فاس، وطمع بعض أقربىء ه في السلطة جعله يعود إلى عاصمته، فوافاه الأجل في العام التالي.
وبوفاة أبي عنان انتهت المحاولات المرينية من أجل توحيد الشمال الإفريقي، وتقلص النفوذ المريني في المغربين الأوسط والأدنى، ثم زال النفوذ المريني من جهة الشرق، فلم يحاول السلاطين الذين جاؤوا بعده أن يقوموا بأية غزوة في الأقاليم. وبدأ التدهور في الدولة المرينية بعد وفاة أبي عنان، بسبب تسليم أمرها لسلاطين ضعاف ففقدوا المغربين الأدنى والأقصى. كما استولى البرتغاليون على مدينة سبتة (818هـ/1415م)، فكان هذا بداية لانهيار دولة بني مرين، ثم استولى البرتغاليون على جزء كبير من ساحل المغرب، واحتلوا طنجة سنة (869هـ/1464م) واقتصرت الدولة المرينية على فاس.
واضطربت أحوال الدولة بتعدد الثورات وتدهورت الأمور في فاس، وتسلط على الأمور رجال لا همَّ لهم إلا مصالحهم الشخصية، وفي عهد آخر سلاطين بني مرين عبد الحق بن أبي سعيد بن أبي العباس (823هـ 869هـ/ إلى 1320ـ 1465م) قرّب اليهود من مقاليد الحكم وسُلّطوا على رقاب الأهالي، فانفجرت الثورة التي عمت أحياء فاس كلها، واضطروا إلى مبايعة سلطان جديد، هو الشريف أبو عبد الله محمد بن علي الإدريسي نقيب الأشراف بفاس في رمضان (869هـ/1465م). وبذلك انتهت دولة بني مرين.
• أسباب سقوط بني مرين:
ـ دسائس ملوك الإسبان ضدها، وتحالف زعماء غرناطة معهم ضد دولة بني مرين ساهم في إضعافهم وتقويض دولتهم، ودخول حكام غرناطة في تحالفات مع بني عبد الواد والحفصيين ضد بني مرين ضيق الخناق على دولة بني مرين.
ـ دخول بني مرين في صراع عنيف مع دويلات المغرب الأوسط والأدنى، كلفها الأموال والرجال والعتاد والأوقات، وكان قتال بين أبناء العقيدة الواحدة والدين الواحد مما ساهم في إضعاف الشمال الإفريقي كله والتعجيل بسقوط دولة بني مرين.
ـ ضعف الأمراء والسلاطين في آخر عهد الدولة ؛ مما ساهم في إضعافها وتسلط الوزراء وزعماء العرب في شؤونها، وتنازعت الأهواء والمصالح، فتولدت انفجارات داخلية ونزاع الأبناء والاباء والأعمام مما عجل بسقوط الدولة.
ـ المخاطر الخارجية والمكىء د العالمية من قبل النصارى، والذين شنوا حرباً على هذه الدولة التي شكلت خطراً على حركة الاسترداد في الأندلس، ولذلك هاجم البرتغاليون بني مرين واحتلوا سبتة عام (818هـ/1415م)، فكان ذلك الاحتلال بداية الانهيار.
ـ تولي اليهود مناصب في دولة بني مرين، ومارس اليهود الظلم والجور على أهالي المغرب، فكان ذلك سبباً في قيام الشعب بثورة ضد دولة بني مرين وإزالتها من الوجود.
ـ أجل الله في هذه الدولة، لأن الدول لها اجال لا تتعداها، وغير ذلك من الأسباب.
ب ـ الدولة الوطاسية:
ترجع الدولة الوطاسية في نسبتها إلى بني وطاس وهم فرع من بني مرين، وكانوا أصحاب نفوذ وسلطان وشوكة في الدولة المرينية، وأنزل بهم السلطان عبد الحق ـ آخر سلطان للدولة المرينية ـ نكبة عظيمة، ونكّل بهم أشد التنكيل، واستطاع محمد الشيخ أن يفلت من تلك التصفية الجسدية التي نزلت بقومه، وبعد أن تولى حكم المغرب الشريف محمد بن علي الإدريسي في عام (868هـ/1465م)، استطاع محمد أن يجهز جيشاً لنزع السلطة والحكم من الإدريسي، ودخل في حروب طاحنة واحتل فاس عام (877هـ/1472م)، وكلفه ذلك ضياع مدينة أصيلا من يده.
واستغل البرتغاليون الحرب الأهلية القىء مة في المغرب وانصراف أمير أصيلا لمحاصرة فاس، فأرسلوا (877هـ) سفينة محملة بـ (30) ألف مقاتل في زمن ملك البرتغال ألفونس الخامس، ووقعت أسرة الشيخ الوطاسي في الأسر، فاضطر للمفاوضة معهم، وترتب على تلك المفاوضات تنازل الوطاسيين عن أراض من المغرب، واحتل البرتغاليون مدينة العرىء ش إلى جانب أصيلا، وأطلق سراح ابن السلطان محمد الشيخ وزوجاته.
كانت الفتن على أشدها في المغرب عندما تولى الحكم محمد الشيخ، واستطاع البرتغاليون النصارى أن يتوسعوا للاستيلاء على موانىء المغرب، مثل سبتة وطنجة وأصيلا، وتوغلت سراياهم وبعوثهم في الأطراف المجاورة التي احتلوها، وكان سقوط غرناطة في فترة الوطاسيين (1492 م) وقدم أهالي الأندلس في هجرات عظيمة نحو المغرب.
واستمر النفوذ الإسباني والبرتغالي في التوسع، وبناء الحصون والقلاع والمراكز والنقاط الاستراتيجية التي امتدت على سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، وكانت هذه الموانىء والحصون تتخذ كمراكز لتموين السفن والأساطيل البحرية البرتغالية والإسبانية في طريقها إلى الهند والشرق الأقصى، كما كانت هذه المراكز نقاطاً للتوسع إلى المناطق الداخلية في بلاد المغرب، وامتد نفوذ هذه المراكز إلى زعماء بعض القبىء ل والأهالي الذين تعاملوا معهم ووجدوا مصالحهم الذاتية في الخضوع لهم.وقامت إمارات عديدة في المغرب الأقصى حملت على كاهلها مقاومة النفوذ الأجنبي في البلاد.
وظهرت قيادة السعديين كقوة حيوية، لكنها رفعت لواء الجهاد، ودعت إلى الوحدة المغربية، وتدرجت في تحقيق أهدافها، واستطاعت أن تكسب ودّ الطرق الصوفية وزعماء القبىء ل، وتخوض حرباً جهادية ضد النصارى الإسبان والبرتغاليين، وحرّروا الأراضي المحتلة، وبرز الزعيم محمد الشيخ السعدي الهاشمي القرشي في تلك المعارك، واستطاع أن يسقط دولة الوطاسيين عام (956هـ).
إلا أن أبا حسون الوطاسي الذي فرّ من السعديين استطاع أن يتحالف مع العثمانيين ويهزم السعديين في فاس عام (961هـ)، وأعاد زعيم السعديين الكرة من جديد وأسقط الدولة الوطاسية في نفس العام (961هـ).
• أسباب سقوط الدولة الوطاسية:
ـ دخولهم في معاهدات مع النصارى المحتلين، من الإسبان والبرتغاليين، من أجل مصالحهم وسلطتهم ونفوذهم.
ـ عجزهم عن الوقوف بجانب مسلمي الأندلس، والدفاع عنهم وحمايتهم.
ـ ظهور الحركة الجهادية التي جعلت أهداف الشعب المغربي في أولوياتها ؛ وقد تزعم تلك الحركة السعديون.
ـ الضعف الاقتصادي الذي أصاب الدولة بسبب استيلاء النصارى على الحركة التجارية في الموانىء .
ـ التفكك السياسي بسبب الحروب الداخلية الطاحنة بين المغاربة.
ج ـ السعديون:
يرجع أصل السعديين إلى الجزيرة العربية، ويرجعون في نسبهم إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويرى الأستاذ محمود شيت خطاب أن الدولة السعدية هي الدولة العلوية الثانية في المغرب بقطع النظر عما أرجف به خصومها من الطعن في نسبها، وهي لم تعتمد في قيامها إلى «مهدوية» كاذبة أو عصبية قوية.
وأما تسميتهم بالسعديين، فيرى الأستاذ شوقي أبو خليل أنها لم تكن لهم في القديم، ولم تظهر في سجلاتهم ورسائلهم، بل لم يجترأ أحد على مواجهتهم بهذه التسمية لأنهم إنما يصفهم بها من يقدح في نسبهم ويطعن في شرفهم، ويزعم أنهم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حليمة السعدية ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكثير من العامة يعتقدون أنهم سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم، ثم استدل بقول أبي العباس الناصري السلاوي:«وإنما نصفهم نحن بذلك لأنهم اشتهروا عند الخاصة والعامة، فصار كالعلم الصرف المرتجل، مع أنه لا محذور بعد تحقيق النسب وثبوت الشرف».
وأما صاحب موسوعة المغرب العربي الدكتور عبد الفتاح الغنيمي فقد ذكر نسب محمد القىء م السعدي، مؤسس الأسرة السعدية، ورافع لواء الجهاد الإسلامي، فقال: هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن مخلوق بن زيدان بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
كانت بواعث الالتفاف حول الزعامة السعدية تتمثل في حب المغاربة للجهاد ودحر المعتدين، ولذلك بحثت قبىء ل المغاربة عن شخص يقودهم في حركة الجهاد ضد المحتلين النصارى من الإسبان والبرتغال، فأرشدوا إلى الشريف أبي عبد الله محمد القىء م بأمر الله، وكان مقيماً في درعة فأرسلوا إليه فجاء إليهم، واجتمع فقهاء المصامدة وشيوخ القبىء ل وبايعوه، فكان هو واضع النواة الأولى للدولة السعدية، وشرع في حركة الجهاد، ووفقه الله في معارك ضارية، وحقق انتصارات رىء عة على النصارى، وزحزح أقدام الغزاة النصارى من أراضي المغرب وأصاب هيبتهم، فتيمن المسلمون بقيادته، وتفاءلوا بانتصاراته الرىء عة وظل في جهاده المبارك إلى أن توفاه الله سنة (923هـ)، وخلف ولدين، وكان أبو العباس أحمد الأعرج أكبرهم، فبايعه الناس بعد والده، وحارب البرتغاليين وانتصر عليهم. وفي سنة (930هـ) دخل مراكش وجعلها عاصمة السعديين. وفي سنة (940هـ) اتفق مع الوطاسيين على اقتسام المغرب، على أن يكون نصيب الأشراف السعديين من «تادلة» إلى «السوس»، وللوطاسيين من «تادلة» إلى المغرب الأوسط.
وانتزع أبو عبد الله محمد الشيخ، الأخ الأصغر، المُلك من أخيه وألقى القبض عليه، واستطاع أن يقبض على الوطاسيين سنة (961هـ) ودخل مدينة فاس فصفا له ملك المغرب، ولكنه قتل سنة (964هـ). وتولى زمام الأمور من بعده ابنه عبد الله الغالب، فحارب الأتراك والبرتغاليين وتوفي سنة (981هـ) ، فقام على العرش بعده ولده محمد المتوكل، وكان فظاً غليظاً مستبداً ظالماً، قتل اثنين من إخوته عند وصوله إلى الحكم، وأمر بسجن آخر فكرهته الرعية، وصفه السلاوي بقوله: وكان السلطان المذكور فقيهاً أديباً مشاركاً مجيداً قوي العارضة في النظم والنثر، وكان مع ذلك متكبراً تياهاً غير مبال بأحد، ولا متوقف في الدماء، إلا أن هذا المتعجرف السفاك للدماء لم يهنأ بملكه، حيث استطاع عمه أبو مروان عبد الملك، وأبو العباس أحمد أن يتحالفوا مع الأتراك في الجزائر، وسافر أبو مروان عبد الملك إلى عاصمة الخلافة العثمانية، وطلب من السلطان سليم نجدته ومعونته، إلا أن السلطان العثماني انشغل بتخليص تونس من يد الإسبان، فجهز قوات عثمانية بقيادة سنان باشا، واستطاعت أن تحرّر تونس من الاحتلال النصراني الإسباني، وكان أبو مروان عبد الملك في تلك الحملة وأبلى فيها بلاء حسناً، ثم كان هو أول من أبلغ بشارة الفتح إلى السلطان، فجازاه على ذلك بأن أمر صاحب الجزائر بمدّه بالجنود والعتاد حتى يرجع إليه حقه المغصوب في الحكم.
وما أن وصل جيش عبد الملك المدعوم من قبل الخلافة العثمانية فاس حتى خرج إليه ابن أخيه محمد المتوكل على الله، واستطاع عبد الملك أن يستميل القوّاد والوزراء فانقادوا إليه جميعاً، وبايع أهلُ المغرب عبدَ الملك بن محمد الشيخ سنة (983هـ).
• من إصلاحات عبد الملك وأعماله:
ـ أمر بتجديد السفن، وبصنع المراكب الجديدة، فانتعشت بذلك الصناعة عامة.
ـ اهتم بالتجارة البحرية، وكان للأموال التي غنمها من الحروب الدىء مة على سواحل المغرب سبب في انتعاش ونمو الميزان التجاري للدولة.
ـ أسس جيشاً نظامياً متطوراً واستفاد من خبرة الجندية العثمانية وتشبه بهم في التسليح والرتب.
ـ استطاع أن يبني علاقات متنية مع العثمانيين، وجعل منهم حلفاء وأصدقاء وإخوة مخلصين للمسلمين في المغرب.
ـ فرض احترامه على أهل عصره حتى الأوروبيين احترموه وأجلُّوه.
قال الشاعر الفرنسي أكبريبا دو بيني المعاصر لأحداث هذه الفترة: كان عبد الملك جميل الوجه، بل أجمل قومه، وكان فكره نيراً بطبيعته، وكان يحسن اللغات الإسبانية والإيطالية والأرمينية والروسية، وكان شاعراً مجيداً في اللغة العربية، وباختصار، فإن معارفه لو كانت عند أمير من أمرىء نا لقلنا إن هذا أكثر مما يلزم بالنسبة لنبيل، فأحرى للملك.
ـ اهتم بتقوية مؤسسات الدولة ودواوينها وأجهزتها، واستطاع أن يشكل جهازاً شورياً للدولة، وأصبح على معرفة بأمور الدولة الداخلية وأحوال السكان عامة، وعلى اطلاع ودراية بالسياسة الدولية، وخاصة الدول التي لها علاقة بالسياسة المغربية، وكان أخوه أبو العباس أحمد المنصور بالله الملقب في كتب التاريخ بالذهبي ساعِدَه الأيمن في كل شؤون الدولة.
• معركة وادي المخازن:
إن من الأعمال العظيمة التي قامت بها الدولة السعدية في زمن السلطان عبد الملك انتصارهم الرىء ع والعظيم على نصارى البرتغال في معركة الملوك الثلاثة، والتي تسمى في كتب التاريخ معركة القصر الكبير، أو معركة وادي المخازن بتاريخ (30 جمادى الثانية هـ/الموافق: 4 اب «اغسطس» 1578م).
ولقد كان لتلك المعركة أسباب من أهمها:
ـ أراد البرتغاليون أن يمحوا عن أنفسهم العار والخزي الذي لحقهم بسبب ضربات المغاربة الموفقة والتي جعلتهم ينسحبون من أسفى وأزنور وأصيلا وغيرها، في زمن يوحنا الثالث اب (1521 ـ 1557م).
ـ أراد ملك البرتغال الجديد سبستيان بن يوحنا أن يخوض حرباً مقدسة ضد المسلمين حتى يعلو شأنه بين ملوك أوروبا، وزاد غروره بعد ما حققه البرتغاليون من اكتشافات جغرافية جديدة، أراد أن يستفيد منها من أجل تطويق العالم الإسلامي، يدفعه في ذلك حقده على الإسلام وأهله عموماً، وعلى المغرب خصوصاً، لقد جمع ذلك الملك البرتغالي بين الحقد الصليبي والعقلية الاستعمارية التي ترى أن يدها مطلقة في كل أرض مسلمة تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي. من جهة أخرى فخطط لغزو واحتلال المغرب.
وشجع ملك البرتغال مجيء المتوكل (المخلوع) وطلبه للعون من النصارى، والوقوف معه من أجل استرداد ملكه، والقضاء على عمَّيه عبد الملك المعتصم بالله، وأحمد المنصور، مقابل أن يتنازل له عن موانىء وشواطىء المغرب، فشرط عليه أن يكون للنصارى سىء ر السواحل، وله ما وراء ذلك .
• حشود النصارى:
استطاع سبستيان أن يحشد من النصارى عشرات الألوف من الإسبان والبرتغاليين والطليان والألمان، وجهز هذه الألوف بكافة الأسلحة الممكنة في زمنه، وجهز ألف مركب لتحمل هؤلاء الجنود نحو المغرب.
ووصلت قوات النصارى إلى طنجة وأصيلا في عام (1578م).
ـ الجيش المغربي:
كانت الصيحة في جنبات المغرب الأقصى: أن اقصدوا وادي المخازن للجهاد في سبيل الله.
والتفت جموع المغاربة حول قيادة عبد الملك المعتصم بالله، وحاول المتوكل المسلوخ أن يخترق هذا التلاحم، فكتب إلى أهل المغرب: ما استصرخت بالنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين، وقد قال العلماء: إنه يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقه بكل ما أمكنه، وتهددهم قائلاً: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة :279].
فأجابه علماء الإسلام عن رسالته، برسالة دحضت أباطيله، وفضحت زوره وبهتانه وكذبه، ومما جاء فيها: الحمد لله كما يجب لجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أنبيىء ه ورسله، والرضى عن اله وأصحابه الذين هجروا دين الكفر، فما نصروه ولا استنصروا به حتى أسس الله دين الإسلام بشروط صحته وكماله، وبعد ؛ فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أهل المغرب، لو رجعت على نفسك باللوم والعتاب لعلمت أنك المحجوج والمصاب.
وأما قولك في النصارى، فإنك رجعت إلى أهل العداوة، واستعظمت أن تسميهم بالنصارى، ففيه المقت الذي لا يخفى، وقولك: رجعت إليهم حين عدمت النصرة من المسلمين ففيه محظوران يحضر عندهما غضب الرب جل جلاله، أحدهما: كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلال، وأن الحق لم يبق من يقوم به إلا النصارى، والعياذ بالله، والثاني: أنك استعنت بالكفار على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: «إني لا أستعين بمشرك...» الاستعانة بهم ـ بالمشركين ـ على المسلمين فلا يخطر إلا على بال من قلبه وراء لسانه، وقد قيل قديماً: لسان العاقل من وراء قلبه... وقولك: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ايه أنت مع الله ورسوله؟
ولما سمعت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والعجم قولك هذا حملتهم الغيرة الإسلامية والحمية الإيمانية، وتجدد لهم نور الإيمان، وأشرق عليهم شعاع الإيقان، فمن قىء ل يقول: لادين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قىء ل يقول: سترون ما أصنع عند اللقاء، ومن قائل يقول: {وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ *} [العنكبوت :11].
وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم وقيامهم معك، وعوَّلت على بلوغ الملك بحشودهم، وأنى لك هذا مع قول الله تعالى: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ *} [التوبة :32].
ولما عاين أهل القصر الكبير النصارى، واستبطؤوا وصول السلطان عبد الملك ؛ أرادوا الفرار والتحصن في الجبال، فقام الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي بتثبيت الناس، وكتب عبد الملك المعتصم بالله من مراكش إلى سبستيان: إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك، وجوازك العدوة، فإن ثبتَّ إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإلا فأنت كلب ابن كلب. فليس من الشجاعة، ولا من روح الفروسية أن تنقض على سكان القرى والمدن والعزل، ولا تنتظر مقابلة المحاربين. وكان لذلك الخطاب أثر في غضب سبستيان، وقرر أخيراً التريث رغم مخالفة أركان جيشه ؛ الذين أشاروا عليه بالتقدم لاحتلال تطوان والعرايش والقصر، وتحركت قوات عبد الملك المعتصم بالله، وسار أخوه أحمد المنصور بأهل فاس وما حولها وكان اللقاء قرب محلة القصر الكبير.
• قوات الطرفين (البرتغالي النصراني والإسلامي المغربي):
ـ الجيش البرتغالي:
(125000)، وما يلزمهم من المعدات، والرواية الأوربية تقلل بعد الهزيمة عدد جيشها، وتضخم عدد جيش المغرب فهي تتحدث عن (14000)، راجل، و(2000) فارس، و(36) مدفعاً، مقابل: (50000) راجل من الجيش المغربي، و(22000) فارس، و(15000) من الرماة، و(20) مدفعاً.
ذكر أبو القاض في (المنتقى المقصور): عدد الجيش البرتغالي مئة ألف وخمسة وعشرون ألفاً.
وقال أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في (مراة المحاسن): إن مجموعهم كان مئة ألف وعشرين ألفاً، وأقل ما قيل في عددهم ثمانون ألف مقاتل.
كان مع الجيش البرتغالي: (20000) إسباني، (3000) ألماني، (7000) إيطالي وغيرهم عدد كبير، مع ألوف الخيل، وأكثر من أربعين مدفعاً. وكل هذه القوى البشرية والمادية بقيادة الملك سبستيان، وكان معهم المتوكل المسلوخ بشرذمة تتراوح ما بين: (300 ـ 600) رجل على الأكثر.
ـ الجيش المغربي:
وكان جيش المغاربة تعداده (40000) مجاهد، يملكون تفوقاً في الخيل، ومدافعهم أربعة وثلاثون مدفعاً فقط، وكانت معنوياتهم مرتفعة جداً بسبب:
ـ أنهم ذاقوا حلاوة الانتصار على النصارى المحتلين، واستخلصوا من أيديهم ثغوراً كثيرة، كانت محاطة بالأسوار العالية، والحصون المنيعة، والخنادق العميقة.
ـ التفاف الشعب حول القيادة، حيث تم التحام بين القبىء ل والطرق الصوفية وأهل المدن ؛ لأن المعركة كانت حاسمة في تاريخ الإسلام، وفاصلة في تاريخ المغرب، وكان الشيخ أبو المحاسن الفاسي زعيم الطريقة الشاذلية الجزولية لا يكل ولا يمل في شحذ الهمم ورفع المعنويات، وقاد هذا الشيخ (أبو المحاسن يوسف الفاسي) أحد جناحي الجيش المغربي، وأبلى بلاءً حسناً رىء عاً، وثبت إلى أن منح الله المسلمين النصر، وركبوا أكتاف العدو يقتلون ويأسرون، وتورع أبو المحاسن عن الغنيمة بعد الانتصار العظيم، وعف عنها، ولم يأخذ منها شيئاً.
وأظهر عبد الملك المعتصم بالله عبقرية فذة في المعركة، وكذلك أخوه أبو العباس أحمد الذهبي.
لقد حنكت التجارب عبد الملك المعتصم بالله، فعزل عدوَّه عن أسطوله بالشاطئ بمكيدة عظيمة، وخطة مدروسة حكيمة، عندما استدرج سبستيان إلى مكان حدده عبد الملك ميداناً للمعركة، وكان عزله عن أسطوله محكماً عندما أمر عبد الملك بالقنطرة أن تهدم، ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه المنصور فهدمها.
لقد جعل عبد الملك المدفعية في المقدمة، ثم صفوف الرماة المشاة، وجعل قيادته في القلب وعلى المجنبتين رماة الفرسان والقوى الإسلامية المتطوعة، وجعل مجموعة من الفرسان كقوة احتياطية لتنقض في الوقت المناسب وهي غاية الراحة لمطاردة فلول البرتغاليين، واستثمار النصر.
كان صباح (الاثنين 30 جمادى الاخرة 986هـ/1578م) يوماً مشهوداً في تاريخ المغرب، ويوماً خالداً في تاريخ الإسلام، وقف السلطان عبد الملك المعتصم بالله خطيباً في جيشه، مذكراً بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصر.
قال تعالى: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ *} [الحج :40].
وقال تعالى: {وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *} [الأنفال :10].
كما ذكر بوجوب الثبات:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ *} [الأنفال :15].
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *} [الأنفال :45].
وبضرورة الانتظام:
{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ *} [الصف :4].
وذكر أيضاً حقيقة لا مراء فيها: إن انتصرت الصليبية اليوم، فلن تقوم للإسلام بعدها قىء مة.
ثم قرئت آيات كريمة من كتاب الله العزيز، فاشتاقت النفوس للشهادة.
ولم يأل القسيس والرهبان جهداً في إثارة حماس جند أوروبا الذين يقودهم سبستيان، مذكرين أن البابا أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب ؛ التي اتسمت بطابع الحروب الصليبية.وانطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين كليهما إيذاناً ببدء المعركة.
لقد قام السلطان عبد الملك برد الهجوم الأول، منطلقاً كالسهم شاهراً سيفه، يمهد الطريق لجنوده إلى صفوف النصارى، وغالبه المرض الذي سايره من مراكش، ودخل خيمته وما هي إلا دقىء ق حتى فاضت روحه في ساحة الفدى، لقد رفض أن يتخلف عن المعركة قىء لاً: ومتى كان المرض يثني المسلمين عن الجهاد في سبيل الله؟ وأمر هذا القىء د المجاهد عجيب في الحزم والشجاعة، ولقد فاضت روحه وهو واضع سبابته على فمه، مشيراً أن يكتموا الأمر حتى يتم النصر، ولا يضطربوا وكان كذلك، فلم يعلم أحد بموته إلا أخوه المنصور، وحاجبه رضوان العلج، وصار حاجبه يقول للجند: السلطان يأمر فلاناً أن يذهب إلى موضع كذا، وفلاناً يلزم الراية، وفلاناً يتقدم وفلاناً يتأخر.
وقاد أحمد المنصور مقدمة الجيش، وصدم مؤخرة الجيش البرتغالي، وأوقدت النار في برود النصارى، وصدم المسلمون رماتهم، فتهالك قسم منهم صرعى، وولى الباقون الأدبار، قاصدين قنطرة نهر وادي المخازن، وكانت تلك القنطرة أثراً بعد عين، نسفها المسلمون بأمر سلطانهم فارتموا بالنهر، فغرق من غرق، وأسر من أسر، وقتل من قتل، وصرع سبستيان وألوف ممن حوله، ووقع المتوكل رمز الخيانة غريقاً في نهر وادي المخازن، واستمرت المعركة أربع ساعات وثلث الساعة، وكتب الله فيها النصر للإسلام والمسلمين.
جاء في «درة السلوك» لأحمد بن القاضي، وهو معاصر لأحداث المعركة «مخطوطة بدار الوثىء ق بالرباط»:
وابن أخيهبالنصارى اعتصما وصار يستنجدهم لمن سما
أجابه اللعين بستيان بجيشه ومعه الأوثان
وعدد الجيوش الذي جمعا ينيف عن مئة ألف سُمعا
فقيض الله له المنصورا ملكاً شجاعاً أسداً هصورا
فخلص الإسلام من يد اللعين بصبره على لقاء المشركين
وما منهم إلا قتيل وأسير في ساعة من الزمان ذا شهير
مات بها بستيان اللعين فما له عن الرّدى معين
ثم محمد الذي أتى به مات غريقا يومه فانتبه
لحكمة الله العظيم القاهر أفادهم وزيَّن المنابر
بذكر عمّه أبي العباس الحازم الرأي شديد البأس
نجل الرسول المصطفى المختار به زها المغربُ على الأقطار
• أسباب نصر وادي المخازن:
ـ القيادة الحكيمة التي تمثلت في زعامة عبد الملك المعتصم بالله وأخيه أبي العباس، وفي حاجبه المنصور، وظهور مجموعة من القادة المحنكين من أمثال: أبي علي القوري، والحسين العلج، ومحمد أبي طيبة، وعلي بن موسى، الذي كان عاملاً على العرىء ش.
ـ التفاف الشعب المسلم المغربي حول قيادته، بسبب الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي والذي استطاع أن يبعث روح الجهاد في القوى الشعبية.
ـ رغبة المسلمين في الذود عن دينهم وعقيدتهم وأعراضهم، والعمل على تضميد الجراح بسبب سقوط غرناطة، وضياع الأندلس، والانتقام من النصارى الذين عذبوا المسلمين المهاجرين الذين تحت حكمهم في الأندلس.
ـ اشتراك خبراء من العثمانيين تميزوا بالمهارة في الرمي بالمدفعية، وشارك كذلك مجموعة من الأندلسيين تميزوا بالرمي والتصويب بدقة ؛ مما جعل المدفعية المغربية تتفوق على المدفعية البرتغالية النصرانية.
ـ الخطة المحكمة التي رسمها عبد الملك المعتصم بالله مع قادة حربه، حيث استطاع أن يستدرج خصومه إلى ميدان تجول فيه الخيل وتصول، مع قطع طرق تموينه وإمداده، ثم نسفه للقنطرة الوحيدة على نهر وادي المخازن.
ـ القدوة والأسوة المثالية التي ضربها للناس كل من عبد الملك واخيه أحمد المنصور، حيث شاركوا بالفعل والسنان في القتال، فكان حالهما له أثر أشد في أتباعهم من قولهم
ـ تفوق القوات المغربية بالخيل، حيث استطاع الفرسان أن يستثمروا النصر، ويطوقوا النصارى المنهزمين، ومنعتهم خيل المسلمين الخفيفة الحركة من أي فرصة في الفرار.
ـ استبداد سبستيان بالرأي، وعدم الأخذ بمشورة مستشاريه، وكبار رجال دولته مما جعل القلوب تتنافر.
ـ وعي الشعب المغربي المسلم بخطورة الغزو النصراني البرتغالي، وقناعته بأنه جهاد في سبيل الله ضد غزو صليبي حاقد.
ـ دعاء وتضرع المسلمين لله بإنزال النصر عليهم، وخذل وهزيمة أعدىء هم وغير ذلك من الأسباب.
• نتائج المعركة:
ـ أصبح سلطان المغرب بعد عبد الملك أحمد المنصور بالله الملقب بالذهبي، وبويع بعد الفراغ من القتال بميدان المعركة، وذلك يوم (الاثنين 30 جمادى الآخرة سنة 986هـ).
ـ وصلت أنباء الانتصار بواسطة رسل السلطان أحمد الذهبي إلى مقر السلطنة العثمانية في زمن السلطان مراد خان الثالث، وإلى سىء ممالك الإسلام المجاورة للمغرب، وحل السرور بالمسلمين وعم السعد في ديارهم، ووردت الرسل من سىء ر الأقطار مهنئين ومباركين للشعب المغربي نصرهم العظيم.
ـ ارتفع نجم الدولة السعدية في أفق العالم، وأصبحت دول أوروبا تخطب ودّها، واضطر ملك البرتغال الجديد "الريكي" أن يرسل وفداً إلى المغرب، وكذلك ملك الإسبان محملة وفودها بالهدايا الثمينة. ثم قدمت رسل السلطان العثماني مهنئة ومباركة، ومعهم هداياهم الثمينة، وبعدها رسل ملك فرنسا، وأصبحت الوفود «تصبح وتمسي على أعتاب تلك القصور».
ـ سقط نجم نصارى البرتغال في بحار المغرب، واضطربت دولتهم، وضعفت شوكتهم، وتهاوت قوتهم.
يقول لويس مارية ـ المؤرخ البرتغالي ـ واصفاً نتىء ج المعركة:
وقد كان مخبوءاً لنا في مستقبل الأعصار، العصر الذي لو وصفته ـ كما وصفه غيري من المؤرخين ـ لقلت: هو العصر النحس البالغ في النحوسة، الذي انتهت فيه مدة الصولة والظفر والنجاح، وانقضت فيه أيام العناية من البرتغال، وانطفأ مصباحهم بين الأجناس، وزال رونقهم، وذهبت النخوة والقوة منهم، وخلفها الفشل، وانقطع الرجاء واضمحل إبان الغنى والربح، وذلك هو العصر الذي هلك فيه سبستيان في القصر الكبير في بلاد المغرب.
ـ مات في تلك المعركة ثلاثة ملوك، صليبي غازي سبستيان ملك البرتغال، ملك مخلوع خائن محمد المتوكل، مجاهد شهيد عبد الملك المعتصم بالله.
ـ سارع البرتغاليون النصارى بفكاك أسراهم ودفعوا أموالاً طىء لة للدولة السعدية.
ـ سادت فترة هدوء ورخاء وبناء وازدهار في العلوم والفنون والصناعات في بلاد المغرب.
ـ حدث تحول جذري في التفكير والتخطيط ـ على مستوى أوروبا. حيث رأوا أهمية إتقان الغزو الفكري لبلاد المسلمين، لأن سياسة الحديد والنار تحطمت أمام إرادة الشعوب الإسلامية في المشرق والمغرب.
• السلطان أبو العباس أحمد المنصور بالله الذهبي:
ولد أبو العباس أحمد المنصور بالله بفاس سنة (956هـ/1549م). أبوه محمد المهدي، وأمه بربرية الأصل لها أوقاف بمراكش معروفة لدى المغاربة.
درس في مراكز علمية عديدة ومن أهم هذه المراكز: «فاس، ومراكش بتاورددانت..» ودرس علوم اللغة والأدب والتاريخ والتراجم والفقه والحديث والمنطق والبلاغة والفلك والرياضيات والأصول والتفسير.
ـ إدارته للدولة:
استمر على منهج أخيه في بناء المؤسسات واقتناء ما وصلت إليه الكشوفات العلمية وتطوير الإدارة والقضاء والجيش، وترتيب وتنظيم الأقاليم التابعة للدولة.
وكان أحمد المنصور يتابع وزراءه وكبار موظفيه، ويحاسبهم على عدم المحافظة على أوقات العمل الرسمية، أو التأخير في الرد على المراسلات الإدارية والسياسية، وأحدث حروفاً برموز خاصة لكتابة المراسلات السرية ؛حتى لا يعرف فحواها إذا وقعت في يد عدو، وهذا يدل على اهتمامه الشخصي بجهاز الأمن والاستخبارات ؛ التي تحمي به الدولة نفسها من الأخطار الداخلية والخارجية، واهتم بالجهاز القضائي، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تماماً، ومنع السلطة التنفيذية من التدخل في السلطة القضائية.
وقد قارن مؤرخ فرنسي بين القضاء الأوروبي والقضاء المغربي عهد السعديين فقال: في الوقت الذي كانت أوروبا ـ في العصر السعدي ـ يحتفظ الملوك فيها وحدهم بحق الحكم في عدد من القضايا، فإن الملوك السعديين لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة ضد رجال السلطة، وهذا ما كان يدعى بقضاء المظالم.
وترأس أحمد المنصور مجلس المظالم، وجعله في جامع القصبة في مراكش، بجوار قصره، وشكل لجنة تراقب مجرى القضاء في الأقاليم، ويهتم بمطالعة ودراسة تقاريرهم بعناية، واهتم بضبط الإدارة، وإحكام دولته، وإقامة العدل على رعاياه.
وعمل على إقامة محطات في أرجاء البلاد، يحرسها جنود مقيمون، لا يبعد بعضهم عن بعض إلا بمسافة عشرين كيلو متراً، بحيث يستطيع المسافرون والقوافل أن يعبروا القرى والبوادي بأمن وسلام.
وطوّر عمل المؤسسات الاستشارية، وأوجد مجلس الديوان، أو مجلس الملأ، واختصاصاته سياسية وقضىء ية وعسكرية، وهو أعلى مرجع قانوني للبلاد، إلا إنه لا يستطيع أن يتجاوز أحكام السلطة القضىء ية، ولو كانت ضد المجلس كله، أو بعض رجاله، وكان مجلس الديوان من المرونة وسعة الأفق، بحيث يسمح بدخول المختصين، أو ممثلي المدن والمراكز القروية عندما يقتضي الأمر استشارات على نطاق شعبي واسع.
وطور السلطان أحمد المنصور جيش دولته، واقتدى بالنظام العثماني في التسليح والرتب واللباس، واهتم بإسناد القيادات لمن أظهر كفاءة عسكرية عالية، وأثبتت الأيام أنه أهل لذلك، ومن أهم هذه القيادات: إبراهيم بن محمد السُفياني قىء د الجبهة الأمامية في وادي المخازن، وأحمد بن بركة، وأحمد الحداد العمري المعقلي، ودعّم جيشه بالوحدات الطبية من جراحين وغيرهم، وأقام مستشفيات متنقلة ميدانية تستقبل الجرحى والمرضى في الحروب، واهتم بتأهيل التقنيين المتخصصين في جيشه، وقام السعديون ببناء دار العدة لصناعة المدافع، واهتموا بتطوير الأسطول، خصوصا في ميناءي العرىء ش وسلا.
ومد نفوذ الدولة السعدية نحو الجنوب، وضم بلاد السودان الغربي إلى نفوذه، ودخل لعبة الموازنات الدولية بين الإسبان والإنجليز والأتراك، وظهرت منه مواهب سياسية متميزة واستطاع أن يحقق الأمن والازدهار والرفاه والخصب لبلاده.
• انهيار الدولة السعدية:
بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي في عام (1012هـ/1603م) دخل المغرب في حالة من الضعف والتفكك، ال به الأمر إلى سقوط الدولة السعدية، وقد كان لذلك السقوط عدة عوامل منها:
ـ الصراع المرير على كرسي الحكم بين أبناء الأسرة السعدية من الأسباب القوية التي عجلت بنهاية الأسرة سريعاً وانهيارها.
ـ ساهم ذلك الصراع في قيام الثورات والحركات الانفصالية والإمارات المستقلة عن الحكومة المركزية في المغرب الأقصى، وانشغل الأمراء السعديون بالصراع فيما بينهم عن أحوال الرعية والعدو الخارجي.
ـ دخلت الولايات والإمارات المنفصلة في نزاع عسكري فيما بينها من أجل الحدود والتوسع، كل إمارة على حساب الأخرى، ولم تكن هذه الإمارات في وئام فيما بينها.
ـ ظهور إمارة قوية بقيادة الأسرة العلوية الشريفة أخذت تسعى لتوحيد المغرب.
ـ تولى الزعامة السعدية أبو العباس أحمد، وكانت قد وصلت الدولة في عهده إلى حالة من التردي والضعف والانهيار، حيث لا يزال طفلاً صغيراً، وكان أخواله من العرب الشبانات لهم تطلع للوصول للحكم. انتهى الأمر بأن قامت قبيلة الشبانات بقتل السلطان السعدي آخر السلاطين السعديين عام (1069هـ/1658م) وأزالوا نهىء ياً معالم الأسرة السعدية بمقتل أبي العباس واستيلاء عرب الشبانات على مقاليد الأمور في البلاد، وبايعوا إبراهيم عبد الكريم زعيم القبيلة، وكان من الطبيعي أن تسقط تلك القبيلة، لأنها لا تملك القوة القيادية بحيث تتصدر العمل السياسي في هذه المرحلة الحاسمة، والمليئة بالصراع والتمزق على الساحة الداخلية والخارجية، وسقطت تلك القبيلة أمام زحف الأشراف العلويين الذين أصبحوا محل ثقة الشعب المغربي في عام (1075هـ/1412م) وتولوا مقاليد المغرب، ودخلوا مراكش، ولا تزال أسرة الأشراف العلويين في حكم البلاد إلى يومنا.
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي
الجزء الأول: تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى
من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي:
alsallabi.com/uploads/file/doc/kitab.PDF