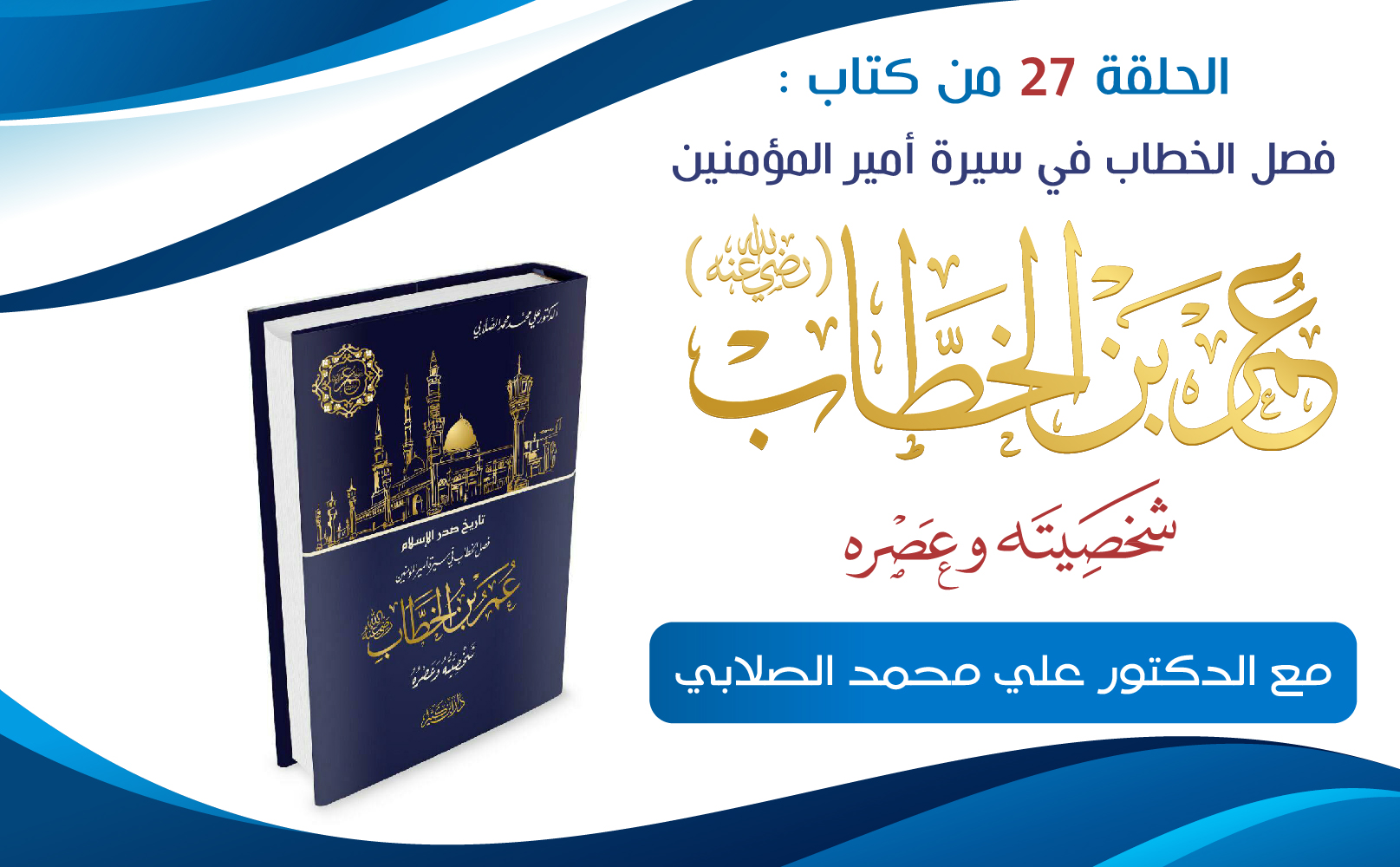الحلقة الخامسة والتسعون (95)
اشتداد المحنة بالمسلمين في غزوة الأحزاب
مع أنَّ المسلمين أخذوا بالاحتياطات كافَّةً في تأمين جبهتهم الدَّاخليَّة، ومحاولة الدِّفاع عن الإسلام، والمدينة من جيش الأحزاب الزَّاحف، إلا أنَّ سنَّة الله الماضية لا نصر إلا بعد شدَّة، ولا منحة إلا بعد محنة، وكلَّما اقترب النَّصر زاد البلاء، والامتحان، وقد ازدادت محنة المسلمين في الخندق عندما:
أولاً: نَقْضُ اليهود من بني قريظة العهدَ، ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف:
كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الَّذين يسكنون في جنوب المدينة، فيقع المسلمون حينئذٍ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم، والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم، ونجح اليهوديُّ زعيم بني النَّضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضمَّ مع الأحزاب لمحاربة المسلمين.
وسرت الشَّائعات بين المسلمين بأنَّ قريظة قد نقضت عهدها معهم، وكان الرَّسول (ﷺ) يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنَّ اليهود قوم لا عهد لهم، ولا ذمَّة، ولذلك انتدب النَّبيُّ (ﷺ) الزبير بن العوَّام «رجل المهمَّات الصَّعبة» ليأتيه من أخبارهم، فذهب الزُّبير، فنظر ثمَّ رجع، فقال: يا رسول الله! رأيتهم يصلحون حصونهم، ويُدرِّبون طرقهم، وقد جمعوا ماشيتهم.
وبعد أن كثرت القرائن الدَّالة على نقض بني قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله (ﷺ) سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن رواحة، وخَوَّات بن جبير رضي الله عنهم، وقال لهم: انطلقوا حتَّى تنظروا: أحَقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم، أم لا؟ فإن كان حقّاً؛ فالحنوا لي لحناً أعرفه، ولا تَـفُتُّوا في أَعْضَاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؛ فاجهروا به للنَّاس. [ابن هشام (3/232)، والبيهقي في دلائل النبوة (3/429)].
فخرجوا حتَّى أتوهم، فوجدوهم قد نقضوا العهد، فرجعوا، فسلَّموا على النَّبيِّ (ﷺ) ، وقالوا: عضَلٌ والقارَّة، فعرف النَّبيُّ (ﷺ) مرادهم.
واستقبل النَّبيُّ (ﷺ) غدر بني قريظة بالثَّبات، والحزم، واستخدم كلَّ الوسائل الَّتي مِنْ شأنها أن تقوِّي روح المؤمنين، وتصدع جبهات المعتدين، فأرسل النَّبيُّ (ﷺ) في الوقت نفسه «سلمة بن أسلم» في مئتي رجلٍ، وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل، يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة، وفي هذه الأثناء استعدَّت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب، فأرسلت إلى جيوشها عشرين بعيراً كانت محمَّلةً تمراً، وشعيراً، وتيناً؛ لتمدَّهم بها، وتقوِّيهم على البقاء، إلا أنَّها أصبحت غنيمةً للمسلمين الَّذين استطاعوا مصادرتها، وأتوا بها إلى النَّبيّ (ﷺ) .
ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين، وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف:
زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها، واشتدَّ الكرب على المسلمين، وتأزَّم الموقف، وقد تحدَّث القرآن الكريم عن حالة الحرج، والتَّدهور، الَّتي أصابت المسلمين، ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزعٍ، وخوفٍ، وفزعٍ في تلك المحنة الرَّهيبة أصدقَ وصفٍ، حيث قال تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: 10، 11].
وكان ظنُّ المسلمين بالله قويّاً، وقد سجَّله القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَلـمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 22].
وأمَّا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش، وزاد خوفهم حتَّى قال مُعَتِّب بن قُشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمَّد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى، وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالرُّجوع إلى بيوتهم بحجَّة أنَّها عورة ، فقد كان موقفهم يتَّسم بالجبن ، والإرجاف وتخذيل المؤمنين، وقد وردت رواياتٌ ضعيفةٌ تحكي أقوالهم في السُّخرية، والإرجاف، والتَّخذيل.
ولكن القرآن الكريم يتكفَّل بتصوير ذلك أدقَّ تصوير، والآيات هي: ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا * وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا * وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً * قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً * قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا * قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً * أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الأحزاب: 13 20].
إنَّ الآيات السَّابقة أشارت إلى النِّقاق، وما تولَّد عنه من القلق في النُّفوس، والجبن في القلوب، وانعدام الثِّقة بالله عند تعاظم الخطوب، والجرأة على الله تعالى بدل اللُّجوء إليه عند الامتحان، ولا يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل المُخَذِّل المُرْجِف، فهم يستأذنون الرَّسول (ﷺ) للانصراف عن ميدان العمل، والقتال بحججٍ واهيةٍ زاعمين: أن بيوتهم مكشوفةٌ للأعداء، وإنَّما يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم، وللخوف المسيطر عليهم، بل ويحثُّون الآخرين على ترك موقعهم، والرُّجوع إلى بيوتهم، ولم يراعوا عقد الإيمان، وعهود الإسلام.
وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق، وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعدادٍ كبيرةٍ كلَّ ليلةٍ حول الخندق حتَّى الصَّباح، وحاول خالد بن الوليد مع مجموعةٍ من فرسان قريش أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحيةٍ ضيِّقةٍ منه، ويأخذهم على حين غِرَّةٍ، لكنَّ أُسَيْدَ بن حضير في مئتين من الصَّحابة يراقبون تحرُّكاتهم، وقد حصلت مناوشاتٌ استشهد فيها الطُّفَيْل بن النُّعمان، والَّذي قتله وحشيٌّ - قاتل حمزة يوم أحدٍ - رماه بحربةٍ عبر الخندق، فأصابت منه مقتلاً، واستطاع حبَّان بن العَرِقَة، من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله، وقال: خذها وأنا ابن العرقة.
وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللَّهُمَّ! إن كنت أبقيت من حرب قريشٍ شيئاً؛ فأبقني لها، فإنَّه لا قومَ أحبُّ إليَّ من أن أجاهد من قومٍ اذوا رسولك، وكذَّبوه، وأخرجوه.
اللَّهُمَّ! وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فاجعلها شهادةً، ولا تميتني حتَّى تقرَّ عيني من بني قريظة. [أحمد (6/141 - 142)، وابن حبان (7028)].
وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصَّالح وهو الَّذي سيحكم فيهم، ثمَّ وجَّه المشركون كتيبة غليظةً نحو مقرِّ رسول الله (ﷺ) فقاتلهم المسلمون يوماً إلى اللَّيل، فلـمَّا حانت صلاة العصر؛ دنت الكتيبة، فلم يقدر النَّبيُّ (ﷺ) ، ولا أحدٌ من أصحابه الَّذين كانوا معه أن يصلُّوا، وشُغِلَ بهمُ النَّبيُّ (ﷺ) ، فلم يصلِّ العصر، ولم تنصرف الكتيبة إلا مع اللَّيل، فقال رسول الله (ﷺ) : «ملأ الله عليهم بيوتهم، وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصَّلاة الوسطى؛ حتَّى غابت الشمس» [البخاري (2931)، ومسلم (627)].
ثالثاً: محاولة النَّبيِّ (ﷺ) تخفيف حـدَّة الحصار بعقـد صلحٍ مع غطفـان، وبثِّ الإشاعات في صفوف الأعداء:
1 - سياسة النَّبيِّ (ﷺ) في المفاوضات مع غطفان:
ظهرت حنكته (ﷺ) وحسن سياسته حين اختار قبيلة غطفان بالذَّات لمصالحتها على مالٍ يدفعه إليها على أن تترك محاربته، وترجع إلى بلادها، فهو يعلم (ﷺ) : أنَّ غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أيَّ هدفٍ سياسيٍّ يريدون تحقيقه أو باعثٍ عقائديٍّ يقاتلون تحت رايته، وإنَّما كان هدفهم الأوَّل والأخير من الاشتراك في هذا الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلالها، ولهذا لم يحاول الرَّسول (ﷺ) الاتصال بقيـادة الأحزاب من اليهـود (كحيي بـن أخطب، وكنانة بن الرَّبيع) أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لأنَّ هدف أولئك الرَّئيسي لم يكن المال، وإنَّما كان هدفهم هدفاً سياسيّاً، وعقائديّاً يتوقَّف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلاميِّ من الأساس، لذا فقد كان اتصاله «فقط» بقادة غطفان، الَّذين «فعلاً» لم يتردَّدوا في قبول العرض الَّذي عرضه عليهم النَّبيُّ (ﷺ) ، فقد استجاب القائدان الغطفانيان (عيينة بن حصن، والحارث بن عوف) لطلب النَّبيِّ (ﷺ) ، وحضرا مع بعض أعوانهما إلى مقرِّ قيادة النَّبيِّ (ﷺ) ، واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحدٌ، وشرع رسول الله (ﷺ) في مفاوضتهم، وكانت تدور حول عرضٍ تقدَّم به رسول الله (ﷺ) يدعو فيه إلى عقد صلحٍ منفردٍ بينه، وبين غطفان، وأهمُّ البنود الَّتي جاءت في هذه الاتفاقيَّة المقترحة:
أ - عقد صلحٍ منفردٍ بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب.
ب - توادع غطفان المسلمين، وتتوقف عن القيام بأيِّ عملٍ حربيٍّ ضدَّهم (وخاصَّة في هذه الفترة).
ج - تفكُّ غطفان الحصار عن المدينة، وتنسحب بجيوشها عائدةً إلى بلادها.
د - يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلِّها من مختلف الأنواع، ويظهر: أنَّ ذلك لسنةٍ واحدةٍ، فقد ذكر الواقديُّ: أنَّ رسول الله (ﷺ) قال لقائدي غطفان: أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثمر المدينة ترجعان بمن معكم، وتخذِّلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا نصف ثمر المدينة، فأبى رسول الله (ﷺ) أن يزيدهما على الثُّلث، فرضيا بذلك، وجاءا في عشرة من قومهما حين تقارب الأمر.
ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول الله (ﷺ) من الوجهة العسكريَّة وضوح الهدف الَّذي خرجت غطفان من أجله، وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء، ويحرِّكها في جبهة القتال، ولاشكَّ في أنَّ اختفاء هذا الدَّافع يعني: أنَّ المحارب فقد ثلثي قدرته على القتال، وبذلك تضعف عنده الرُّوح المعنوية الَّتي تدفعه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه، وبذلك استطاع (ﷺ) أن يُفتِّت، ويضعف من قوَّة جبهة الأحزاب.
وقد أبرز (ﷺ) في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج النُّبوة في التَّحرك لفكِّ الأزمات عند استحكامها، وتأزُّمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربويّاً من دروس التَّربية المنهجيَّة عند اشتداد البلاء، وقبل عقد الصُّلح مع غطفان شاور رسولُ الله (ﷺ) الصحابة في هذا الأمر، فكان رأيُهم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة، وقال السَّعدان: سعدُ بن معاذ، وسعدُ بن عبادة: يا رسول الله! أمراً تحبُّه، فنصنعُه، أم شيئاً أمرك الله به لابدَّ لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعُه لنا؟ فقال: «بل شيءٌ أصنعه لكم، والله! ما أصنع ذلك إلا لأنِّي رأيت العرب رمتكم عن قوسٍ واحدةٍ، وكالبوكم - أي: اشتدوا عليكم - من كلِّ جانبٍ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما»، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنَّا وهؤلاء على الشِّرك بالله، وعبادة الأوثان، لا نعبد الله، ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً واحدةً إلا قِرىً - أي: الطَّعام الَّذي يُصنع للضَّيف - أو بيعاً، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزَّنا بك، وبه، نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةٍ، والله لا نعطيهم إلا السَّيف، حتَّى يحكم الله بيننا وبينهم، فقال النَّبيُّ (ﷺ) : «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصَّحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب، ثمَّ قال: ليَجْهدوا علينا. [ابن هشام (3/234)].
كان رد زعيمي الأنصار: سعدُ بن معاذ، وسعدُ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى، والأدب مع النَّبي (ﷺ) وطاعته، فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى، فلا مجال لإبداء الرَّأي بل لابدَّ من التَّسليم، والرِّضا.
والثَّاني: أن يكون شيئاً يحبُّه رسول الله (ﷺ) ، باعتباره رأيه الخاصّ، فرأيه مقدَّمٌ، وله الطَّاعة في ذلك.
الثَّالث: أن يكون شيئاً عمله الرَّسول (ﷺ) لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم، فهذا هو الَّذي يكون مجالاً للرَّأي.
ولـمَّا تبيَّن للسَّعدين من جواب الرَّسول (ﷺ) : أنَّه أراد القسم الثَّالث: أجاب سعدُ بن معاذ بجوابٍ قويٍّ، كبت به زعيمي غطفان، حيث بيَّن أنَّ الأنصار لم يذلُّوا لأولئك المعتدين في الجاهليَّة؛ فكيف وقد أعزَّهم الله تعالى بالإسلام؟! وقد أُعجب النَّبيُّ (ﷺ) بجواب سعدٍ، وتبيَّن له منه ارتفاع معنويَّة الأنصار، واحتفاظهم بالرُّوح المعنويَّة العالية، فألغى بذلك ما بدأ من الصُّلح مع غطفان.
وفي قوله (ﷺ) : «إنِّي قد علمت: أنَّ العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحدةٍ» [الطبراني في الكبير (5409)، وابن هشام (3/234)، ومجمع الزوائد (6/131)].
دليلٌ على أنَّ رسول الله (ﷺ) كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفّاً واحداً، وهذا يرشد المسلمين إلى عدَّة أمورٍ، منها:
- أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية.
- أن يكون الهدف الاستراتيجيُّ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيع تحييده، ولا تنسى القيادة الفتوى، والشُّورى، والمصلحة الانيَّة، والمستقبليَّة للإسلام.
وفي استشارة رسول الله (ﷺ) للصَّحابة يتبيَّن لنا أسلوبه في القيادة، وحرصه على فرض الشُّورى في كلِّ أمرٍ عسكريٍّ يتَّصل بالجماعة، فالأمر شورى، ولا ينفرد به فردٌ حتَّى ولو كان هذا الفرد رسول الله (ﷺ) ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد، ولم ينزل به وحيٌ.
إن قبول الرسول (ﷺ) رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره، ويحترم رأيهم ويحترمون رأيه، ومصالحة النبي (ﷺ) مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة للأمة.
إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معانٍ:
أ - أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي، والمشورة في أي أمر يخص الجماعة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ب - أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ورسوله (ﷺ) وبالإسلام.
ج - أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرجة بالصبر والرغبة القوية في قهر العدو، مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه.
2 - اهتمام الرسول (ﷺ) ببث الإشاعات في صفوف الأعداء:
استخدم النَّبي (ﷺ) سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن، فلقد كان يعلم (ﷺ) أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب، فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته ويستغله في جانبه، فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها، والآن ساق المولى - عز وجل - نُعيم بن مسعود الغطفاني إلى رسول الله (ﷺ) ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله، إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال له رسول الله (ﷺ) : إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. [ابن هشام (3/240)، والبيهقي في دلائل النبوة (3/445 )].
فقام نُعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله (ﷺ) ، فأغرى اليهود بطلب رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار، وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن لتسليمها للمسلمين ثمناً لعودتها إلى صلحهم، لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أنها لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية؛ فالحرب خدعة.
وقد نجحت دعاية نُعيم بن مسعود أيما نجاح، فغرست روح التشكيك، وعدم الثقة بين قادة الأحزاب، مما أدى إلى كسر شوكتهم، وتثبيط عزمهم، وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها على الأسس التالية:
أ - أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف، بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نُصح.
ب - أنه ذكّر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير، وبصَّرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم إن هم استمروا في حروبهم للرسول (ﷺ) ، فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفكارهم وقلب مخططاتهم العدوانية.
ج - أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له، وفي استمرار هذا الكتمان نجاح في مهمته، فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته.
وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب.
يمكن النظر في كتاب السِّيرة النَّبويّة عرض وقائع وتحليل أحداث
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ


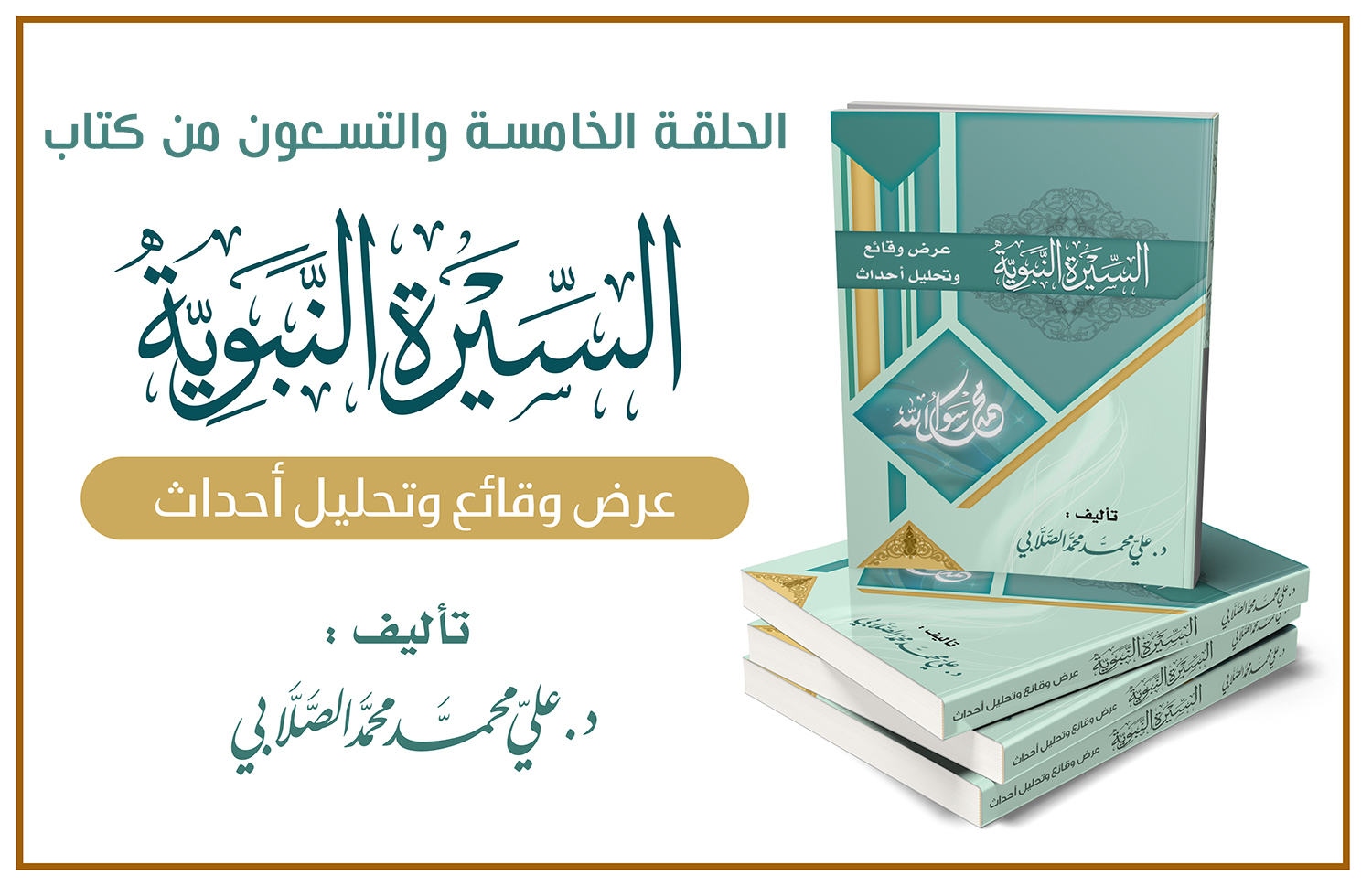
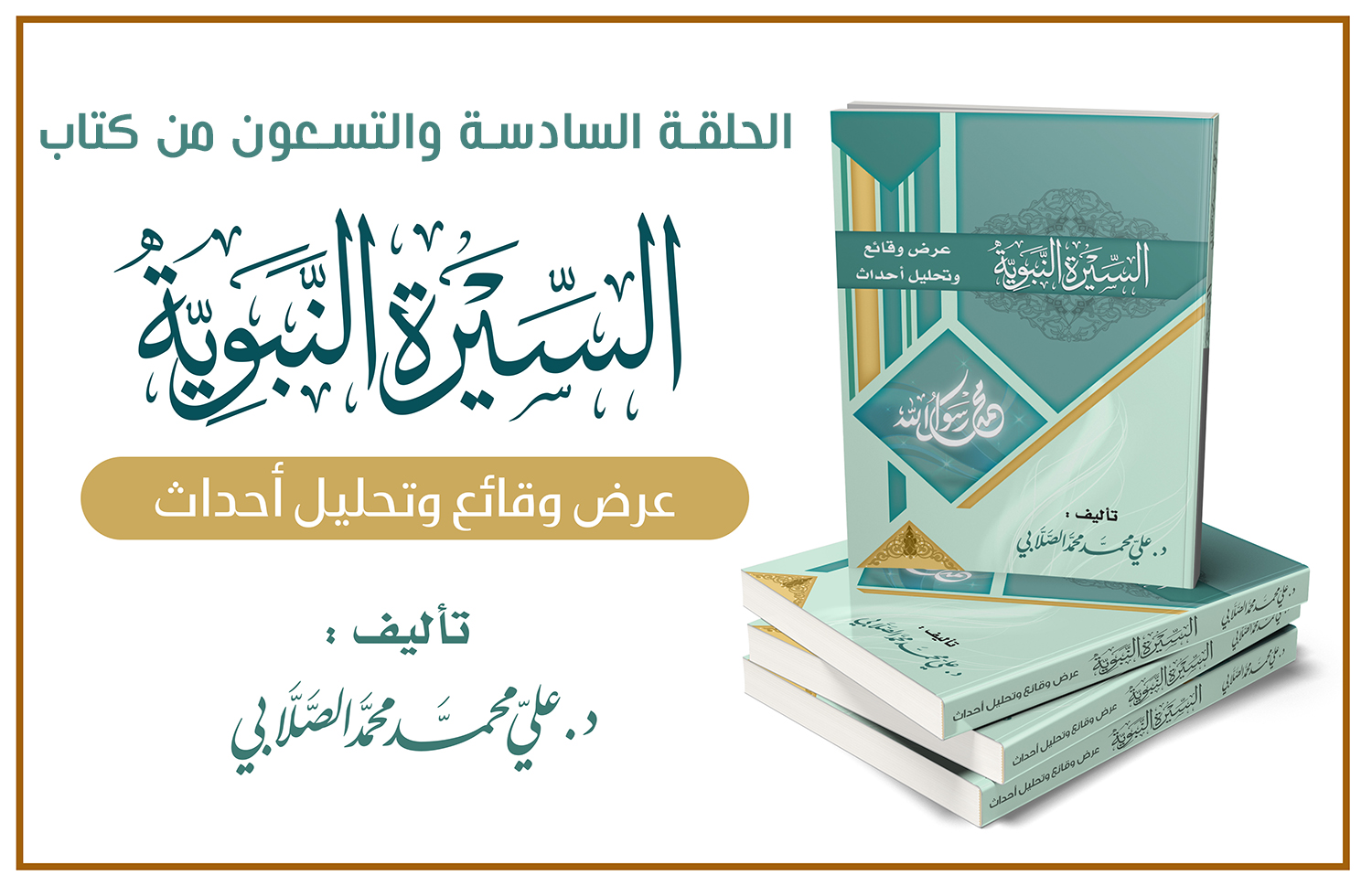

.jpg)