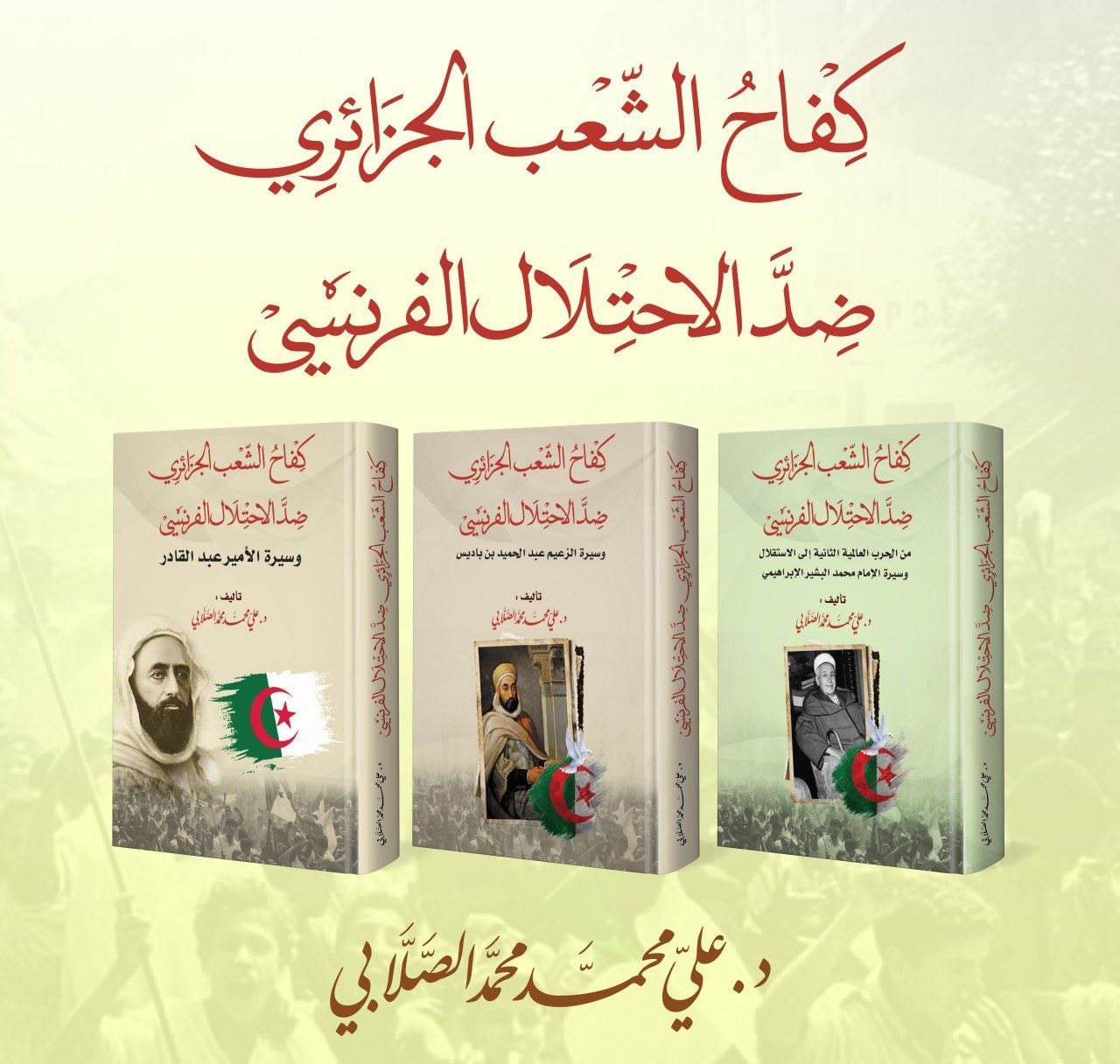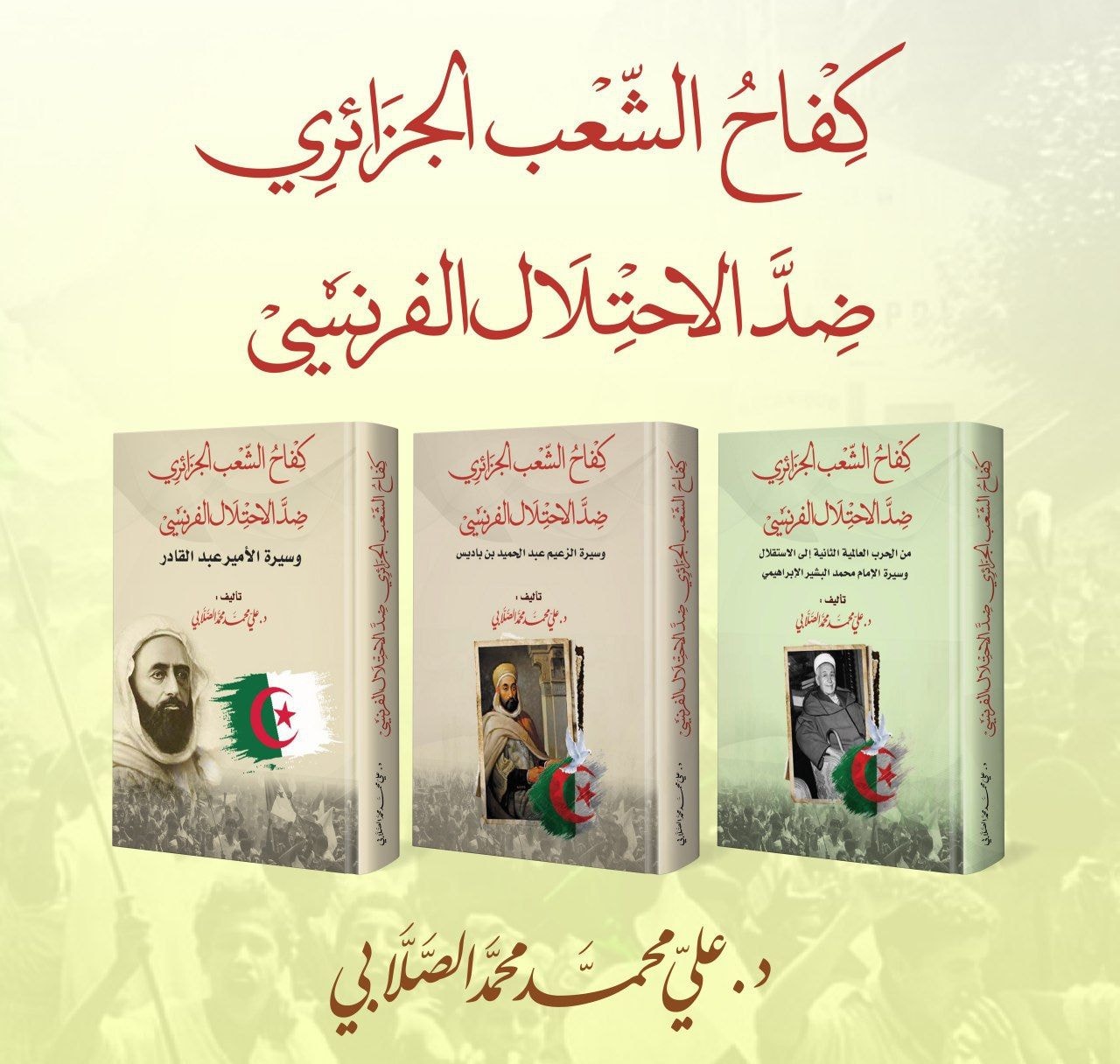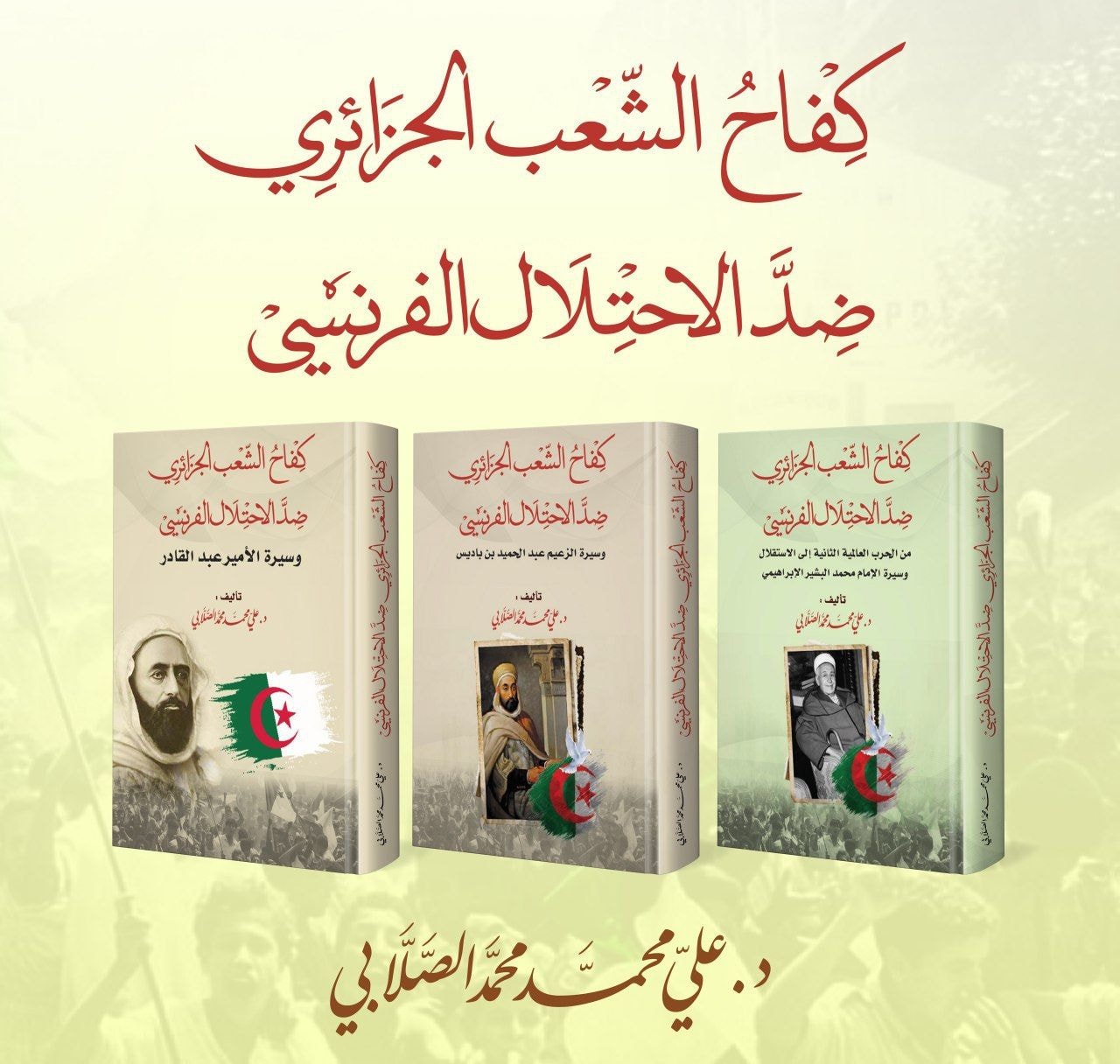ابن باديس في مواجهة الاندماجيين
من كتاب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي(ج2)
الحلقة: 163
بقلم: د.علي محمد الصلابي
محرم 1443 ه/ أغسطس 2021م
الاندماجي مصطلح سياسي تاريخي دل في الجزائر على من يؤمن بما يسمى الاندماج ويناضل سياسياً من أجل تحقيقه، وكان الواقع الجزائري يطلق على جماعات من النخبة الجزائرية يعتقدون أنه من المستحيل افتكاك الجزائر من مخالب الاستعمار الفرنسي، لا سلماً ولا حرباً. وعلى ذلك فإن الأنفع والأجدى في نظرهم من المطالبة بالاستقلال ؛ إنما هو السعي إلى مطالبة السلطات الفرنسية بتحقيق المساواة بين كل الفرنسيين مادامت القوانين الفرنسية تنص على أن الجزائر فرنسية، أي تحقيق الانصهار التام بين الشعب والأقلية الأوروبية التي تمثل الوجه القبيح للاستعمار الاستيطاني في الجزائر، وهي التي جاءت في ركابه وملّكها بالقوة أراضي الجزائريين الخصبة، وحوّل القادرين منهم إلى خدم بلا حقوق ولا اعتبار لكرامتهم الإنسانية، ذلك هو الاندماج في مصطلحهم.
وقد كان الشيخ ابن باديس مناهضاً صلباً للاندماج والإندماجيين، وهو المشهور بقصيدته التي يرى فيها أن الاندماج هو الأمر المحال وفي ذلك يقول قصيدته المشهورة التي غدت نشيداً وطنياً تغنت به أجيال كثيرة من أبناء الوطن ومن أشهر أبياتها قوله:
شعــــــب الجزائر مســــــلم وإلى العــــــــــــــروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب
أو رام إدمــــــــــاجاً لـــــــه رام المحـــــــــــــتال من الطلب
وقد كان من أشهر هؤلاء الاندماجيين في هذه الفترة التي نتحدث عنها السيد فرحات عباس الذي كان من رجال السياسة البارزين في ذلك العهد، وهو الذي صار بعد اندلاع الثورة أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ما بين سنتي 1958م، 1960م، فقد تغيرت أفكاره ومواقفه مع الزمن وانخرط في الثورة الشاملة ضد المحتلين.
كان فرحات عباس قد كتب في جريدة الوفاق التي تصدر باللغة الفرنسية واسمها لانطانت يوم 23 فبراير 1936م مقالاً باللغة الفرنسية تحت عنوان «فرنسا هي أنا» قال فيه ما ترجمته: لو كنت اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت وطنياً. ولن أموت من أجل الوطن الجزائري، لأن هذا الوطن غير موجود لم أعثر عليه ، وقد سألت التاريخ وسألت الأحياء وسألت الأموات وزرت المقابر فلم يُحدّثني عن هذا الوطن الجزائري أحد.
وتصدّى الشيخ الإمام ابن باديس للردّ عليه في مقال كان له صدى واسع ودويّ كبير تحت عنوان «كلمة صريحة» ردّ فيه على فرحات عباس، بدأه قائلاً:
إن هؤلاء المتكلمين باسم المسلمين الجزائريين، والذين يُصورون الرأي العام الإسلامي الجزائري بهذه الصورة هم في وادٍ والأمة في واد.. ثم يُضيف في صرخة استنكار: لا يا سادتي، نحن نتكلم باسم قسم عظيم من الأمة، بل ندعي أننا نتكلم باسم أغلبية الأمة، فنقول لكم ولكل من يُريد أن يسمعنا.. إننا نحن فتشنا في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة، فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا، ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال، ولها وحدتها الدينية واللغوية، ولها ثقافتها الخاصة.
ثم يخلص الإمام إلى أهم فقرة في مقاله والتي يقول فيها: ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست في فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد، في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها، لا تريد أن تندمج ولها وطن محدود معين، هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة.
وقد بلغ من تأثير هذا المقال في المحيط السياسي، أن قامت على الشيخ الإمام ضجة كبيرة، أراد أصحابها من خلالها أن يستفزوا عليه سلطات الاستعمار، بحُجة كونه ضد «الوجود الفرنسي في الجزائر». أما المعني نفسه وهو الأستاذ فرحات عباس، كما يسميه الشيخ ابن باديس بكل أدب، فقد زاره في مكتبه بإدارة المجلة التي يُشرف عليها في مدينة قسنطينة، وهي مجلة الشهاب التي صدر فيها المقال، وشرح له من خلال تلك الزيارة أنه كان يريد أن يُحق حقوق الجزائريين في المساواة مع الفرنسيين.
ثم كتب فرحات عباس يُعيد ذلك مقالاً في جريدة «لاديفانس» «الدفاع» مقالاً توضيحياً حاول أن يخفف فيه من وطأة المقال الأول، وما كان من اثاره السلبية في الرأي العام الوطني.
وقد أثنى الشيخ ابن باديس على تقبل فرحات عباس للنقد البنّاء فقال: وإنا لنشهد أنه من أكمل الرجال الذين رأينا فيهم ـ بهذه المناسبة ـ الهمة العالية وشرف النفس وطهارة الضمير، ونقدنا له لم يتألم منه ولم يتكدر، وسلك مسلك كبار رجال الساسة الذين يحبذون النقد وينصاعون لكلمة الحق.
وبهذا الأسلوب الحكيم استطاع ابن باديس أن يعمل عمله السحري في نفس المرحوم الزعيم فرحات عباس ـ المشهود له بالحصافة والإخلاص ـ فيحوله من حالته التي كان يقول فيها: فرنسا هي أنا، إلى أن يصبح من قادة ثورة نوفمبر 1954م، بل أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وأول رئيس للمجلس الوطني التأسيسي في فجر الاستقلال.
فإن الإجراءات الإدارية كانت هي الأخرى مانعاً أمام الراغبين في طلب التجنس.
وعموماً فقد شهدت الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر اقتراح مشاريع عديدة لتجنيس الجزائريين المسلمين، وبعد فترة هدوء شهدتها بداية القرن العشرين عاد بعد ذلك الحديث مجدداً عن قضية التجنيس، وعرف أهمية أكبر بمناسبة صدور قانون التجنيد العسكري الإجباري في فيفري 1912م فُرض على الجزائريين ومشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الأولى وما قدموه من تضحيات في المعارك التي دارت انذاك في أوروبا ؛ ولذلك فقد تعالت بعض الأصوات تطالب بضرورة تعويض هؤلاء بمنحهم الحقوق السياسية. وقد تمخض في النهاية عن كل النقاشات التي تمت والمشاريع التي قدمت صدور قانون 4 فيفري 1919م.
لقد نص هذا القانون على: أن أهالي الجزائر بإمكانهم الحصول على صفة المواطن الفرنسي بموجب إجراءات السيناتوس كونسيلت 14 جويلية. وبموجب هذا القانون ـ 4 فيفري 1919م ـ ودون شك أن هذا القانون جاء نتيجة لفشل قانون 1865م والفرق الواضح ما بين القانونين هو أن الإجراءات في قانون 1865م تقوم به السلطات الإدارية في حين أنه في قانون 1919م تقوم بها السلطات القضائية مهما يكن فمنذ صدور هذا القانون أصبح أمام الجزائريين الراغبين في التجنس والاندماج في المجتمع الفرنسي طريقتين إما طلب التجنس حسب قانون 1865م أو طلب ذلك حسب قانون 1919م.
وقد تعددت الاراء حول هذا القانون ما بين مؤيد ومعارض، وتزامن الشروع في تطبيق القانون مع ظهور الحركة الإصلاحية في بداية العشرينات وظهور الصحافة الإصلاحية، التي كانت منبراً للعلماء للتعبير عن ارائهم ومواقفهم من مختلف القضايا المطروحة انذاك.
ومن بين العلماء الأوائل الذين انبروا إلى هذه القضية الشيخ عبد الحميد بن باديس، فقد استغل في أحد أعداد الشهاب، فرصة التعليق على كلمة وزير الداخلي الفرنسي للوفد الجزائري الذي شارك في حفل افتتاح مسجد باريس في شهر جويلية 1926م ليبين موقفه من هذه القضية، فقد خاطب الوزير الوفد بقوله: إن عرضتكم لوزارة الداخلية لها معنى مخصوص... إن دعوة هذا الوفد دون بقية الوفود إلى وزارة الداخلية له معناه، ويتطرق بعد ذلك لوضعية الجزائري المسلم منذ صدور قانون 1865م.
وفي نظر ابن باديس أن الجزائريين لم يتمتعوا من ذلك الوقت بحقوق المواطن الفرنسي لأنهم لم يكونوا ملزمين بكل الواجبات، أما اليوم فهم يقومون بجميعها، فمن حقهم أن يطالبوا فرنسا بحقوقهم بمقتضى كلمة وزير الداخلية، إلا أن ابن باديس يرفض التجنس بالشكل الذي جاءت به القوانين ويقول أنه بإمكان الجزائري المسلم الحصول على حقوقه دون أن يقدم على التجنس الذي يؤدي حسب القانون الفرنسي إلى التخلي عن الأحوال الشخصية، وهو يرد بذلك على دعاة التجنس المطلق، وبالنسبة إليه لا يوجد تناقض ما بين أن يكون الجزائري فرنسياً يتمتع بجميع حقوقه وفي نفس الوقت محافظاً على شخصيته.
وبعد النقاش حول مسألة التجنيس الذي دار في نهاية العشرينات ما بين المصلحين الرافضين لذلك والمدافعين عن الاندماج في فرنسا حتى مع التخلي عن الأحوال الشخصية ؛ يعود ابن باديس إلى الحديث عن هذه المسألة في بداية الثلاثينات، مستغلاً في ذلك خيبة أمل المتجنسين واعترافاتهم بفشل سياسة التجنيس، فبعد نشر الربيع الزناتي لمقال يعبر فيه عن خيبة أمله في الوضعية التي ال إليها المتجنسون من جراء السياسة الاستعمارية والممارسات اليومية غير اللائقة التي يتعرضون لها، يستغل ابن باديس هذا الاعتراف ليعلق عليه تحت عنوان «أقر الخصم وارتفع النزاع، داعية التجنس يعترف بالخيبة».
لقد بات معلوماً ضرورياً أن رفض أحكام الإسلام هو ارتداد عنه، وما كان أكثر الذين فعلوا هذه الفعلة على قلتهم عالمين بهذه الحقيقة. وما أقدموا على ما أقدموا عليه من رفض الإسلام ؛ إلا ببواعث الرغبة في عرض الدنيا ودواعي الطمع من نيل الحقوق الفرنسية كالفرنسيين الحقيقيين، ولكن هذه الرغبة لم تتم، وهذا الطمع لم يتحقق وبقي القوم ويا للأسف معلقين لا من ملة ابائهم ولا من الملة الأخرى.
ومع ذلك فإن ابن باديس لم يبعد المتجنسين ولم يقصهم عن مجتمعهم الأصلي، بل فتح لهم الأبواب للعودة، حتى تتكاتف جهود الجميع لأن الجزائر المستقبل في حاجة إلى جميع الطاقات المثقفة.
غير أن العلماء لم يكتفوا بهذه المواقف المعتدلة والمتفهمة للمتجنسين ، فأمام إلحاح المتجنسين وغير المتجنسين في معرفة الحكم الشرعي من قضية التجنس والاندماج لم يتوانوا في تحريمه واعتباره ردة.
ففي جانفي 1938م أصدر الشيخ ابن باديس فتوى تكفر كل مسلم قبل التجنس مع تخليه عن أحواله الشخصية، حيث تنص الفتوى بتكفير كل مسلم جزائري أو تونسي أو مغربي يتنازل عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية باختياره، ويتجنس بالجنسية الفرنسية للتمتع بالحقوق المدنية.
قال ابن باديس: ما أكثر ما سئلنا عن هذه المسألة، وطلب منا الجواب في الصحف، ومن السائلين رئيس المتجنسين الأستاذ التركي «الذي لم يجد من يفته في تونس» وكاتبنا برسالتين، فأدينا الواجب بهذه الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد واله: التجنس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة الإسلامية، ومن رفض حكماً واحداً من الأحكام الإسلامية عدّ مرتداً عن الإسلام بالإجماع فالمتجنس مرتد بالإجماع، والمتجنس ـ بحكم القانون الفرنسي يجري تجنسه على نسله، فيكون قد جنى عليه بإخراجه من حظيرة الإسلام، وتلك الجناية من شر الظلم وأقبحه، وإثمها متجدد عليه ما بقي له نسل في الدنيا خارجاً عن شريعة الإسلام بسبب جنايته ـ والعلم عند الله. خادم العلم وأهله، عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء.
كما أفتى في قضية تزوج المسلم الجزائري بالفرنسية بالرغم من أن الإسلام يبيح الزواج بالكتابية ؛ فقد أفتى ابن باديس بحرمة زواج الجزائري المسلم بالفرنسية، وعلل ذلك بكون النتيجة التي يؤدي إليها هذا الزواج هي الخروج عن حظيرة الإسلام، لأن القانون الفرنسي يقضي بأن أبناءه منها يتبعون جنسية أمهم في خروج نسله عن حظيرة الإسلام، فإن كان راضياً بذلك فهو مرتد عن الإسلام جان على أبنائه ظالم لهم، وإن كان غير راض لهم بذلك وإنما غلبته شهوته على الزواج فهو اثم بجنايته عليهم وظلمه لهم، لا يخلصه من إثمه هذا إلا إنقاذهم مما أوقعهم فيه.
وفي ذات الموضوع أصدر فتوى أخرى في قضية دفن أبناء المتجنسين في مقابر المسلمين، سأل أحد أهالي «ميشلي» من القبائل الكبرى عن أبناء المتجنسين بالجنسية الفرنسية هل يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؟ فكان جواب ابن باديس كما يلي: بعد الحمد لله والصلاة والتسليم على النبي واله، قال: فابن المطورني أي «المتجنس» إذا كان مكلفاً ولم يُعلم منه إنكار ما صنع أبوه والبراءة منه فهو مثل أبيه لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن كان صغيراً فهو مسلم على فطرة الإسلام يدفن معنا ويصلى عليه. كتبه خادم العلم وأهله عبد الحميد بن باديس.
لقد تصدى ابن باديس إلى دعاوى الاندماج والانصهار في الثقافة الفرنسية، واستطاع أن يخلص الجزائر من تلك الأفكار الهزيلة، التي لم تصمد أمام الحقائق وطبيعة الأشياء، وصلابة الشخصية الجزائرية المعتزة بدينها ولغتها وبلادها.
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com