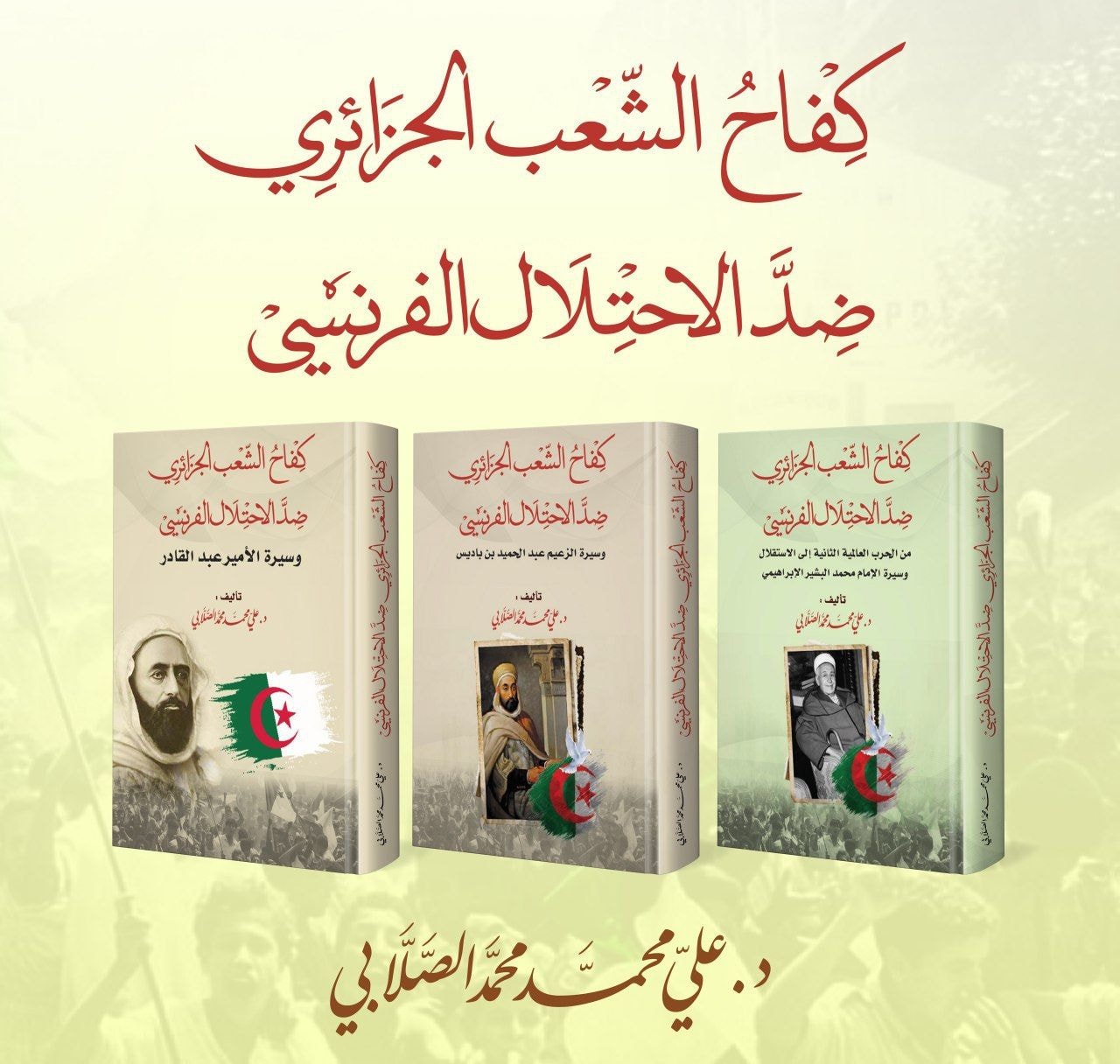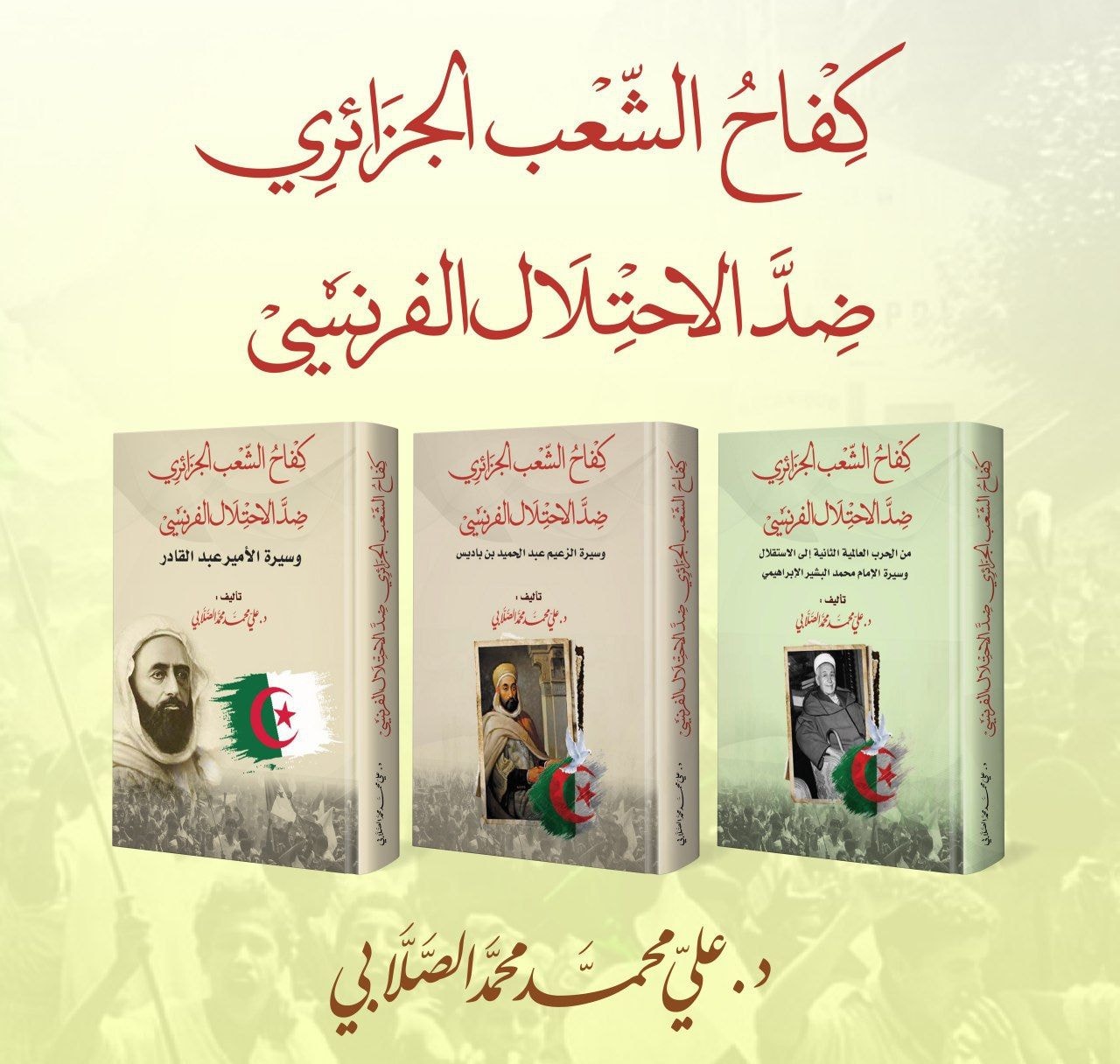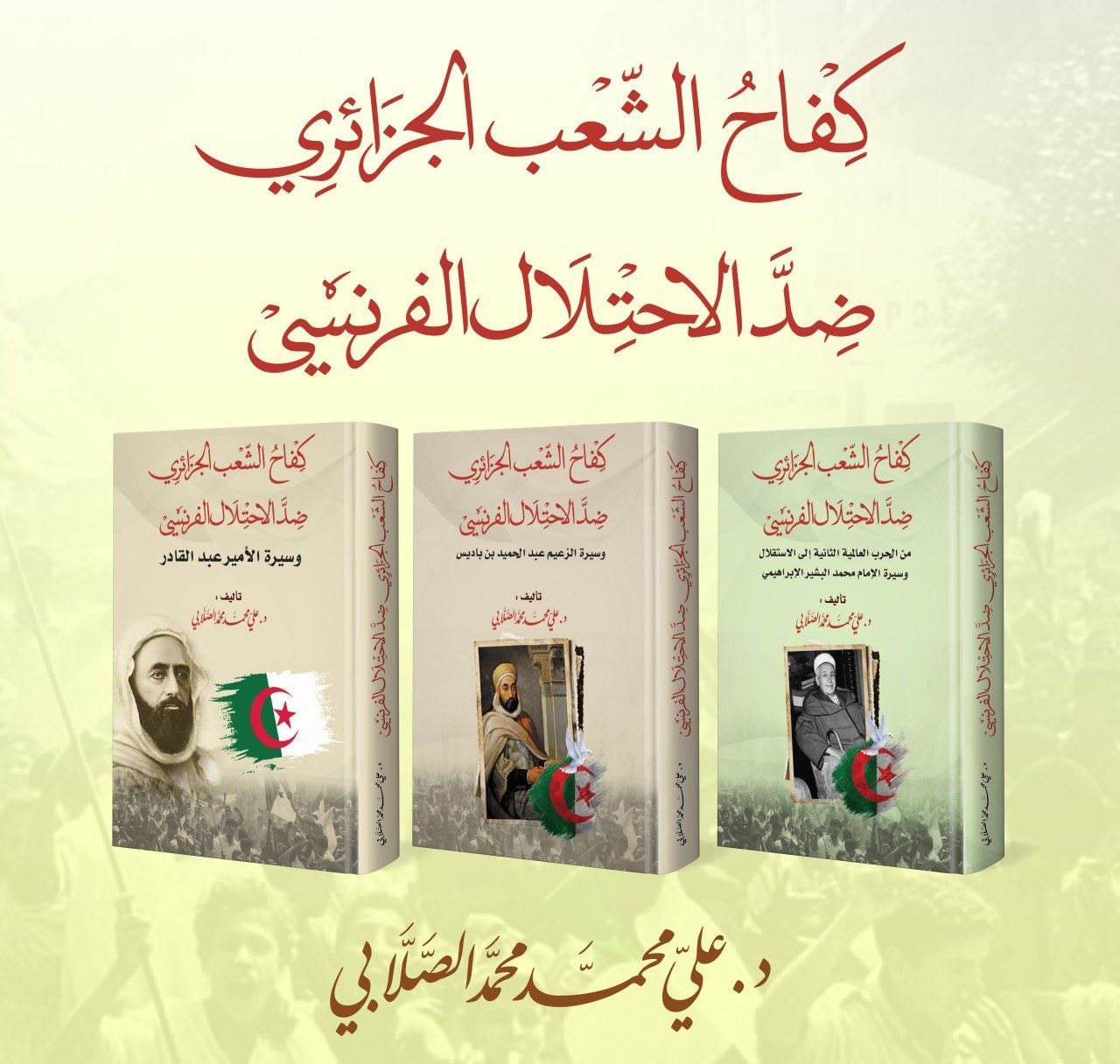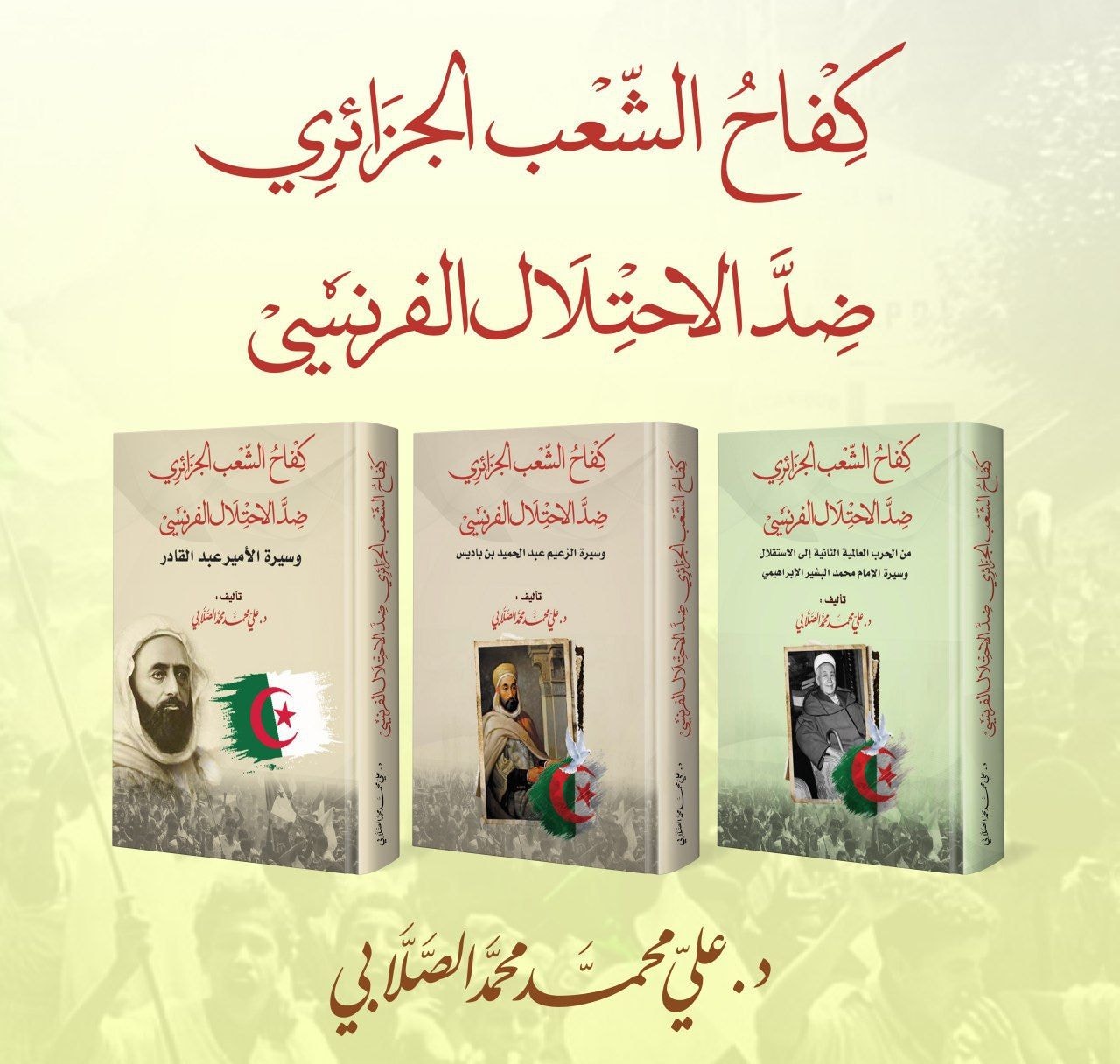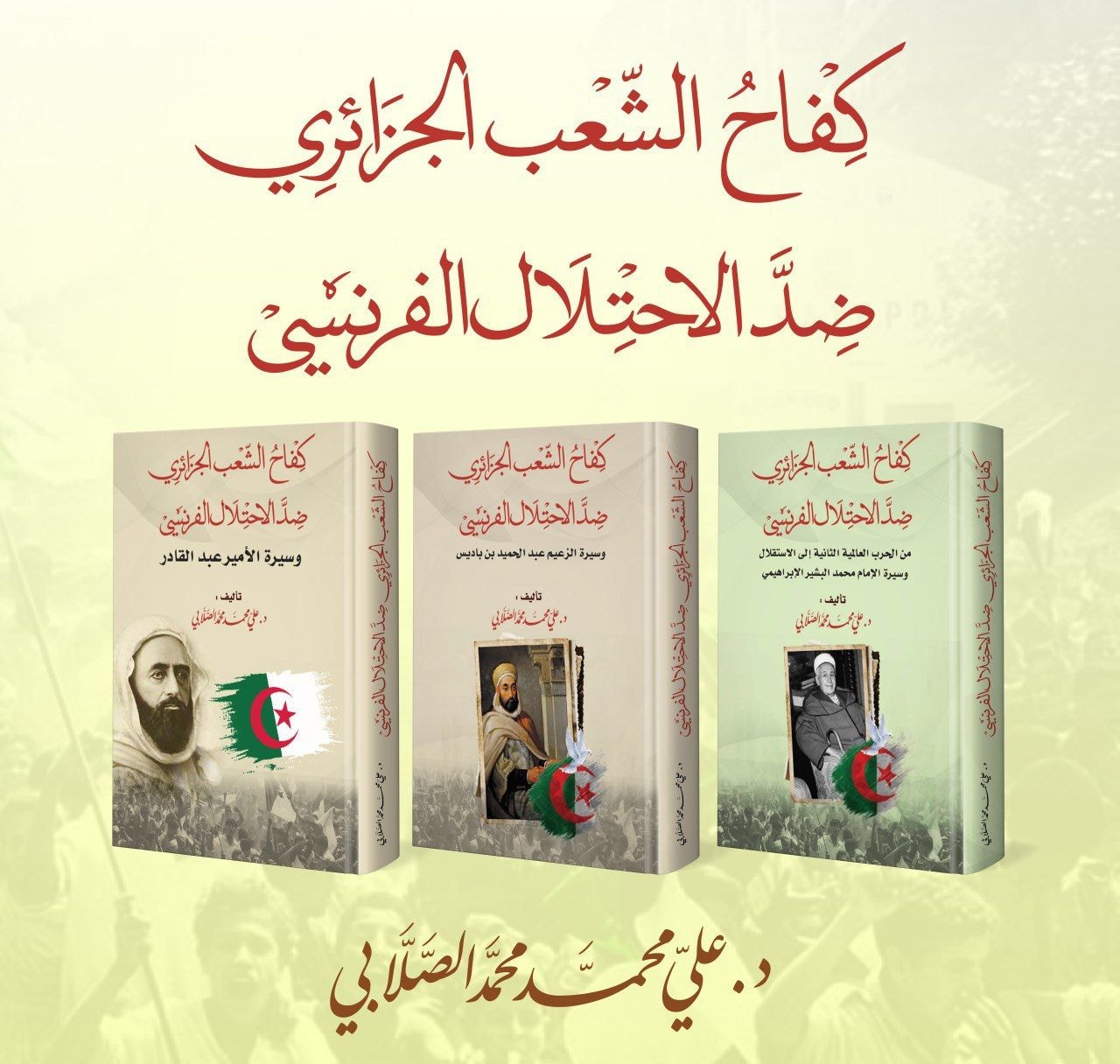مفهوم الأمة عند ابن باديس
من كتاب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي(ج2):
الحلقة: 165
بقلم: د.علي محمد الصلابي
محرم 1443ه/ أغسطس2021
إن لمفهوم الأمة عند الشيخ عبد الحميد بن باديس أبعاداً ترتكز على مقومي «العقيدة» «واللسان»، فالشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب، هكذا يحدد الشيخ المقومات التي تصنع وجود الأمة بمرجعياتها الثقافية المتأصلة في الذات الجزائرية، والتي يتقاسمها وشعوب عدة حاولت الجغرافيا تضييق افاق توافقاتها التاريخية واللسانية والعقائدية.
لقد شكلت نضالات ابن باديس تجسيداً عملياً لمفهوم الأمة ؛ ذلك المفهوم النابع من وعي عميق ومتجذر بالانتماء، انتماء أكبر من الأرض والتراب تؤطره جوامع ترتكز على ثوابت تنبني عليها الشخصية الجزائرية، وبذلك كان المفهوم يمثل هدفاً تربوياً يبتغي الشيخ ترسيخه، باعتباره استراتيجية تؤسس حصانة للهوية، ومن ثم كانت الجهود الإصلاحية للشيخ بمثابة تأهيل لمفهوم الأمة.
فالأمة عند الشيخ كيان يرتبط بظروف تهيأئ وجوده وتبسط تحققه: وأولاها الحرية، ذلك أن الحرية تحيل إلى القدرة على اتخاذ القرار في الأمم المغلوبة على أمرها.. لا تستطيع أن تصنع أمراً لنفسها فكيف تستطيع أن تصنعه لغيرها، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فكيف تستطيع أن تدافع عما تقرره مع غيرها، وهي لم تستطع أن تعتمد على نفسها في داخليتها، فكيف يعتمد عليها في خارجيتها؟ فالوحدة السياسية بين هذه الأمم أمر غير ممكن ولا معقول ولا مقبول.
وبذلك تفتقد الأمة بالمفهوم الشامل عند ابن باديس لأهم ركيزة لقيامها كوحدة أو ككيان له وجوده العيني وليس النظري فحسب، وهذه الركيزة يعقدها الشيخ في الوحدة السياسية للأمة.
فالوحدة السياسية تكون مقترنة بممارسة واعية ومسؤولة وحرة ولا يمكن من الناحية المنطقية أن تقوم هذه الوحدة في ظل التبعية والقبوع تحت نير الإملاءات الاستعمارية ؛ ذلك أن الاستعمار عائق في وجه تشكل الأمة ووحدتها. وهي نظرة وإن فرضها الواقع السياسي للأمة العربية في عهد الشيخ، إلا أنها رؤية استشرافية تنظر لمفهوم الوحدة السياسية، تلك الوحدة التي لم تتجسد بعد في استقلال الأمة العربية وتخلصها من ربقة الاحتلال الأجنبي، فاستبدلته باحتلال آخر هو الاحتلال الأيدولوجي الذي شكل عائقاً أمام الوحدة السياسية باعتباره شكلاً آخر من أشكال القبوع تحت الإملاءات الاستعمارية.
والواقع الاستعماري يفرض على الأمم المغلوبة أن تعمل أولاً على التخلص منه ثم التوجه نحو تحقيق الوحدة، وهو عمل يختص به كل شعب في أطره الجغرافية المحدودة تبعاً لما تراه يتوافق ووضعيتها التاريخية والواقعية دون أن تلغي حقيقة انتمائها وجوهر هويتها الجمعية.
يقول الشيخ:... نجد شعوباً أخرى وهي شعوب الشمال الإفريقي المصابة بالاستعمار، فهذه لا وحدة سياسة بينها ولا بين غيرها ولا يتصور أن تكون، ومن الخير لها أن تعمل كل واحدة منها في دائرة وضعيتها الخاصة على ما يناسبها من الخطط السياسية التي تستطيع تنفيذها بالطرق المعقولة الموصلة مع الشعور التام بالوحدة القومية والأدبية العامة والمحافظة عليها والمجاهرة بها.
فالوحدة السياسية مرتبطة بالحرية والقدرة على التجسيد الواعي لمفهوم الانتماء، أما الوحدة الثقافية فهي الشعور بذاك الانتماء وتأصله في الذات الجمعية للأمة، وهو شعور تتمخض عنه ممارسات اجتماعية وأدبية ثقافية تعلن عن ارتباط الأمة وصلتها بماضيها وبمحيطها المكمل لها، كوجود وكماهية.
فالأمة تتشكل كمفهوم من ناحيتين: ناحية سياسية دولية وناحية أدبية اجتماعية، فالناحية السياسية من شأن الأمم المستقلة التي تنعم بالقدرة على التوجه العملي نحو مرجعياتها الثقافية المتأصلة فيها لتشكيل الوحدة كمنطلق أساس لتجسيد مفهوم الأمة، في حين أن الناحية الأدبية الاجتماعية فهي التي يجب أن تهتم بها كل الأمم الإسلامية المستقلة وغيرها، لأنها ناحية تتعلق بالمسلم من جهة عقيدته وأخلاقه وسلوكه في الحياة في أي بقعة من الأرض كان ومع أي أمة عاش وتحت أي سلطة وجد.
وتتخذ الأمة في مفهوم الشيخ ابن باديس أبعاداً أوسع من أطر الجغرافيا، وتمتد إلى فضاءات التاريخ واللغة والدين، تلك الفضاءات التي تجمع شعوباً عدة في بوتقة واحدة وأمة موحدة، هذا مع إقصاء المكون العرقي الذي لا يمكن أن يشكل ركيزة دعائمية لمفهوم الأمة.
ويعتبر عند الشيخ هذا المفهوم انطلاقاً من ملامسته لواقع الجزائر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية الإسلامية، حيث يقول: ما من نكير أن الجزائر كانت أمازيغية من قديم عهدها وما من أمة من الأمم استطاعت أن تقلبها من كيانها ولا أن تخرجها من أمازيغيتها أو تدمجها في عنصرها، بل هي التي تبتلع الفاتحين، فينقلبوا إليها ويصبحوا كسائر أبنائها، فلما جاء العرب وفتحوا الجزائر فتحاً إسلامياً لنشر الهداية ـ لا لبسط السيادة ـ وإقامة العدل الحقيقي بين جميع الناس لا فرق بين العرب الفاتحين والأمازيغ العرب أبناء الوطن الأصليين، دخل الأمازيغ من أبناء الوطن في الإسلام وعلموا لغة الإسلام العربية طائعين، فأمتزجوا بالعرب بالمصاهرة، ونافسوهم في مجال العلم، وشاطروهم سياسة الملك، فأقام الجميع «العرب والأمازيغ» صرح الحضارة الإسلامية يعبرون عنها وينشرون لواءها بلغة واحدة هي اللغة العربية الخالدة، فاتحدوا في العقيدة والنحلة كما اتحدوا في اللغة والأدب فأصبحوا شعباً واحداً عربياً متحداً غاية الاتحاد ممتزجاً غاية الامتزاج.
فالأمة لا تنبني وفق الانتماء العرقي، لأن ذلك تضييق للمفهوم وقصر له، وهو مفهوم لا يقبل التضييق أو التقزيم لأنه يتأسس على العقيدة واللسان والتاريخ والثقافة، وهي دعائم تتسم باتساع الأفق والشمول، فكل من كان دينه الإسلام ولغته لغة القرآن فهو ينتمي لدائرة «الأمة»، باعتبار أن هذين العاملين يشاركان باقي العوامل في بوتقة وحدة العقيدة واللسان، فالتاريخ يخضع لشمولية التاريخ الإسلامي، وكذا تحيل الثقافة إلى مرجعيتها الإسلامية المتأصلة فهي كتفكير وممارسة.
وفي نظرة تنم عن رؤية شمولية ترفض المساحات المؤطرة بالحدود وتتوخى تقديم المفهوم على حقيقته، بعيداً عن السقوط في مغبة النزوع نحو الفرق بما يمثله ذلك من توجه عنصري يفرق ولا يجمع، بل إنه تكاد لا تخلص أمة لعرق واحد، وتكاد لا توجد أمة لا تتكلم بلسان واحد، فليس الذي يكون الأمة ويربط أجزاءها، ويوحد شعورها ويوجهها إلى غايتها ؛ هو هبوطها من سلالة واحدة، وإنما الذي يفعل ذلك هو تكلمها بلسان واحد.
فالانتماء للأمة العربية يعني ذلك الشعور الذي ينتفض في وجه الجغرافيا والحدود، والأمة هي تلك الأمة الممتدة من المحيط الهندي شرقاً إلى المحيط الأطلنطي غرباً.. تنطق بالعربية وتفكر بها وتتغذى من تاريخها وتحمل مقداراً عظيماً من دمها، وقد صهرتها القرون في بوتقة التاريخ حتى أصبحت أمة واحدة.
وهو انتماء يغوص في عمق التاريخ ليأخذ منه مشروعيته وشرعيته المعرفية، باعتبار أن اللغة العربية تمثل بعداً تاريخياً إلى جانب كونها بعداً لسانياً، وكذا رابطاً بين حاضر الذات وماضيها، وبذلك تكون هذه اللغة بمثابة إعلان عن هوية الأمة وحضورها عبر التاريخ.
فابن باديس حينما يتحدث عن اللغة العربية يضمّنها كل هذه المقومات، باعتبارها لغة القران، والرابطة القوية التي تربط بين أفراد الأمة الواحدة، والتي من خلالها تبرز الذكريات التاريخية التي يعيش عليها المجتمع، والشعور المشترك الذي يؤلف بين قلوب أفراد المجتمع..
وهكذا فاللغة من الوجهة القومية هي الرابطة الشعورية والفكرية التي تربطنا بجنسنا وبقومنا وثقافة هذا الجنس، والجنس هنا هو العروبة ؛ شعور وجداني وكيان ثقافي واتجاه حضاري.
ثم إن العامل الأساسي الذي ينبني عليه مفهوم الشيخ ابن باديس للأمة هو عامل العقيدة باعتبارها الخانة الجامعة والإطار الذي تنصهر فيه الانتماءات الأخرى. فالإسلام هو المعين الذي تأخذ منه الأمة مفهومها وهو المفهوم القرآني الذي يصرح به نصاً حيث يقول: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ *} [الأنبياء : 92]. وكذلك يقول عز من قائل {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110].
فالمفهوم القرآني للأمة كان بمثابة المرجعية الثقافية التي يؤسس ابن باديس مفهومه عليها في الوطنية الإسلامية ؛ هي الدائرة الأوسع والتي تشمل الدوائر الأخرى الأقل شمولاً، على عكس التحليل الذي نجده عند فلاسفة المذهب الإنساني «الهومانيزم» الذي يجعل الدائرة الإنسانية هي الأوسع والأكثر شمولاً، لأن الأجناس والأديان والأوطان والثقافات في رأيهم هي حواجز وعوامل مفرقة بين الناس الذين يرجعون إلى أصل واحد.
إن الإسلام هو المقوم الأكبر لبلورة مفهوم الأمة، ذلك أنه يشمل الهوية والانتماء، ويوسع افاقه الدستور الموجه للإنسانية جمعاء، إنه دين الإنسانية الذي لا نجاة لها ولا سعادة إلا به، وإن خدمتها لا تكون إلا على أصوله، وإن إيصال النفع إليها لا يكون إلا من طريقه، وهو الركيزة الأساسية لبلورة مفهوم الأمة عند الشيخ فالانتماء للإسلام يعني وجود رابطة جامعة بين المنتمين لهذا الدين، بل إن الإسلام هو الذي يصنع الفرد ليجعل منه عضواً فعالاً في المجتمع.
وتربية النشء على المقومات الإسلامية هي التي من شأنها صناعة الأمة ؛ هو منهج ابن باديس الذي عاش من أجله، فالإسلام هو الذي يحوي كل المقومات ليذيبها في بوتقة الانتماء الديني. انتماء يلغي الحدود وتتسع آفاقه.
لقد علّم ابن باديس الجزائريين كيف يعلنوا التزامهم الوطني والعربي القومي والإسلامي العقدي، وقد عبّر عنه شعراً قائلاً:
شعب الجزائر مســــــلم وإلى العـــــــــــروبة ينتســـــــــب
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب
إن ابن باديس الذي أكد انتماءه لأمته العربية فكراً تغنّى بذلك في بعض ما نظمه من الشعر، ومما قاله:
المجـــــد لله ثم المجــــــد للعـــــــــرب من أنجبوا لبني الإنسان خير نبي
ونشروا في الناس ملة عادلة لا ظلم فيها على دين ولا نسب
قومي هم وبنو الإنسان كلهم عشيرتي وهدي الإسلام مطلبي
وقال أيضاً:
أشعـــــب الجــــــــزائر روحي الفدا لما فيــــــــــك من عـــــــــــزة عربيــــــــــــــة
بنيت على الدين أركانــــــــــــــها فكانت سلاماً على البشرية
هذه هي الأمة في فكر الإمام ابن باديس الذي سعى لتعزيز الوطنية الجزائرية في نفوس مواطنيه، وتعزيز القومية العربية، مبيناً العلاقة الراسخة المتأصلة بين العروبة والإسلام.
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com