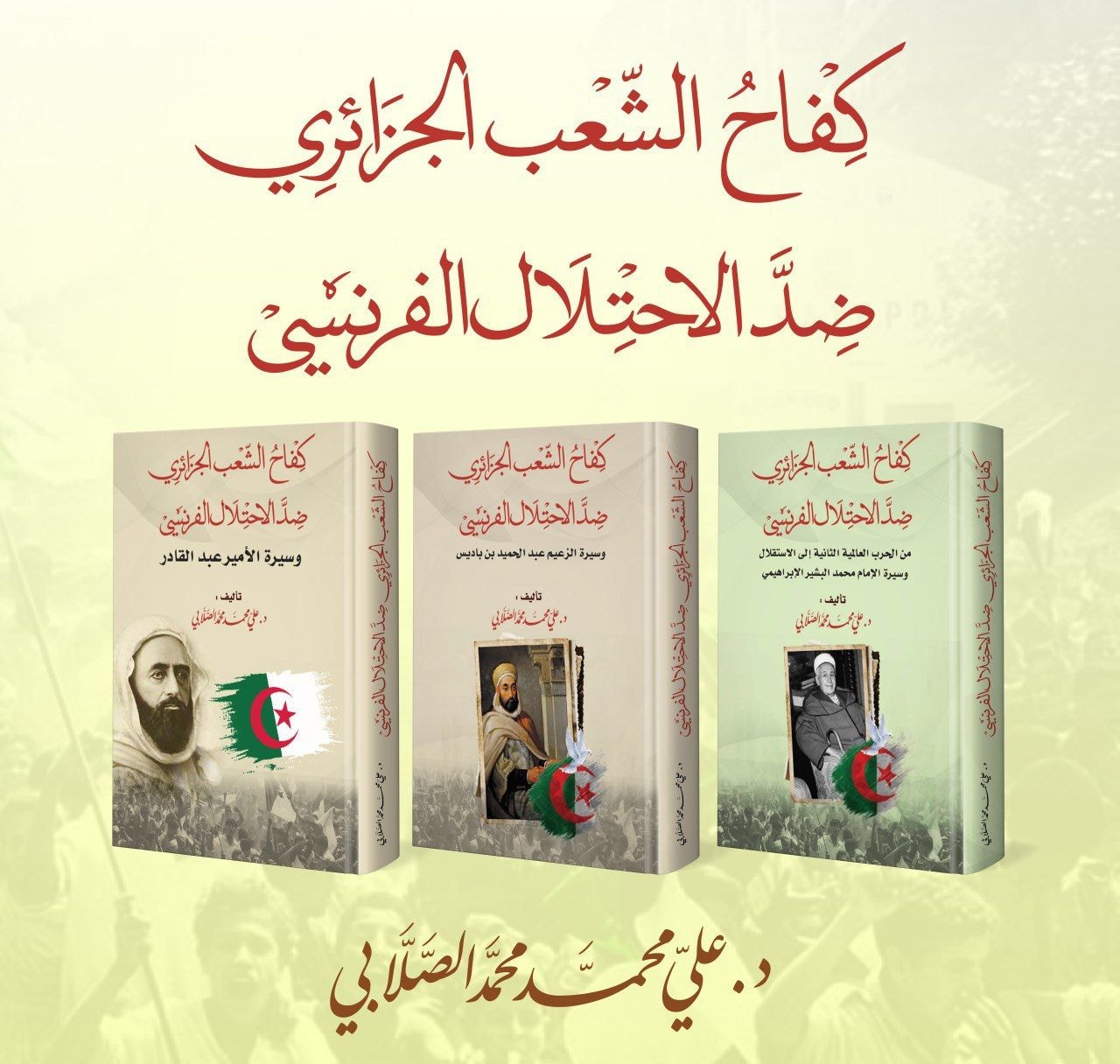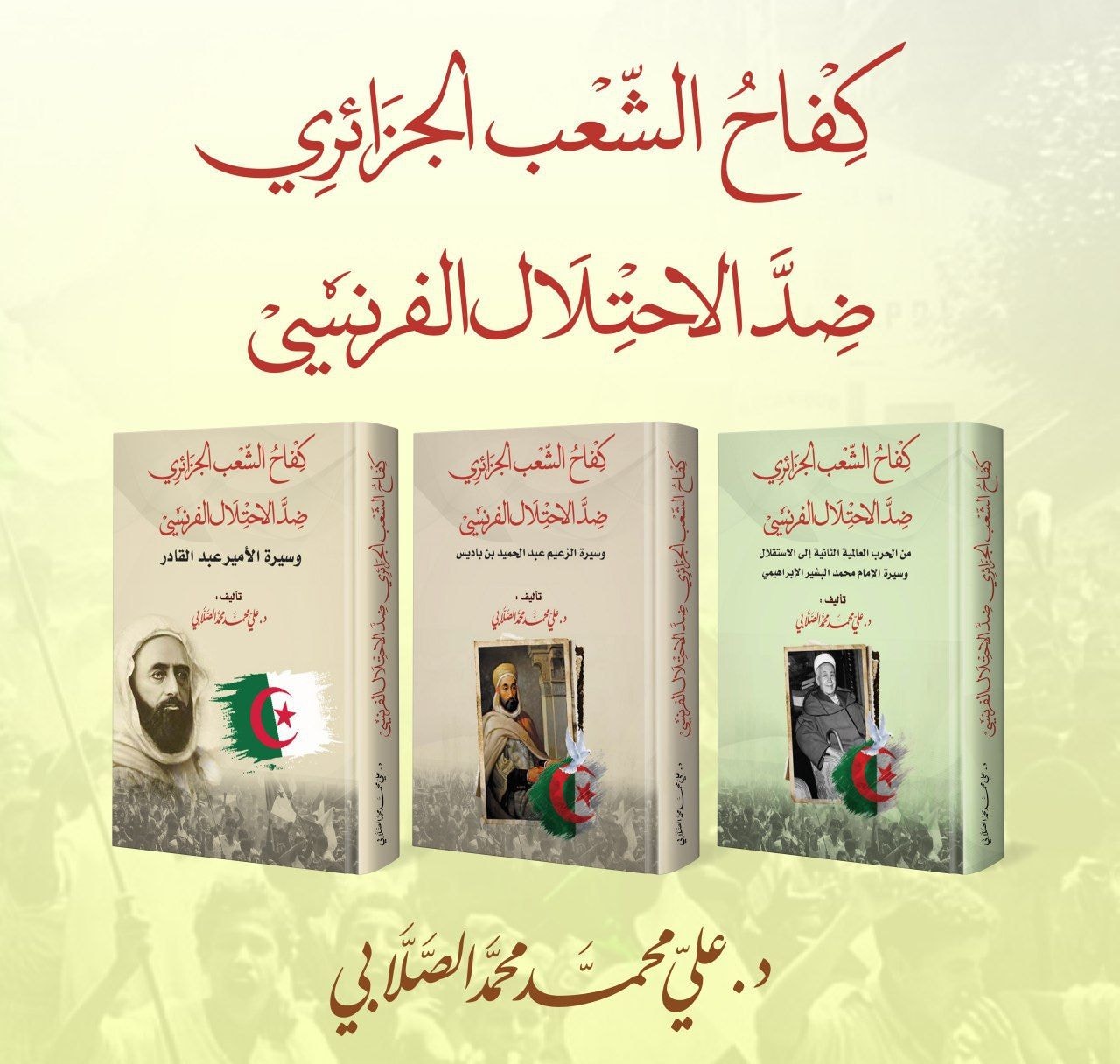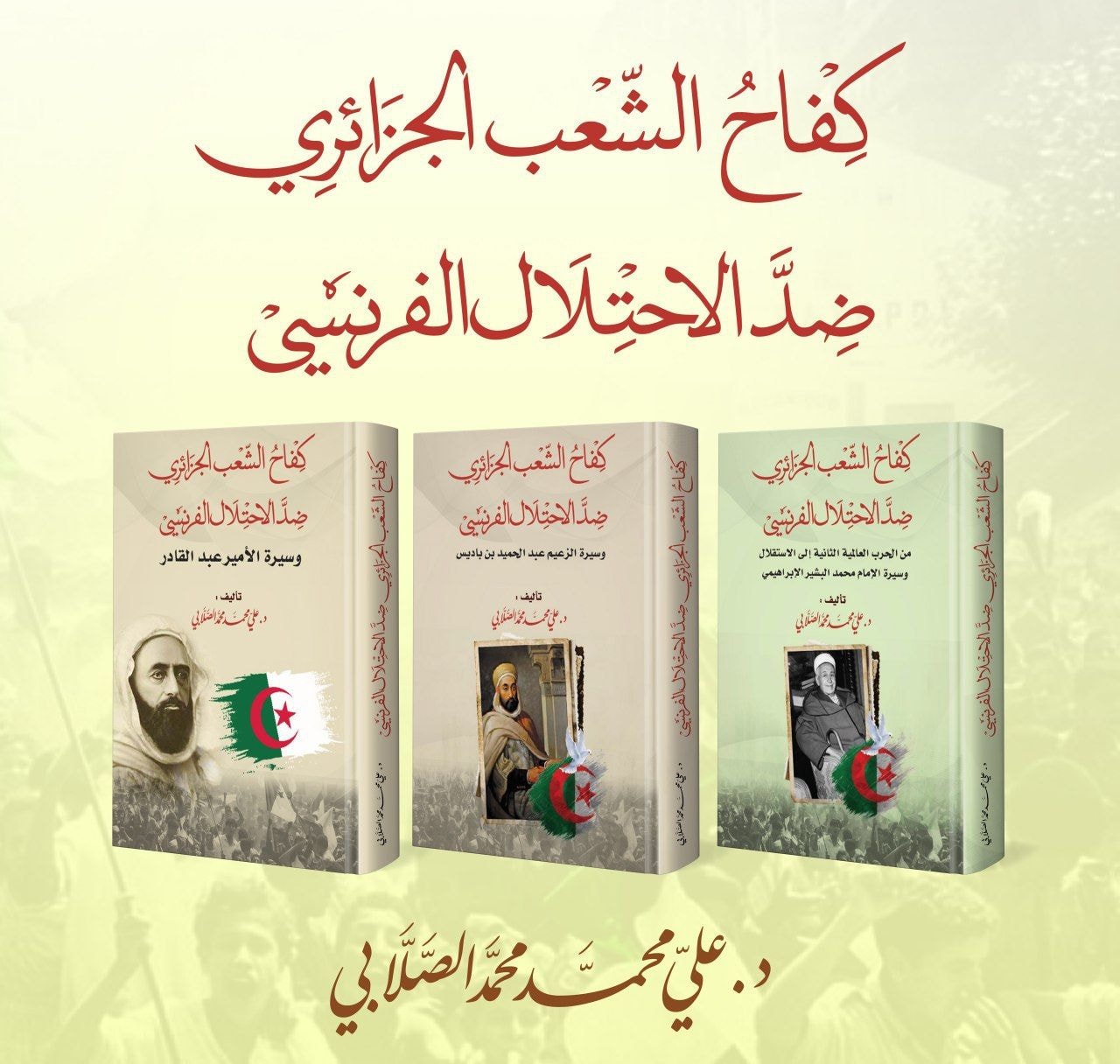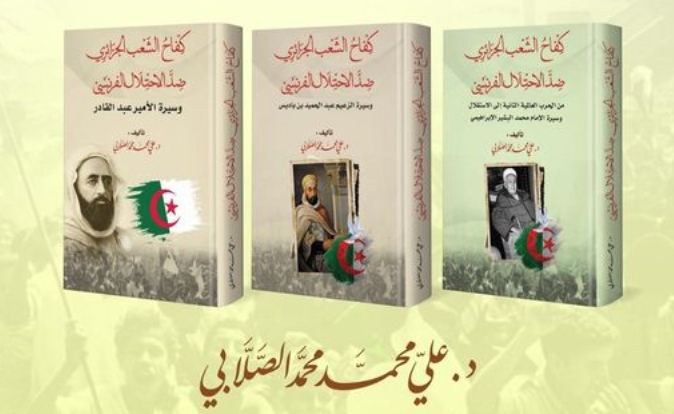(أسس قيام الدولة العربية الموحدة عند ابن باديس)
من كتاب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي(ج2):
الحلقة: 171
بقلم: د.علي محمد الصلابي
محرم 1443 ه/ أغسطس 2021م
لم يكن ابن باديس أول من آثار فكر قيام الدولة العربية الموحدة، فقد أثارها من قديم بعض فلاسفة الإسلام الأوائل أمثال الكندي والفارابي ثم ابن خلدون، كما أثارها في أواخر القرن التاسع عشر رجال الإصلاح الديني والسياسي أمثال الكواكبي والأفغاني، وبعدهم جاء ابن باديس في تفسيره ومقالاته ليحدد أسس قيام هذه الدولة وعوامل بناء الحضارات وأسباب انهيارها، كما حدد الأطر السياسية والجغرافية والسكانية للدولة العربية الموحدة، وأثر المقومات اللغوية والدينية والقومية في تفاعل هذه الأطر وتكوين الإطار المرجعي لهذه الدولة.
وبرغم الملامح المثالية في التصور الباديسي والأمل الواعد في تحقيق هذه الدولة، فقد حاول في واقعية تقديم تصور لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع العربي بالفعل، مؤكداً على أن في استقراء التاريخ والواقع بإمكاناته
ومتغيراته دليل على إمكان تحقق هذه الدولة التي تحكمها مجموعة من الأسس والأطر الأخلاقية والدينية والاجتماعية والجغرافية الواحدة وهي:
1 ـ الإطار الخلقي:
ويتمثل في ضرورة الالتزام بالقانون الذي يساوي ويؤاخي بين الجميع في كل شيء في إطار عام من الحق والعدالة، وفي الثواب والعقاب وفي العمل والتفكير، وحتى في مجال التضحية من أجل بناء وبقاء الدولة ووحدتها وحمايتها، وقد عبر عن ذلك ابن باديس بقوله: الحياة تشترى بالأرواح والأبدان، ذلك هو الثمن، ومن دفع الثمن فمن الحق والعدل أن يأخذ المثمن، وعلى مبدأ الحق والعدل يكون حق الأفراد في التمثيل البرلماني وفي جميع المجالس الإقليمية، وتوحيد النيابة البرلمانية والمشاركة في الانتخابات وحرية التعبير والمساواة في كل شيء، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، وهكذا تكون المؤاخاة الحقيقية والتي لا تكون إلا عندما يشعر الإنسان بأنه لا مغموط الحق ولا مهضوم الجانب من صاحبه.
2 ـ الإطار الجغرافي والسكاني:
ويصف ابن باديس التفاعل السكاني في هذه الدولة بقوله:
فالجليل والكبير له مكانه، والصغير والحقير له مكانه، وعلى كل مواطن أن يسد الثغرة التي من ناحيته مع شعوره بارتباطه مع غيره من جميع أجزاء البنيان التي لا غناء لها عنه، كما لا غناء له عن كل واحد منها، فكل واحد من المؤمنين عليه تبعه بمقدار المركز الذي هو فيه والقدرة التي عنده، ولا يجوز لأحد وإن كان أحقر حقير أن يخل بواجبه في ناحيته، فإنه إذا أزيل حجر، صغير من بنيان كبير دخل فيه الخلل بمقدار ما أزيل، وإذا بدأ الخلل من الصغير تطرق الكبير.
3 ـ الإطار الاجتماعي:
يرى ابن باديس أن يؤسس الإطار الاجتماعي للدولة على أساس التعاون والمشاركة، ويقول: إن الدولة العربية الواحدة لا بد أن يكون قوامها العمل والإنتاج والنظام، وأن تكون كل مدينة من مدنها هي مدينة الشعب العامل، إذ العمل طريق التغيير والإنتاج، وبه يكون التطور والبناء والنهضة وفق الشعار الدائم، فاعمل وداوم على العمل، وحافظ على النظام، فالعمل ما هو إلا خطوة ووثبة وراءها خطوات وثبات، وبعدها إما الحياة وأما الممات.
4 ـ الإطار الديني:
ويتمثل في الالتزام بالواجبات والتكاليف وبما في الدين من نصح وإرشاد وعلم وبصيرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكي يصبح الدين من أهم أسس بناء الدولة الموحدة دعا ابن باديس إلى:
ـ ضرورة التمسك بالإسلام الذاتي، أي الإسلام علىحقيقته الذي يقوم على الفهم والإدراك للعقائد والأخلاق والاداب الإسلامية والأعمال، شريطة أن يبني ذلك كله على الفكر والنظر ليحيا حياة فكر وإيمان وعمل.
ـ ضرورة الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب على يد سفهائها وأهل الفساد منها، وتهجرهم وتنبذهم من مجتمعهم من الشرور والبلايا، وتقل أو تنعدم منها المفاسد والمنكرات، أما الأمة التي تسكت عن سفهائها وأهل الشر من كبرائها وتدعهم يتجاهرون فيها بالفواحش والقبائح هي أمة هالكة متحملة جريرة المجاهرة بالمعاصي.
ـ ضرورة التمسك بتعاليم الدين الداعية إلى العلم والثقافة والأدب لأن هذه التعاليم بمثابة الغذاء الذي يحتاجه الجسم، فكما أن الأبدان تحتاج إلى الغذاء كذلك الدول في حاجة إلى غذاء من الأدب والرقي والعلم الصحيح، ولا يستقيم سلوك أمة حتى تنقطع الرزيلة من طبقاتها، وتنتشر الفضيلة بينهم ؛ إلا إذا تغذت عقول أبنائها بهذا الغذاء النفيس.
ـ ضرورة الانتباه إلى ما في الدين من قوة عظيمة لا يستهان بها، وقوة معنوية نلتجأئأأ إليها في تهذيب أخلاقنا، وقتل روح الإغارة والفساد والجرائم فينا، ودور كبير في تسيير أمور الدولة وسياستها، ومن ثم فالدولة التي تتجاهل دين الشعب تسيء في سياسته وتجلب عليه وعليها الأضرار والأتعاب والفتن.
5 ـ الإطار السياسي:
ويشرح ابن باديس مفهوم السياسة الحكيمة التي تقوم عليها الدولة وعمادها العلم والدين، فيقول: إن العلم هو وسيلة المعرفة لحقيقة الأوضاع السياسية والإجتماعية في الدولة، وهو السبيل ليعرف العرب والمسلمون أنهم المتسببون فيما هم فيه، ووجب عليهم ألا يحملوا مسؤولية ذلك إلى غيرهم أو إلى الأقدار، فهناك أسباب لكل شيء، وهذه السببية يتم معرفتها بالعلم.. فالسياسة الحكيمة تؤكد على أن العلم وكذلك الدين لا ينهض حق النهوض إلا إذا نهضت السياسة بحق، وعلى ذلك وجب على الدولة أن تلتزم في سياستها بقوانين العلم وحدود الإيمان معاً، وأن العلم في هذه الدولة مهمته خلق الوعي وتنبيه الأذهان إلى المشكلات التي تعترض كلاً من الدولة والأفراد وكيفية حل هذه المشكلات، كما أن على العلم تقع مسؤولية توجيه السياسة لهذه الدولة.
والسياسة الحكيمة عند ابن باديس تعتمد على أسس وأهداف ثلاثة: هي التعاون على الخير، ثم السعي لتحقيق السعادة، ثم نشر السلام. وذلك لأن الدولة العربية الإسلامية الموحدة هي دولة إنسانية ودينها هو دين الإنسانية العام الذي لم ينزل للعرب وحدهم، بل نزل لبني الإنسان كافة، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ : 28]. وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ *} [الأنبياء : 107].
ومن أجل تطبيق هذا المبدأ عملياً كان ابن باديس يؤكد موقفه العملي المتمثل في:
ـ أصر على وجود العلماء في المجالس النيابية، اعتقاداً منه بأن السياسة ستكون في نظر هؤلاء العلماء المشاركين هي التفكير والعمل والوطنية.
ـ ضرورة أخذ العلم عن كل أمة وبأي لسان، واقتباس كل ما هو مفيد مما عند غيرنا، ومد اليد إلى كل من يريد التعاون على الخير والسعادة والسلام.
ـ ضرورة أن تؤسس السياسة على العلم، لأن السياسة بلا علم هي مجرد فكر نظري لا يفيد، وأن السياسة مع العلم تكون كالتربية والتعليم وسيلة إصلاحية فعالة.
ـ رفض ما دعا إليه الإمام محمد عبده من ضرورة فصل الدين عن الدولة والسياسة، على اعتبار أن السياسة لحقت بالعقائد الدينية حين تغلغلت فيها الأهواء السياسية فأورثت شقاقاً وخلافاً. أما ابن باديس فقد رفض هذا الفصل وأصر على إشتراك السياسة مع الدين في بناء الدولة الموحدة، وخاصة إذا كان هذا الاشتراك بأسلوب علمي يوقظ الوعي ويحرك الهمم والعزائم، ويحقق للأمة النهضة، ويساعدها في التغلب على العقبات وفي مقدمتها عوامل التفريق بين الداخل والخارج.
ـ وأن العلم الذي يوجه السياسة والأمة هو العلم بالأسباب، إنه العلم الذي يبني الأمم ويكون الحضارات، وبه يجعل الله من الأمة الضعيفة أمة قوية عندما تأخذ بأسباب العلم والمدنية، وتضعف الأمة عندما تبتعد عن تلك الأسباب.
ويؤكد ابن باديس أن تلك سنة كونية ثابتة وأن من سنن الله في كونه أن يعلم هذا العالم الإنسان ما لم يكن يعلم، كإخراج الضد من الضد، وإخراج الحي من الميت، وإنقاذ الأمة الضعيفة التي لا تملك شيئاً من وسائل القوة الروحية ولا من وسائل القوة المادية، فتلك سنة ثابتة ولا تختلف باختلاف الأمم ولا تتبدل على الأجيال.
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي: