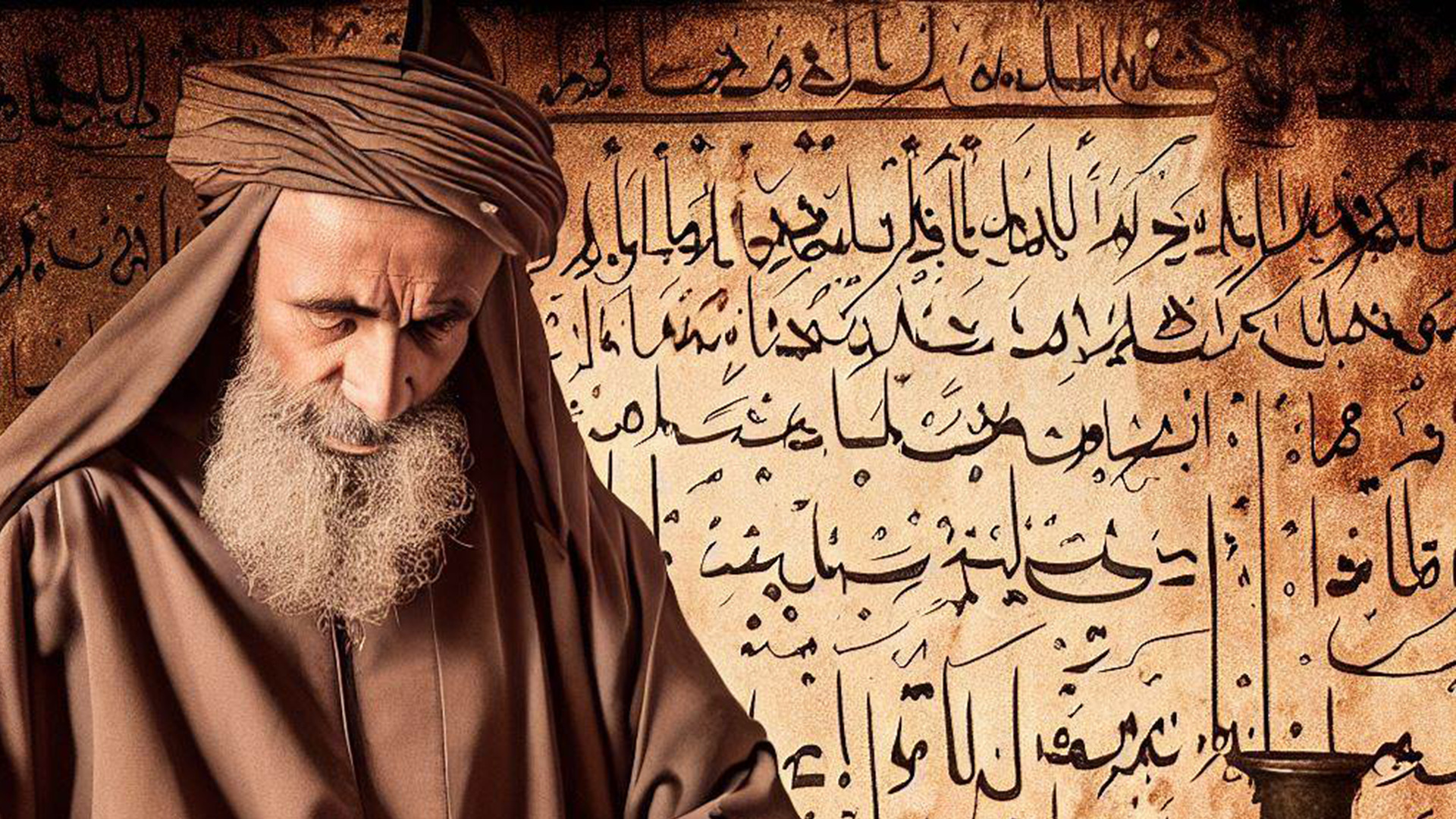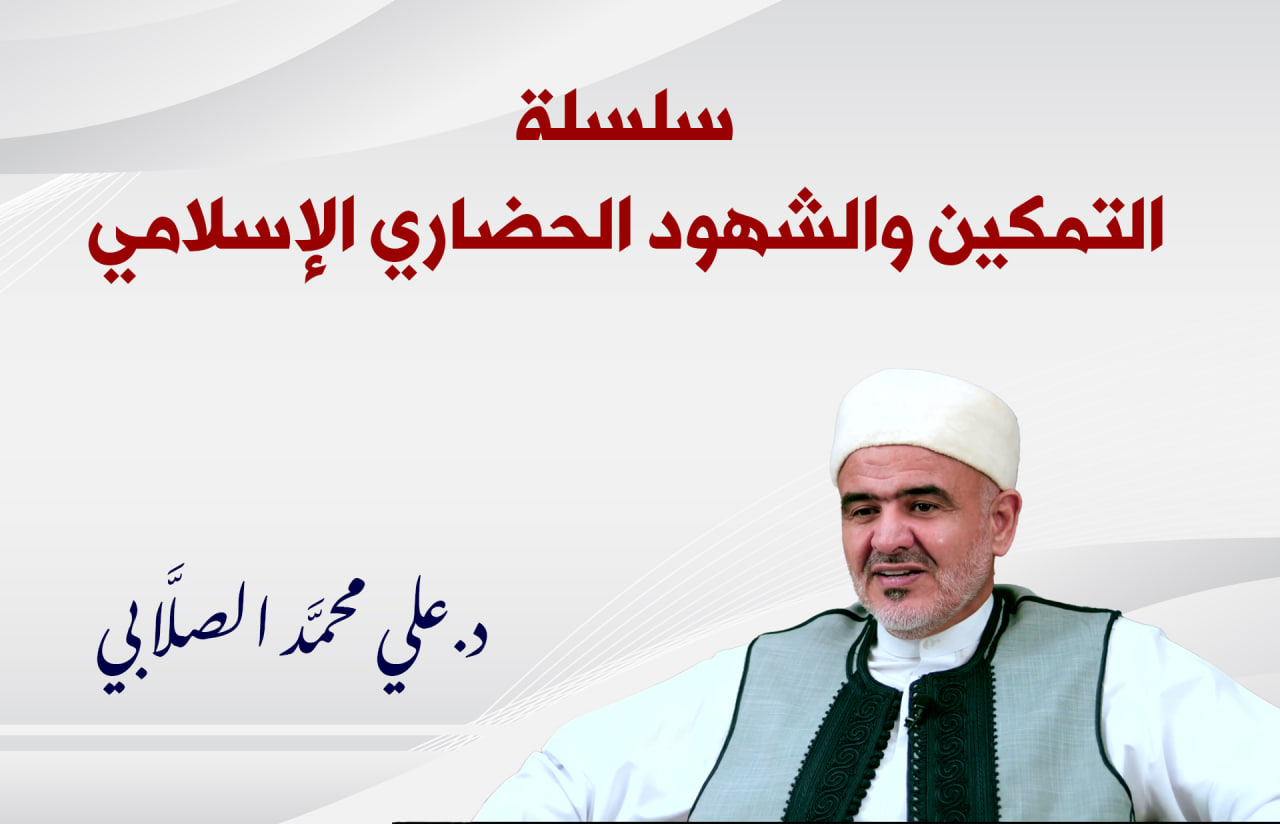الشيخ العالم الفاضل، المفيد المجيد، إمام زمانه، وحافظ وقته وأوانه، حامل لواء السنة، متين الديانة، حسن الأخلاق، لطيف المحاضرة، حسن التعبير، شيخ الإسلام في زمانه، العالم الإمام أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهو شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشافعي المذهب، القاهري الدار» كان حافظًا ديِّنًا ورعًا زاهدًا عابدًا مفسرًا شاعرًا فقيهًا أصوليًّا متكلمًا ناقدًا بصيرًا جامعًا، حرر ترجمته جمع من الأعيان»، كان يكنى بـ: «أبي الفضل». نشأ ابن حجر العسقلاني –رحمه الله - في أسرة تحب العلم وتشجع عليه، وهذا قدر الله له أن ينشأ في جو علمي وبيئة صالحة تأخذ بيده إلى العلم، حتى صار له شأن عظيم بين الناس، وشاء الله تعالى كذلك أن ينشأ ابن حجر- رحمه الله- يتيمًا أباً وأمًا، فحُرم من عطف أبيه وعلمه كما حرم من حنان أمه، إلا أنه –رحمه الله- تغلب على ظروفه وكافح في حياته حتى نال السؤدد بين الناس بالعلم والحديث. نشأ ابن حجر –رحمه الله- مع يتمه في غاية العفة والصيانة والرياسة في كنف أحد أوصيائه، زكي الدين الخروبيّ، وهو من كبار التجار في مصر، وظل ابن حجر في كنف وصيه يرعاه إلى أن مات الزكيّ الخروبي سنة 787هـ، وكان قد راهق، فلم تعرف له صبوة ولم تضبط له زلة، وفي سنة 790 هـ أكمل ابن حجر -رحمه الله- السابعة عشرة من عمره، فقرأ القرآن تجويداً على الشهاب الخيوطي، وسمع صحيح البخاري على بعض المشايخ، كما سمع من علماء عصره البارزين واهتم بالأدب والتاريخ. وفي هذه الفترة انتقل ابن حجر -رحمه الله- إلى وصاية شمس الدين بن القطان المصري فحضر دروسه في الفقه والعربية والحساب، وفي سنة 793هـ نظر في فنون الأدب، ففاق أقرانه فيها، حتى أنه لا يكاد يسمع شعراً إلا ويستحضر من أين أخذ ناظمه وطارح الأدباء، ونظم الشعر والمدائح النبوية. وتمثِّل سنة 793 هـ منعطفاً ثقافياً في حياة ابن حجر –رحمه الله، فمن هذه الثقافة العامة الواسعة واجتهاده في الفنون التي بلغ فيها الغاية القصوى أحس بميل إلى التخصص فحبّب الله إليه علم الحديث النبوي، فأقبل عليه بكليته، ويذكر السخاوي أن ابن حجر -رحمه الله- لم يكثر في طلب الحديث إلا في سنة 796 هـ، وكتب بخط يده: «رفع الحجاب وفتح الباب وأقبل العزم المصمم على التحصيل ووفق للهداية إلى سواء السبيل» فكان أن تتلمذ على يد خيرة علماء عصره. ولم يبلغ ابن حجر العسقلاني –رحمه الله- خمسة وعشرين سنة حتى جمع من العلوم ما لم يجمعه أحد في عصره، في علوم القرآن والتفسير والفقه واللغة والأدب والتاريخ والحديث والنحو، وجمع بين علوم النقل والعقل، وأخذ عن عدد جمّ من المتخصصين في علوم المعارف كلها، ولا يتوفر ذلك إلا لشاب ذو همة عالية وعزيمة قوية ورغبة حقيقية في طلب العلم والانتفاع به. كان ابن حجر –رحمه الله- مع صغر سنه لا يألو جهداً في الرحلة إلى طلب العلم وتحصيله، مهما كلفه ذلك من بعدٍ عن أهله وأولاده وأصحابه، ومهما عانى من سفره من تعب ونصب. وقد عبَّر عن ذلك ابن حجر نفسه بقوله: وإذا الديار تنكرت سافرت في *** طلب المعارف هاجراً لدياري وإذا أقمت فمؤنسي كتبي، فلا *** أنفك في الحالين من أسفاري. فكانت أول رحلته إلى قوص وهو في العشرين من عمره، وبالتحديد سنة 793 هـ، حيث حطت رحاله في قوص في صعيد مصر، وفي أواخر سنة 793 هـ كانت لابن حجر –رحمه الله- رحلة إلى الإسكندرية، والتقى فيها ابن حجر بمجموعة من المحدثين والمسندين، منهم ابن الخراط، وابن شافع الأزدي، وابن الحسن التونسي، والشمس الجزري. وقد أورد ابن حجر ما لقيه من العلماء وما سمعه منهم وما وقع له من النظم والمراسلات وغير ذلك في كتاب سماه «الدرر المضيئة من فوائد إسكندرية». وكانت لابن حجر رحلة إلى الحجاز للحج والمجاورة، حيث الفرصة سانحة للاشتغال والمذاكرة على ما يصادفونه هناك من العلماء والشيوخ والمحدثين والمسندين، وكان آخر حجة حجها –رحمه الله- سنة 824هـ، وفيها نزل بالمدرسة الأفضلية، أنزله فيها قاضي مكة المحب بن ظهيرة. والتقى ابن حجر –رحمه الله- في منى ومكة والمدينة جمعا كبيرا من العلماء والمحدثين والقضاة والأعيان، فقرأ عليهم وقرءوا عليه، وأخذوا عنه بعض تصانيفه، وأجاز لهم بالرواية عنه. ورحل ابن حجر -رحمه الله- إلى بلاد الشام في سنة 802هـ، وحثه على الرحلة إليها شيخه محمد بن محمد بن محمد الجزري، وصحبه فيها قرينه الزين شعبان، وسمع بسرياقوس وغزة ودمشق ونابلس وبيت المقدس والخليل والصالحية، وغيرها من بلاد الشام، والتقى هناك بعدد غفير من العلماء والمسندين، وفي رحلته لبيت المقدس. لقد وهب الله ابن حجر ذكاءً وقاداً وحافظة واعية ونشاطاً متواصلاً واطلاعاً واسعاً، مع صفاء الذهن ولطافة الحسن ورقة العاطفة وجمال الأسلوب وجزالة الألفاظ، وجودة الفهم والقراءة المركزة مع السرعة الفائقة مما جعلته نجماً لامعاً في كل أقطار العالم الإسلامي وأمصاره، ونابغة من أفراد النوابغ في علوم كثيرة وبخاصة في علم الحديث، فلقد كان واحداً من الأعيان الأفذاذ في الحديث والفقه والتفسير والـاريخ والعربية والشعر والخطابة والفتيا والإملاء والإقراء والقضاء. أما عن التاريخ فمنذ الأيام الأولى لاشتغال ابن حجر بالعلم حبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس ووقائع الأحداث وأحوال الرواة، وقد ساعده في هذا رحلاته الواسعة في العالم والأقطار والأمصار، التي عاين البلدان من خلالها، حتى تفرد بذكر الكثير من الحوادث والمراجع، وقد انعكس هذا على كتاباته التاريخية فصبغها بالصبغة الشمولية، وقد اعتنى الحافظ بالنقد التاريخي ومارسه في مختلف جوانب كتاباته.وألمّ المرض بالحافظ ابن حجر –رحمه الله- في ذي القعدة سنة 852هـ، ولكن مع مرور الأيام توفي ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجة سنة 852 هـ جزاه الله خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين.