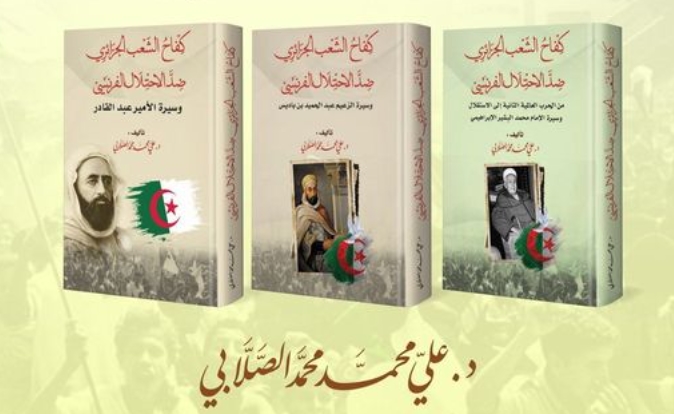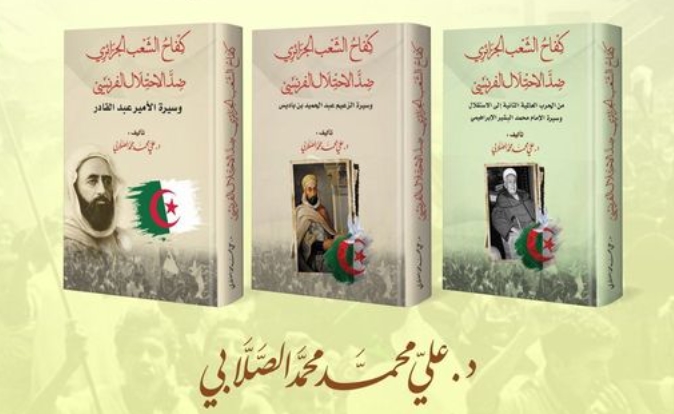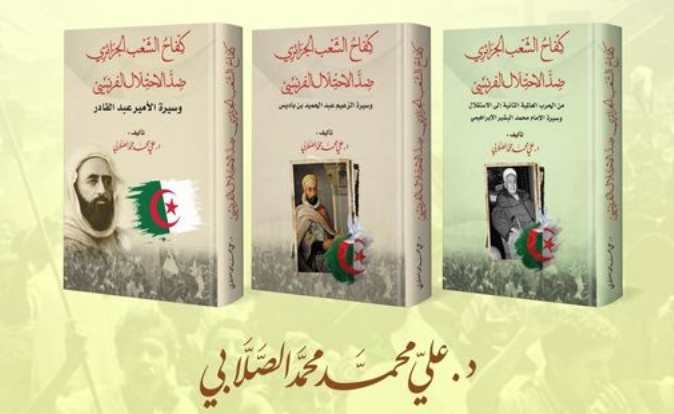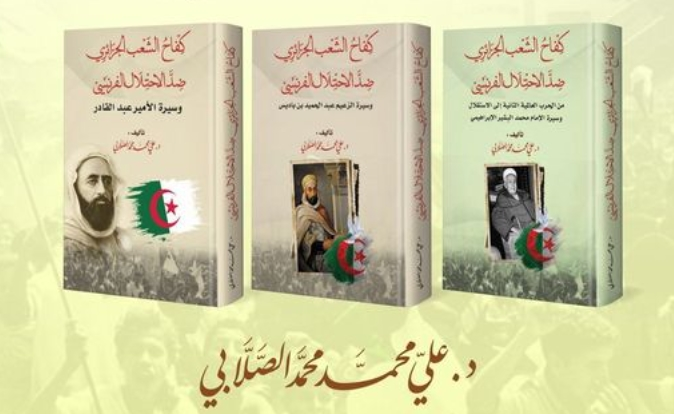(رحلات محمد البشير الإبراهيمي العلمية)
من كتاب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي(ج3):
الحلقة: 190
بقلم: د.علي محمد الصلابي
صفر 1443 ه/ أكتوبر 2021
1 ـ تصدره للتدريس ورحلته لمصر:
مات عمه سنة (1321هـ/ 1903م) وعمر محمد البشير أربع عشرة سنة، وكان عمه قد أجازه الإجازة العامة، وعهد إليه أن يخلفه في التدريس لطلابه، فأصبح شيخاً وهو في سن الصبا، والقيام عليهم كالعادة في حياة عمه. وانتقل في بعض السنين إلى المدارس القبلية القريبة منهم لسعتها واستيعابها للعدد الكثير من الطلبة، وتيسر المرافق بها للسكنى، ودام على تلك الحال إلى أن جاوز العشرين من عمره، فتاقت نفسه إلى الهجرة إلى الشرق، واختار المدينة المنورة، لأن والده سبقه إليها 1908 فراراً من ظلم فرنسا، فالتحق به متخفياً أواخر سنة 1911م، كما خرج والده متخفياً، ومر في وجهته هذه بالقاهرة، وأقام بها ثلاثة أشهر، وحضر بعض دروس العلم في الأزهر، وعرف أشهر علمائه وحضر دروس كل من:
ـ الشيخ سليم البشري.
ـ والشيخ محمد بخيت، وحضر درسه في البخاري في رواق العباسي.
ـ والشيخ يوسف الدجوي، حضر درسه في البلاغة.
ـ والشيخ عبد الغني محمود، حضر له درساً في المسجد الحسيني.
ـ والشيخ السمالوطي، حضر له درساً في المسجد الحسيني.
ـ والشيخ سعيد الموجي الذي كان له سند عالٍ في رواية الموطأ، وطلب أن يرويه عنه بذلك السند. وحضر مجالسه في جامع الفكهاني مع جمهور من الطلبة، وتولى الإبراهيمي قراءة بعض الموطأ عليه من حفظه.
وحضر عدة دروس في دار الدعوة والإرشاد التي أسسها الشيخ رشيد رضا في منيل الروضة، وزار شاعر العربية الأكبر أحمد شوقي، وأسمعه عدة قصائد من شعره من حفظه فتهلل ـ رحمه الله ـ واهتزَّ، كما اجتمع بشاعر النيل حافظ إبراهيم في بعض أندية القاهرة، وأسمعه من حفظه شيئاً من شعره كذلك.
2 ـ رحلته إلى المدينة:
خرج الإمام محمد البشير الإبراهيمي من القاهرة قاصداً المدينة المنورة، فركب البحر من بورسعيد إلى حيفا، ومنها ركب القطار إلى المدينة، وكان وصوله إليها في أواخر سنة 1911م، واجتمع بوالده ـ رحمه الله ـ وطاف بحلق العلم في الحرم النبوي مختبراً، فلم يرق له شيء منها واعتبرها غثاء يلقيه رهط ليس لهم من العلم والتحقيق شيء. وقال: لم أجد علماً صحيحاً إلا عند رجلين هما شيخاي:
ـ الشيخ العزيز الوزير التونسي.
ـ والشيخ أحمد الفيض أبادي الهندي.
فهما والحق يقال عالمان محققان وسّعا أفق الإدراك في علوم الحديث وفقه السنة، ولم أكن راغباً إلا في الاستزادة من علم الحديث رواية، ومن علم التفسير، فلازمتهما ملازمة الظل، وأخذت عن الأول الموطأ دراية، ثم أدهشني تحقيقه في بقية العلوم الإسلامية، فلازمت درسه في فقه مالك، ودرسه في «التوضيح» لابن هشام، ولازمت الثاني في درسه لصحيح مسلم، وأشهد أني لم أر لهذين الشيخين نظيراً من علماء الإسلام وقد علا سني، واستحكمت التجربة، وتكاملت الملكة في بعض العلوم، ولقيت من المشايخ ما شاء الله أن ألقى، ولكنني لم أر مثل الشيخين في فصاحة التعبير ودقة الملاحظة والغوص عن المعاني، واستنارة الفكر، والتوضيح للغوامض، والتقريب للمعاني القصية، ولقد كنت لكثرة مطالعتي لكتب التراجم والطبقات قد كونت صورة للعالم المبرز في العلوم الإسلامية منتزعة مما يصف به كتّاب التراجم بعض مترجميهم، وكنت أعتقد أن تلك الصورة الذهنية لم تتحقق في الوجود الخارجي منذ أزمان، ولكنني وجدتها محققة في هذين العالمين الجليلين، وقد مات الشيخ الوزير بالمدينة في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
وأما الشيخ حسين أحمد ؛ فقد سلمه الشريف حسين بن علي إلى الإنجليز في أواخر ثورته المشؤومة، فنفوه إلى مالطا، ثم أرجعوه إلى وطنه الأصلي (الهند)، وعاش بها سنين، وانتهت إليه رئاسة العلماء بمدينة العلم (ديوبند)، ولما زرت باكستان للمرَّة الأولى 1952م كاتبته، فاستدعاني بإلحاح إلى زيارة الهند، ولم يقدر لي ذلك، وفي هذه العهود الأخيرة بلغتني وفاته بالهند.
ـ وأخذ أيام مجاورته بالمدينة علم التفسير عن الشيخ الجليل إبراهيم الأسكوبي، وكان ممن يشار إليهم في هذا العلم مع تورع وتصاون هو فيهما نسيج وحده.
ـ وأخذ الجرح والتعديل وأسماء الرجال عن الشيخ أحمد البرزنجي الشهرزوري في داره أيام انقطاعه عن التدريس في الحرم النبوي، وكان من أعلام المحدثين، ومن بقاياهم الصالحة.
ـ وأخذ أنساب العرب وأدبهم الجاهلي والسيرة النبوية عن الشيخ محمد عبد الله زيدان الشنقيطي، وهو أعجوبة الزمان في حفظ اللغة العربية وأنساب العرب وحوادث السيرة.
ـ وأتمَّ معلوماته في علم المنطق عن الشيخ عبد الباقي الأفغاني بمنزله، وكان رجلاً مسناً منقطعاً عن أسباب الدنيا، قرأ عليه الحكمة المشرقية، وكان قيماً عليها بصيراً بدقائقها.
ـ وذاكر صاحبه الشيخ أحمد خيرات الشنقيطي سنين عديدة في اللغة والشعر الجاهلي ومنه المعلقات العشر، وصاحبه محمد العمري الجزائري أمهات الأدب المشهورة، خصوصاً الكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، فقد ختماهما مطالعة مشتركة، فاحصة متأنية، وكذلك فعلا بكتاب الأغاني من أوله إلى اخره، وبالجملة فقد كانت إقامته بالمدينة المنورة أيام خير وبركة.
وكان ينفق أوقاته على إلقاء دروس في العلوم التي لا يحتاج فيها إلى مزيد كالنحو والصرف والعقائد والأدب، وكان يتردد على المكتبات الجامعة فلا يراه الرائي إلا في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت، حتى استوعب معظم كتبها النادرة قراءة، وفي مكتبة السلطان محمود، وفي مكتبة شيخه الوزير، وفي مكتبة بشير أغا، أو في مكتبات الأفراد الغاصة بالمخطوطات مثل مكتبة ال الصافي، ومكتبة رباط سيدنا عثمان، وفي مكتبة ال المدني، وال هاشم، ومكتبة الشيخ عبد الجليل برادة، ومكتبة الوزير التونسي العربي زروق، كما كان يستعير المخطوطات من أصدقائه وتلاميذه الشناقطة، منها ديوان غيلان ذي الرمة، فيقرأها ويحفظ عيونها، وقد حفظ في تلك الفترة معظم ديوان ذي الرمة، كل هذا والشيخ الإبراهيمي لم ينقطع عن إلقاء الدروس.
3 ـ الحرب العالمية الأولى وهجرته إلى دمشق:
ولما جاءت سنة 1917م أمرت الحكومة العثمانية بترحيل سكان المدينة كلهم إلى دمشق بسبب استفحال ثورة الشريف حسين بن علي، وعجز الحكومة عن تموين الجيش الذي بلغ عدده خمسين ألفاً، وتموين المدنيين الذين يبلغ تعدادهم ثمانين ألفاً، فاقتضى تدبير قوادها العسكريين إذ ذاك أن ينقل سكان المدينة إلى مصدر الأقوات في دمشق بدل أن تنقل الأقوات منها إليهم، فكان الشيخ محمد البشير من أوائل المطيعين لذلك الأمر، وخرج مع والده إلى دمشق في شتاء 1917م، وكان من أول وصوله إلى دمشق اهتم بلقاء رجال العلم، وكانوا أول من بدأ بالفضل، فزاروه في منزله، وتعرف على العلماء، وعرف من خلال مجالسه الأولى مراتبهم، واصطفى منهم جماعة من أولهم صديقه الحميم الشيخ محمد بهجت البيطار.
وما لبث شهراً حتى انهالت عليه الرغبات في التعليم بالمدارس الأهلية، فاستجاب لبعضها، وحمله إخوانه على إلقاء دروس في الوعظ والإرشاد بالجامع الأموي بمناسبة حلول شهر رمضان، فامتثل وألقى دروساً (تحت قبة النسر الشهيرة) على طريقة الأمالي، فكان يجعل عماد الدرس حديثاً يمليه من حفظه بالإسناد إلى أصوله القديمة، ثم أملى تفسيره بما يوافق روح العصر وأحداثه، فسمع الناس شيئاً لم يألفوه ولم يسمعوه إلا في دروس الشيخ بدر الدين الحسني، ثم بعد خروج الأتراك من دمشق وقيام حكومة الاستقلال العربي دعته الحكومه الجديدة إلى تدريس الاداب العربية بالمدرسة السلطانية، (وهي المدرسة الثانوية الوحيدة إذ ذاك)، مشاركاً للأستاذ اللغوي الشيخ عبد القادر المبارك، فاضطلع بما حمل من ذلك، وتلقى عنه التلامذة دروساً في الأدب العربي الصميم، وكانت الصفوف التي يدرّس لها الأدب العربي هي الصفوف النهائية المرشحة للبكالوريا، وقد تخرّج عنه جماعة من الطلبة هم من عماد الأدب العربي في سوريا منهم:
ـ الدكتور جميل صليبا.
ـ والدكتور أديب الروماني.
ـ والدكتور المحايري.
والدكتور عدنان الأتاسي.
ولما دخل الأمير فيصل بن الحسين دمشق اتصل بالشيخ محمد بشير الإبراهيمي، وأراده على أن يبادر بالرجوع إلى المدينة ليتولى إدارة المعارف بها، ولم يكن ذلك في نيته ولا قصده، لما طرأ على المدينة من تغير في الأوضاع المادية والنفسية، فأبى ذلك عليه، وما فتأئ الأمير يلح عليه فيصدّ ويأبى، إلى أن سنحت الفرصة فكرّ راجعاً إلى الجزائر موطن ابائه وعشيرته.
لم يكن الشيخ الإبراهيمي مع ثورة الشريف حسين بن علي ضد الخلافة العثمانية والمتحالف مع الإنجليز، فقد كان الشيخ ضد هذه الثورة، واستقر بدمشق قرابة أربع سنوات.
ـ وفي دمشق طلب منه القائد التركي جمال باشا بواسطة أحد أعوانه، التعاون مع العثمانيين، ولكنه أبى وفضَّل الاشتغال بالتدريس، فعمل أستاذاً للعربية في المدرسة السلطانية.
ـ وفي دمشق تزوج، وفيها توفي والده وأحد أولاده.
4 ـ لقاؤه بابن باديس في المدينة:
كان من تدابير الأقدار الإلهية للجزائر، ومن مخبَّات الغيوب لها ؛ أن يرد لها عليَّ بعد استقراري في المدينة المنورة سنة وبضعة أشهر أخي ورفيقي في الجهاد بعد ذلك، الشيخ عبد الحميد بن باديس، أعلم علماء الشمال الأفريقي ـ ولا أغالي ـ وباني النهضات العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية للجزائر.
وبيت ابن باديس في قسنطينة بيت عريق في السؤدد والعلم، ينتهي نسبه في سلسلة كعمود الصبح إلى المعز بن باديس، مؤسس الدولة الصنهاجية الأولى والتي امتد ظلها على قسنطينة ومقاطعتها حيناً من الدهر.
يقول محمد بشير الإبراهيمي: ومع تقارب بلدينا، بحيث لا تزيد المسافة بيننا على مائة وخمسين كيلومتراً، ومع أننا لِدَتان في السن يكبرني الشيخ بنحو سنة وبضعة أشهر، رغم ذلك كله، فإننا لم نجتمع قبل الهجرة إلى المدينة، ولم نتعارف إلا بالسماع، لأنني كنت عاكفاً في بيت والدي على التعلم، ثم على التعليم، وهو كان يأخذ العلم من علماء قسنطينة متبعاً لتقاليد البيت لا يكاد يخرج من قسنطينة، ثم بعد بلوغ الرشد ارتحل إلى تونس، فأتمَّ في جامع الزيتونة تحصيل علومها.
كنا نؤدي فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد النبوي، ونخرج إلى منزلي، فنسهر مع الشيخ ابن باديس منفردين إلى اخر الليل، حين يفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصلاة الصبح، ثم نفترق إلى الليلة الثانية، إلى نهاية ثلاثة الأشهر التي أقامها بالمدينة المنورة.
كانت هذه الأسمار المتواصلة كلها تدبيراً للوسائل التي تنهض بها الجزائر، ووضع البرامج المفصَّلة لتلك النهضة الشاملة، التي كانت كلها صوراً ذهنية تتراءى في مخيلتينا، وصحبها من حسن النيَّة وتوفيق الله ما حقَّقها في الخارج بعد بضع عشرة سنة، وأشهد الله على أن تلك الليالي من سنة 1913م هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي لم تبرز للوجود إلا في سنة 1931م.
5 ـ رجوع ابن باديس إلى الجزائر:
ورجع الشيخ ـ ابن باديس ـ إلى الجزائر بعد زيارته للمدينة واتفاقه مع محمد البشير الإبراهيمي على خطة عمل شاملة لنهضة الجزائر في عام 1913م، بعد أن يقنع الإبراهيمي والده بأنه لاحق به إلى الجزائر، وأن رجوعه يترتب عليه إحياء الدين والعربية وقمع للابتداع والضلال، وإنكاء للاستعمار الفرنسي.
وكان هذا هو المنفذ الوحيد الذي يستطيع أن يدخل منه على نفس والده ليسمح له بالرجوع إلى الجزائر.
وشرع ابن باديس بعد رجوعه من أول يوم في تنفيذ الخطوة الأولى من البرنامج الذي اتفق فيه مع الإبراهيمي ففتح صفوفاً لتعليم العلم، واحتكر مسجداً جامعاً من مساجد قسنطينة لإلقاء دروس التفسير وكان إماماً فيه، دقيق الفهم لأسرار كتاب الله، فما كاد يشرع في ذلك ويتسامع الناس به حتى انهال عليه طلاب العلم من الجبال والسهول إلى أن ضاقت بهم المدينة، وأعانه على تنظيمهم وإيوائهم وإطعام المحاويج منهم جماعة من أهل الخير ومحبِّي العلم، فقويت بهم عزيمته، وسار لا يلوي على صائح.
واشتعلت الحرب العالمية الأولى وهو في مبدأ الطريق، فاعتصم بالله فكفاه شرَّ الاستعمار، وكان لوالده مقام محترم عند حكومة الجزائر، فسكتت عن الابن احتراماً لشخصية الوالد، وظهرت النتائج المرجوة لحركته في السنة الأولى.
وكانت في السنة الثانية وما بعدها أكبر، وعدد الطلبة أوفر، إلى أن انتهت الحرب.
6 ـ رجوع الإبراهيمي إلى الجزائر:
قال الشيخ محمد البشير: ورجعت أنا إلى الجزائر فلقيني ـ ابن باديس ـ بتونس، وابتهج لمقدمي أكثر من كل أحد لتحقيق أمله المعلَّق عليَّ، وزرته بقسنطينة قبل أن أنقلب إلى أهلي، ورأيت بعيني النتائج التي حصل عليها أبناء الشعب الجزائري في بضع سنوات من تعليم ابن باديس، واعتقدت من ذلك اليوم أن هذه الحركة العلمية المباركة لها ما بعدها، وأن هذه الخطوة المسدَّدة التي خطاها ابن باديس هي حجر الأساس في نهضة عربية في الجزائر، ولمست بيدي اثار الإخلاص في أعمال الرجال، ورأيت، ورأيت شباناً ممن تخرَّجوا على يد هذا الرجل، وقد أصبحوا ينظمون الشعر العربي بلغة فصيحة وتركيب عربي حر، ومعان بليغة، وموضوعات منتزعة من صميم حياة الأمة، وأوصاف رائعة في المجتمع الجزائري، وتشريح لأدوائه، ورأيت جماعة أخرى من أولئك التلاميذ وقد أصبحوا يحبرون المقالات البديعة في الصحف، فلا يقصرون عن أمثالهم من إخوانهم في الشرق العربي، واخرون يعتلون المنابر، فيحاضرون في الموضوعات الدينية والاجتماعية، فيرتجلون القول المؤثِّر، والوصف الجامع، ويصفون الدواء الشافي بالقول البليغ.
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول: تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى
alsallabi.com/uploads/file/doc/kitab.PDF
الجزء الثاني: كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس
alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC135.pdf
الجزء الثالث: كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من الحرب العالمية الثانية إلى الاستقلال وسيرة الإمام محمد البشير الإبراهيمي
alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC136(1).pdf
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:
http://alsallabi.com